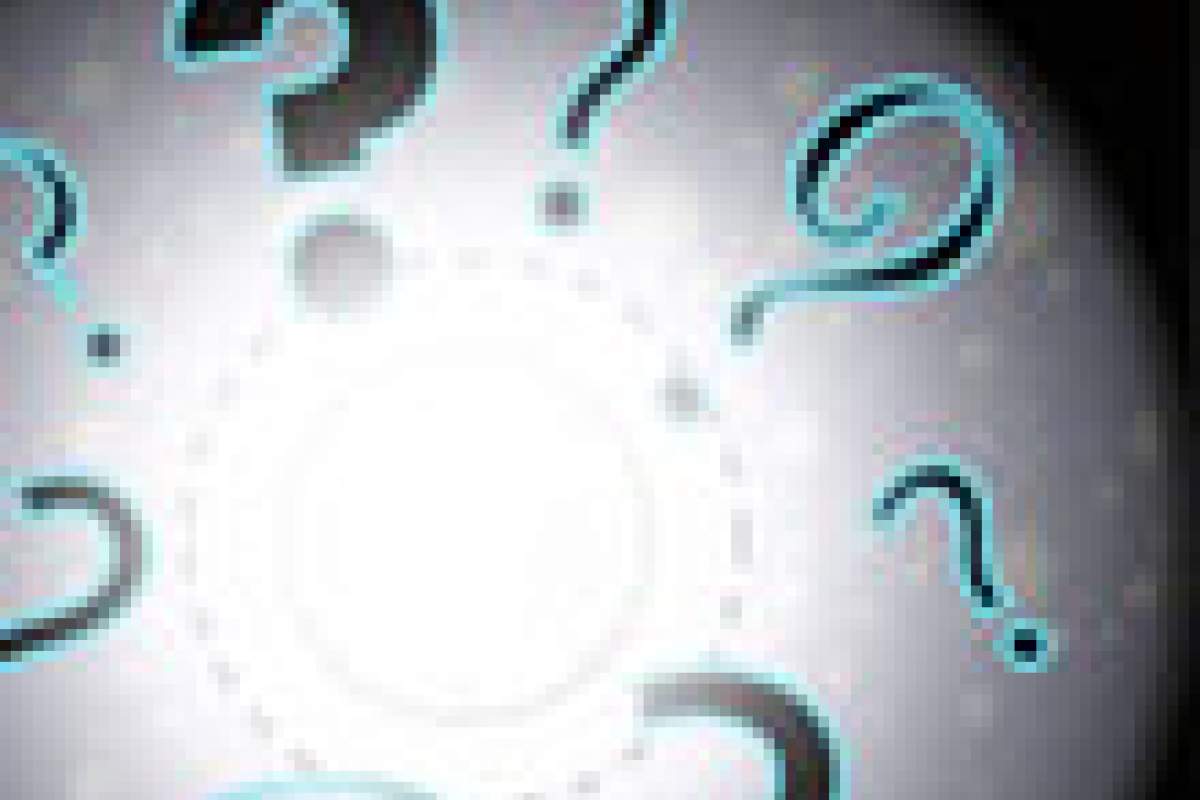دور الثّقافة الإجتماعيّة في الأخلاق
الثّقافة عبارة عن مجموعة من الاُمور، التي تبني فكر وروح الإنسان، وتمنحه الدّافع الأصلي للتحرك نحوالمسائل المختلفة. وعلى مستوى المِصداق، تمثّل الثّقافة مجموعةً من العقائد، والتاريخ والأدب والفن، والآداب والرّسوم لمجتمع ما.وأحد هذه الاُمور، العادات والتقاليد والسّنن لقوم من الأقوام.
عدد الزوار: 1123
الثّقافة عبارة عن مجموعة من الاُمور، التي تبني فكر وروح الإنسان، وتمنحه الدّافع الأصلي للتحرك نحوالمسائل المختلفة.
وعلى مستوى المِصداق، تمثّل الثّقافة مجموعةً من العقائد، والتاريخ والأدب والفن، والآداب والرّسوم لمجتمع ما.
وأحد هذه الاُمور، العادات والتقاليد والسّنن لقوم من الأقوام، فإذا إستوحت مقوّماتها من الفضائل، فستكون مؤثّرة في خلق الأجواء المناسبة لتربية وتهذيب النّفوس، وأمّا لو استرفدت قوتها وحياتها من الرّذائل الأخلاقيّة، فستكون البيئة مهيّئة لتقبل أنواع القبائح أيضاً.
وَوَرد في القرآن الكريم إشاراتٌ واضحةٌ في هذا المجال، تبيّن كيفيّة إنحراف الأقوام السّابقة، بسبب الثّقافة المنحرفة والتقاليد والأعراف المنحطة لديهم، والّتي أدّت بهم إلى السّقوط في منزلقات الخطيئة، والإنحدار في هاوية الرذائل الأخلاقية، ومنها:
1- ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾(الأعراف:28).
2- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ﴾(البقرة:170).
3- ﴿إِذْ قَالَ لاَِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الَّتمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَها عَابِدِينَ﴾(الأنبياء:52-53).
4- ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَة مِنْ نَذِير إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾(الزخرف:23).
5- ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾(الأعراف:82).
6- ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالاُْنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾(النّحل:58-59).
7- ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ اللهِ وَرِضْوَاناً سِيَماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾(الفتح:29).
تفسير وإستنتاج
ما نستوحيه من الآيات الكريمة محلّ البحث، هوأنّ ثقافة الأقوام والاُمم السّالفة، لها دورٌ فاعل في تربية ونموالصفات الأخلاقيّة، أيّاً كانت، فإذا كانت الثّقافة السّائدة بمستوى مرموق، فمن شأنها أن تفرز لنا أفراداً ذوي صفات حميدة وأخلاق عالية، والعكس صحيح، والآيات الكريمة السّابقة الذّكر، تُشير إلى المعنيين أعلاه.
ففي "الآية الاُولى": نقرأ قول الأقوام السّالفة، الّذين يعيشون الإنحراف، ويمارسون الخطيئة من موقع الوضوح في الرؤية، فإذا سُئلوا عن الدّافع لمثل هذه التصرفات الشائنة، والسلوكيات المنحرفة، قالوا بلغة التّبرير: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا...﴾. ولم يكتفوا بذلك بل تعدّوا الحدود، وقالوا: ﴿وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾.
بناءً على ذلك، فإنّهم اتخذوا سُنّة الّذين مَضوا من قبلهم دليلاً على حسن أعمالهم، ولم يخجلوا من أفعالهم القبيحة، على مستوى النّدم والإحساس بالمسؤوليّة، بل كانوا يعطوها الصّبغة الشرعيّة أيضاً.
"الآية الثّانية": طرحت نفس المعنى ولكن بشكل آخر، فعندما كان الأنبياء يدعون أقوامهم إلى الشريعة الإلهيّة النّازلة من عند الله تعالى، كانوا يتحرّكون في المقابل من موقع العناد والتكبّر، ويقولون بِغرور: ﴿سنتّبع سنّة آبائنا﴾.
ولم يكن سبب ذلك، إلاّ لأنّهم وجدوا آبائهم يؤمنون بها ويتّبعونها، وبذلك لبست ثياب القداسة واعتبروها ديناً في حركة الحياة والواقع، فهي عندهم أفضل من آيات القرآن الكريم، وشرائع الباري تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾، وعليه، فلماذا فضّلوا العمل بسنّة الجهلاء، على اتّباع آيات الوحي الإلهي؟.
ويضيف القرآن الكريم قائلاً: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ﴾.
وَوَرد في "الآية الثّالثة": الكلام عن السّنن وعادات الأقوام أيضاً، ودور الثّقافة الخاطئة في صياغة الأعمال المتقاطعة مع الأخلاق، ففي بيان يشابه الآيات الماضية، نقرأ قصّة إبراهيم وعبدة الأصنام في بابل، فعندما كان يلومهم إبراهيم عليه السلام لعبادتهم الأصنام التي لا تضرّ ولا تنفع، كانوا يقولون بصراحة: وجدنا آباءنا لها عاكفين: ﴿إِذْ قَالَ لاَِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الَّتمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾.
فأجابهم إبراهيم عليه السلام بأشدّ الكلام وأغلظه، بقوله: ﴿وَقَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤكُمْ فِي ضَلال مُبِين﴾.
ولكن وللأسف الشديد، إنتقل هذا الضّلال المبين إلى الأجيال، جيلاً بعد جيل، فأصبح جزءاً من ثقافتهم، وأكسبه توالي الزّمن عليه مسوح القداسة، فلم يمح قبحه فحسب، بل أصبح من إفتخاراتهم على المستوى الحضاري والدّيني.
"الآية الرابعة": توحي لنا نفس المعنى، ولكن بشكل آخر، ففي معرض جوابهم على السّؤال القائل: لماذا تعبدون هذه الأصنام رغم أنّكم تعيشون سلامة العقل؟، تقول الآية على لسانهم: ﴿بَلْ قالُوا إِنّا وَجَدنا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾.
فليس أنّهم لم يعتبروا هذه الحماقة، ضلالةً فحسب، بل إعتبروها هدايةً وفلاحاً، ورثوه عن آبائهم الماضين، وذكرت "الآية التي بعده" أنّ هذا هوطريق ومنطق كلّ المترفين على طول التاريخ، وقالت: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في قَرْيَة مِنْ نَذِير إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾.
ومن البديهي أنّ ذلك التقليد الأعمى، الذي كان يظهر جميلاً في ظلّ تلك القبائح، له أسبابٌ كثيرةٌ وأهمّها تبدّل ذلك القُبح إلى سُنّة وثقافة بمرور الزّمن.
وورد نفس هذا المعنى في الآية (103 و104) من سورة المائدة، فقد إبتدع عرب الجاهليّة بدَعاً ما أنزل الله بها من سلطان، فكانوا يحلّون الطعام الحرام ويحرّمون الطعام الحلال، وكانوا يتمسكون بالخرافات والعادات السيئة، ولا يقلعون عنها أبداً، ويقولون: ﴿حَسْبُنا ما وَجَدنا عَلَيهِ آبائَنا﴾.
ويتبيّن ممّا تقدم من الآيات الكريمة، تأثير العادات الخاطئة والسّنن البائدة، في قلب الاُمور رأساً على عقب، بحيث يضحى الخطأ صواباً في الواقع الأخلاقي والفكري لدى النّاس.
وفي "الآية الخامسة": يوجد موضوع جديد بالنّسبة لِدَور العادات والسّنن في تحول القيم الأخلاقيّة، وهو: أنّ قوم لوط الذين سوّدوا وجه التّأريخ بأفعالهم الشّنيعة، (ولِلأسف الشّديد، نرى في عصرنا الحاضر، أنّ الحضارة الغربيّة أقرّت تلك الأفعال على مستوى القانون أيضاً)، فعندما دعاهم لوط عليه السلام، والقلّة من أصحابه، إلى التّحلي بالتّقوى والطّهارة في ممارساتهم وأفعالهم، تقول الآية أنّهم إغتاظوا من ذلك بشدّة: ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾.
فالبيئة الملوّثة، والسّنن الخاطئة والثّقافة المنحطّة أثّرت فيهم تأثيراً سلبياً، ممّا حدى بهم إلى إعتبار الطّهارة والتّقوى جنايةً، والرّذيلة والقبائح من عناصر العزّة والإفتخار، ومن الطّبيعي، فإنّ الرذائل تنتشر بسرعة في مثل هذه البيئة، التي تعيش أجواء الإنحطاط والخطيئة، وتندرس فيها الفضائل كذلك.
"الآية السادسة": تقصّ علينا قصّة وأدِ البنات الُمريعة في العصر الجاهلي، ولم يكن سبب ذلك سوى تحكيم الخُرافات والسّنن الخاطئة في واقع الفكر والسلوك لدى الأفراد، فقد كانت ولادة البنت في الجاهليّة عاراً على المرء، وإذا ما بُشّر أحدهم بالاُنثى يظلّ وجهه مسودّاً من فرط الألم، والخجل، على حدّ تعبير القرآن الكريم1: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالاُْنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾.
ولا شكّ أنّ القتل من أقبح الجرائم، وخصوصاً إذا كان القتيل طفلاً وليداً جديداً، ولكن السّنن الخاطئة والتقاليد الزائفة، التي كانوا عليها مَحَقت القُبح من هذه الجريمة النّكراء، وجعلت منها فضيلةً.
وبالنّسبة لوأد البنات الفظيع، جاء في بعض التّفاسير: أنّ البعض من هؤلاء الجاهلين، كانوا يستخدمون اُسلوب الدّفن للبنات، وبعض يغرقونهن، والبعض الآخر كانوا يفضّلون رميهنّ من أعلى الجبل، وقسم آخر كانوا يذبحون بناتهم2، وأمّا بالنسبة لظهور هذا الأمر عند العرب، وتأريخه والدافع الأصلي له، فقد وردت أبحاثٌ مفصّلة لا يسع المقام لذكرها الآن3.
والكلام في كيفيّة تمهيد الطريق للرذائل الأخلاقيّة، من خلال تلك السّنن الخاطئة، والعادات الزّائفة، وكيف تحلّ الرذائل مكان الفضائل، هودليلٌ وشاهدٌ آخر على أنّ الثّقافة تُعتبر من الدّواعي المهمّة لتفعيل عناصر الفضيلة، وتقوية قوى الإنحراف والرذيلة، في واقع الإنسان، وبالتّالي فإنّ أوّل ما يتوجب على المصلحين، في حركتهم الإصلاحية، هوإصلاح ثقافة المجتمع والسير بها في خط العقل والدّين.
ونرى في عصرنا الحاضر ثقافات زائفة، لا تتحرك بعيداً عمّا كان في عهد الجاهليّة، حيث أضحت مصدراً لأنواع الرذائل الأخلاقيّة في حركة الحياة الإجتماعية، وقد إنعقد في السّنوات الأخيرة مؤتمراً عالمياً في بكين عاصمة الصين، وشارك فيه أغلب دول العالم، ونادى فيه المشاركون بالعمل لتثبيت ثلاثة اُصول، وأصرّوا عليها من موقع إحترام حقّ الإنسان وهي:
1- حريّة العلاقات الجنسيّة للمرأة.
2- الجنسيّة المثليّة.
3- حرّية إسقاط الجنين.
وقد واجهت هذه الاُمور معارضةً شديدةً من قبل بعض الدول الإسلامية، ومنها الجمهورية الإسلامية.
ومن الطبيعي، عندما يُدافع نواب الدّول المتحضّرة عن مثل هذه الاُمور الشنيعة، تحت ذريعة الدفاع عن حقوق المرأة، فأيّة ثقافة سوف تظهر للوجود؟، وأيّة رذائل ستنتشر في المجتمع؟، الرذائل التي لا تضرّ بالمسائل الأخلاقيّة للناس فحسب، بل وستؤثر أيضاً على حياتهم الإجتماعيّة والإقتصاديّة، من موقع إهتزاز المبادىء الإنسانيّة في منظومة القيم.
"الآية السابعة": تستعرض علاقة الفضائل بثقافة المحيط والبيئة، فما وردنا من أحاديث عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم، تبيّن مدى الرّقي الأخلاقي الذي حصل في المجتمع المظلم آنذاك، نتيجة النّهضة الفكريّة والأخلاقيّة التي جاء بها الإسلام إلى ذلك المجتمع، فيقول القرآن الكريم: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ اللهِ وَرِضْوَاناً سِيَماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾.
وعبارة: "فالذين معه"، لا تحصر هذه المعيّة في زمانِ خاصٍّ، ومكان معيّن، بل تمتد إلى المعيّة في القيم الأخلاقيّة، والأفكار الإنسانيّة، فكلّ من يقبل تلك الثّقافة الإلهيّة المحمديّة يكون من مصاديق الآية.
علاقة الآداب والسّنن بالأخلاق في الرّوايات الإسلاميّة
أعطى الإسلام أهميةً كبيرةً لهذه المسألة، ألا وهي، سنّ السنن الصّالحة، والإبتعاد عن السنن السّيئة، وللمسألة إنعكاساتٌ وأصداءٌ كبيرةٌ في الأحاديث الإسلامية، ويستفاد من مجموع تلك الأحاديث، أنّ الهدف هوسنّ العادات الصّالحة، كي تتهيّأ الأرضية اللاّزمة للتحلّي بالأخلاق الحميدة، وإزالة الرذائل الأخلاقية من واقع النفس والسّلوك، ومنها:
1- ما ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم: "خَمْسٌ لا أَدَعُهُنَّ حَتّى المَماتِ الأَكْلُ عَلَى الحضِيضِ مَعَ العَبِيدِ...، وحَلْبُ العَنزِ بِيَدي وَلَبْسُ الصُّوفِ وَالتَّسلْيمُ عَلَى الصِّبيانِ، لَتَكُونَ سُنَّةً مِنْ بَعدِي"4.
والهدف من كلّ ذلك، هوإيجاد روح التّواضع عند الناس من خلال الإقتداء بالرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم، في حركة السّلوك الإجتماعي.
2- وجاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه واله وسلم. أنّه قال:
"مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عُمِلَ بِها مِنْ بَعْدِهِ كانَ لَهُ أَجْرَهُ وَمِثلَ اُجُورِهِمْ مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيئَاً، ومَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيَّئَةً فَعُمِلَ بِها مِنْ بَعْدِهِ كانَ عَلَيهِ وِزْرَهُ وِمثلَ أَوزارِهِم مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوزَارِهِمْ شَيئاً"5.
وورد في بحارالأنوار نفس هذا المضمون.
ونقل هذا الحديث بتعابير مختلفة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم، والإمام الباقر والإمام الصّادق عليهما السلام، وهويُبيّن أهمية الّتمهيد للأعمال الأخلاقيّة، وأنّ التّابع والمتبوع هما شريكان في الثواب والعقاب، والهداية والضّلال.
3- ولذلك أكّد الإمام علي عليه السلام، على مالك الأشتر هذا المفهوم أيضاً، لحفظ السنن الصالحة، والوقوف في وجه من يريد أن يكسر حرمتها، فيقول:
"لا تَنْقُضْ سُنَّةً صالِحَةً عَمِلَ بِها صُدُورُ هذِهِ الاُمَّةِ وإجتَمَعَتْ بِها الاُلفَةُ وَصَلُحَتْ عَلَيها الرَّعِيَّةٌ، ولا تُحْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشيء مِنْ ماضِي تِلكَ السُّنَنِ فَيَكُونُ الأَجرُ لِمَنْ سَنَّها وَالوِزرُ عَلَيكَ بِما نَقَضَتْ مِنْه"6.
وبما أنّ السّنن الحسنة تساعد على تعميق عناصر الخير، ونشر الفضائل الأخلاقيّة في واقع المجتمع، فهي تدخل في مصاديق الإعانة على الخير ونشر السّنن الحميدة، وأمّا إحياء السّنن القبيحة والرذائل الأخلاقية، فتدخل في مصاديق الإعانة على الإثم والعدوان، ونعلم أنّ فاعل الخير والدّال عليه شريكان في الأجر، وكذلك فاعل الشّر والدّال عليه شريكان في العقاب أيضاً، من دون أن يقل من ثواب العاملين، أوعقابهم شيء.
والسّنة الحسنة بدرجة من الأهمية، بحيث قال الرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم، في الرواية المعروفة في حقّ جدّه الكريم:
"كَانَتْ لِعَبدِ المُطَّلِبِ خَمساً مِنَ السُّنَنِ أَجراها اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي الإِسلامِ: حرَّمَ نَساءَ الآباءِ عَلَى الأبناءِ، وَ سَنَّ الدِّيَةَ فِي القَتْلَ مأَة مِنَ الإبلَ، وَ كَانَ يَطُوفُ بِالبَيتِ سَبَعَةَ أَشواط، وَ وَجَدَ كَنزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الخُمسَ، وَسَمّى زَمزَمَ حِينَ حَفَرَها سِقايَةَ الحاجِّ".
ويستخلص من مجموع ما تقدم أنّ الآداب والسّنن والعادات، لها معطياتٌ مهمّةٌ، على مستوى إيجاد الفضائل وتكريس الرّذائل على حدّ سواء، ولذلك أكّد عليها الإسلام تأكيداً شديداً وجعل الثّواب لمن يسنّ السّنن الصالحة، والعقاب لمن يسنّ السّنن الرّذيلة، واعتبرها من الذنوب الكبيرة.
*الأخلاق في القرآن،آية الله مكارم الشيرازي،مدرسة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام-قم،ط2،ج1،ص160-168
1- قال بعض المفسّرين: بناءً على العلاقة الوثيقة بين القلب والوجه، فإذا ما فرح الإنسان، يتحرك الدّم الشّفاف نحوالوجه ويصبح الوجه مضيئاً ونورانياً، وعندما يهتم ويغتم الإنسان فإنّ الدورة الدموية تقل سرعتها ويصفّر الوجه ويسود، وتعتبر هذه الظاهرة، علامةً للفرح والحُزن: (تفسير روح المعاني... ذيل الآية الشريفة).
2- تفسير روح المعاني، ج14، ص154، في ذيل الآية المبحوثة.
3- تفسير الأمثل، ذيل الآية 58 من سورة النحل.
4- بحار الأنوار، ج73، ص66.
5- كنز العمال، ح43079، ج15، ص780.
6- نهج البلاغة، رسالة 53.