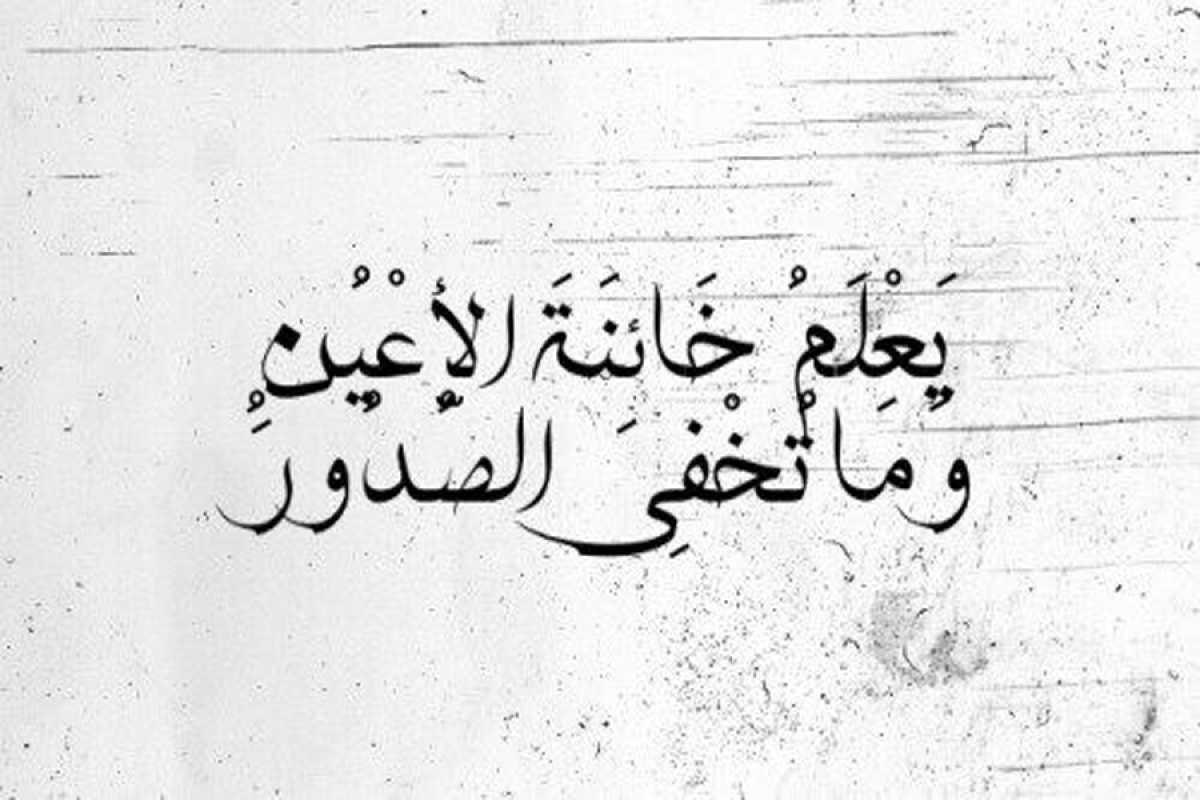نظرة الإسلام إلى الآخرين
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير﴾
عدد الزوار: 1429﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير﴾[1].
كان الإسلامُ أوّلَ مَن أقرَّ المبادئ الخاصّة بحقوق الإنسان في أكمل صورة وعلى أوسع نطاق، فأقرّ مبدأ كرامة الإنسان لكونه إنساناً. فالناس جميعاً أُمّة واحدة، وربّهم واحد، وأصلهم واحد؛ يقول تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡس وَٰحِدَة وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالا كَثِيرا وَنِسَآءۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبا﴾[2]، و﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير﴾[3].
نظرة الإسلام إلى الآخر
ينظر الإسلام إلى الآخر مِن منطلق الكرامة الإنسانيّة، القيمة المطلقة التي يبني عليها رؤيته الثقافيّة والاجتماعيّة، ويجعلها القاعدة الأساس في تشريعاته. فالآخر -أيّاً كان ولأيّة أُمّةٍ انتمى- يشمله قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾[4]؛ أي إنّ تكريم الله لِبني آدم (عليه السلام) مُطلَق، يشمل البشر كلّهم، لا جماعة من المؤمنين أو فئة مِن الناس. إذاً، كُرِّمَ الإنسان، بِغَضّ النظر عن جِنسه ومعتقده وقيمته الاجتماعيّة، ولا يحقّ لأحدٍ أن يجرّده مِن الكرامة التي أودعها الله في جِبلَّته وفِطرته وطبيعته، سواء أكان مُسلماً أو غير مُسلِم، مؤمناً بِكتاب الله ورسوله ونبيّه أو غير مؤمن. فالكرامة البشرية حَقٌّ مشاعٌ يتمتّع به الناس جميعهم مِن دون استثناء؛ وهذا ذروة التكريم وقمّة التشريف.
المساواة الإنسانيّة والأخوّة الإسلاميّة[5]
تعتمد العلاقة التي يَطرحها القرآن الكريم على أمرَيْن: المساواة والأخوّة. وينبغي تقويم أساس هذه العلاقة وتشخيص مضمونها ومحتواها بشكلٍ دائم؛ ما يجعل العلاقة الاجتماعيّة قائمة على أساس نظرة واقعيّة لحقيقة الإنسان وقيمته من ناحية، وطبيعة العلاقة الاجتماعيّة وتكوُّن بُنيتِها مِن ناحية أخرى. وفي هذا المجال يُقيم الإسلام أفضل العلاقات بين الناس على أساس المساواة والتكافؤ، فَبعضهم نظير الآخر، لا يمتاز أحدهم على الآخرين؛ قال النبيّ الكريم (صلى الله عليه وآله): «أيّها الناس، إنّ ربّكم واحد، وإنّ أباكم واحد؛ كلّكم لآدم، وآدم مِن تراب. وإنّ أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا فَضلَ لِعربيٍّ على عجميٍّ إلّا بالتقوى. ألا هل بلَّغتُ؟» قالوا: نعم. قال (صلى الله عليه وآله): «فليُبلِّغ الشاهدُ الغائبَ»[6].
وإنّما تنشأ الاختلافات والامتيازات بسبب عوامل وأسباب طارئة مِن حركة الإنسان والمجتمع؛ بعضها حقّة وصحيحة، كامتياز التقوى والعِلم والجهاد، وبعضها باطلة وغير واقعيّة، كامتياز كثرة الأموال والأولاد والقدرة والسلطة المادّيّة.
أمّا طبيعة العلاقة التي يجب أن يقوم عليها البناء الاجتماعيّ ومحتواها فَهي علاقة الأخوّة الإسلاميّة والإيمانيّة، وعلاقة المساواة بين أبناء المجتمع الذي يقوم على العقيدة الإسلاميّة. فالمسلمون إخوة، يتكافؤون ويتساوون في قيمتهم المعنويّة، كأنّهم من أبٍ واحد وأمّ واحدة. لذا، وَضع الإسلام الصلةَ الاجتماعيّة موضع العلاقة النسبيّة التكوينيّة في قيمتها وأهمّيّتها؛ روى ثقة الإسلام الكلينيّ في الكافي قصّة زواج «جويبر»، وهو رجل من أهل اليمامة، أسلم فَحسن إسلامه، وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً، أمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يخطب مِن زياد، أحد رؤساء قبائل المدينة، فَقال: «... يَا جُوَيْبِرُ، إِنَّ اللَّه قَدْ وَضَعَ بِالإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَرِيفاً، وشَرَّفَ بِالإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَضِيعاً، وأَعَزَّ بِالإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ذَلِيلاً، وأَذْهَبَ بِالإِسْلَامِ مَا كَانَ مِنْ نَخْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وتَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا وبَاسِقِ [المرتفع في علوّه] أَنْسَابِهَا. فَالنَاسُ -اليَوْمَ- كُلُّهُمْ؛ أَبْيَضُهُمْ وأَسْوَدُهُمْ وقُرَشِيُّهُمْ وعَرَبِيُّهُمْ وعَجَمِيُّهُمْ، مِنْ آدَمَ، وإِنَّ آدَمَ خَلَقَه اللَّه مِنْ طِينٍ. وإِنَّ أَحَبَّ النَاسِ إِلى اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْوَعُهُمْ لَه وأَتْقَاهُمْ. ومَا أَعْلَمُ -يَا جُوَيْبِرُ- لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْكَ -الْيَوْمَ- فَضْلاً، إِلَّا لِمَنْ كَانَ أَتْقَى لِلَّه مِنْكَ...»[7].
لذا، لم يغفل الإسلام عن العلاقة بالآخر، وقوامها العلاقة الإنسانيّة؛ قال الإمام عليّ (عليه السلام) في عهده لِمالك الأشتر: «وأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَحْمَةَ لِلرَعِيَّةِ والْمَحَبَّةَ لَهُمْ واللُطْفَ بِهِمْ، ولَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ؛ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِين، وإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ»[8]. وقد حثَّت الروايات على المجاملة العامّة وحُسن الخلق مع الناس جميعاً، فالأصلُ الاحتفاظ بالعلاقة الاجتماعيّة على المستوى الإنسانيّ، ما لم تطرأ أوضاع استثنائيّة تفرض موقفاً آخر، كالبراءة أو القطيعة؛ يقول الإمام الصادق (عليه السلام): «مُجَامَلَةُ النَاسِ ثُلُثُ الْعَقْلِ»[9].
مِن هنا، يتّضح موقف الإسلام من الكفّار، وَقد فَصَّل القرآن في العلاقة العامّة بين الكفّار والأعداء الذين يتّخذون موقفاً سياسيّاً أو عسكريّاً عدوانيّاً ضدّ المسلمين، وبين الكفّار العاديّين الذين لا موقف عدائيّاً لهم، فَنهى عن ولاء القسم الأوّل ومودّته -كما في سورة الممتحنة- وأجاز البرّ والقسط للقسم الثاني. وقد ورد في كتب الفقه جواز الصدقة على الكافر، كجزءٍ من آداب تعامل الإسلام مع الآخرين؛ ما يعني أنّ الكفر لا يسلبه صفته الإنسانيّة ما لم يدخل في عداد الكافر الحربيّ. وكذلك، ورد في فتاوى فقهائنا المعاصرين ما يدلّ على أهمّيّة الودّ والإحسان إلى الكفّار ما لم يكونوا مِن أعداء الإسلام والمسلمين؛ قال تعالى: ﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾[10].
ويُشير إلى ذلك تأكيدُ أهمّيّة الدعوة إلى الله والحوار بالأسلوب الذي يتّسم بالعقلانيّة والمحافظة على العلاقة الإنسانيّة الاجتماعيّة العامّة والحكمة والموعظة الحسنة مع الكفّار وغير المسلمين والناس عامّة، ونَهيُ القرآن الكريم والحديث الشريف عن سَبِّ الكفّار، تجنّباً لتصعيد الموقف السلبيّ منهم.
إذاً، إنّ كيان الإسلام ومجد المسلمين يستدعيان الحفاظ على استقلالهما الثقافيّ والسياسيّ والاقتصاديّ، والحذر من الوقوع في حبائل الكفر. ولكنّ ذلك لا ينافي مداراة الكفّار، ودعوتهم إلى الحقّ، والبرّ والإحسان إليهم، وإيجاد العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة معهم، إذا كان فيه صلاح الإسلام والمسلمين، مع رعاية الاحتياط.
* زَادُ المُنِيبين في شهر اللّه، إصدار دار المعارف الإسلاميّة الثقافيّة، الطـبعــة الأولى 2024م.
[1] سورة الحجرات، الآية 13.
[2] سورة النساء، الآية 1.
[3] سورة الحجرات، الآية 13.
[4] سورة الإسراء، الآية 70.
[5] لِمزيد من الاطّلاع ينظر: الحكيم، السيّد محمّد باقر، دور أهل البيت (عليهم السلام) في بناء الجماعة الصالحة، مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)، لا.م، 1425ه، ط2، ج1، ص471 - 500.
[6] ابن شعبة الحرّاني، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، مصدر سابق، ص34.
[7] الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج5، ص340.
[8] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص427، الكتاب 53.
[9] الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص643.
[10] سورة الممتحنة، الآيتان 8 - 9.