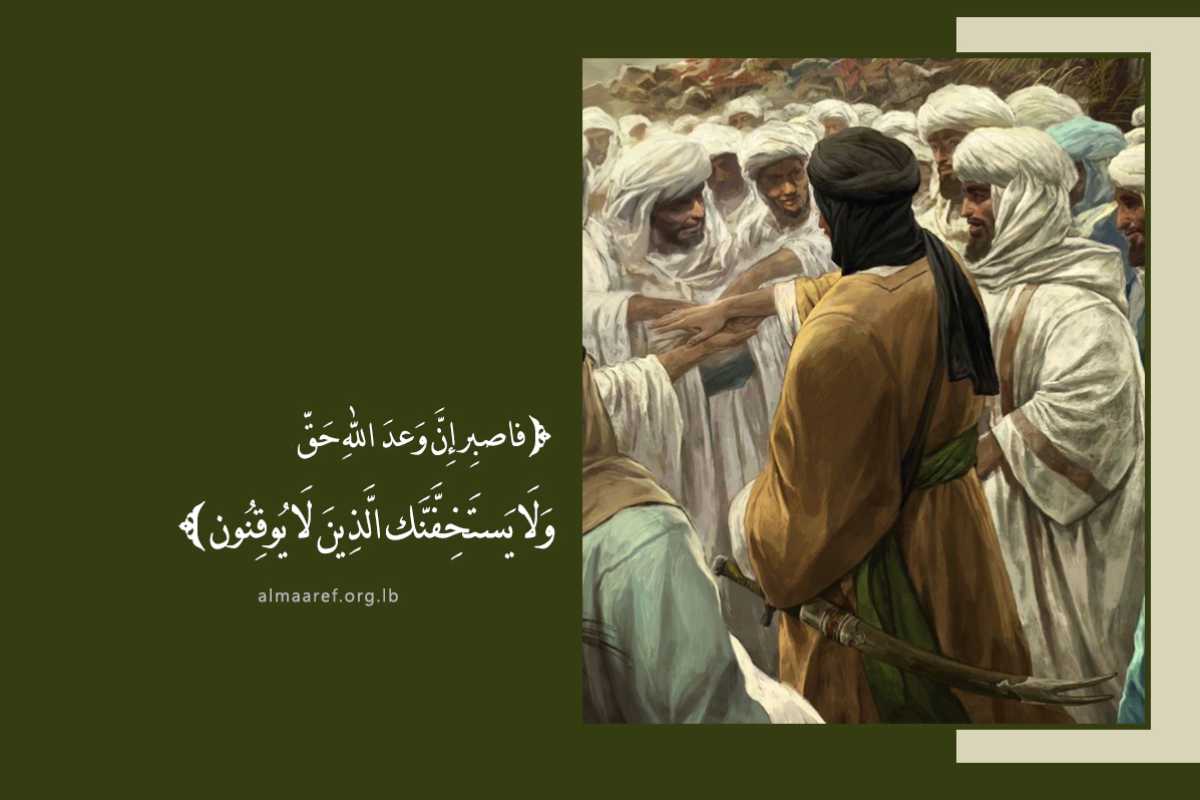خصائص المجتمع النامي، خصائص المجتمع الإسلامي
يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة مثلًا للمسلمين الّذين يتّبعون التعاليم النبويّة الشريفة، وهذا المثل له علاقة وطيدة مع موضوع بحثنا.
عدد الزوار: 998خصائص المجتمع النامي، خصائص المجتمع الإسلامي
خصائص المجتمع الاسلامي
﴿ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطَۡٔهُۥ فََٔازَرَهُۥ
فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ..﴾1. يذكر الله
تعالى في هذه الآية الكريمة مثلًا للمسلمين الّذين يتّبعون التعاليم النبويّة
الشريفة، وهذا المثل له علاقة وطيدة مع موضوع بحثنا.
يقول القرآن الكريم: إنّ هؤلاء المسلمين قد ذُكِروا في الإنجيل كالزرع الّذي يخرج
ورقه بادىء ذي بدء، وهو لا شكّ رقيق
﴿ أَخۡرَجَ شَطَۡٔهُۥ
﴾، لكن لا يبقى هذا
الورق على حاله، إذ كلّما انتشر في الأرض وأصبح له سويق، قوي وكانت له صفة أخرى أي
يقوي الورقة الأولى الّتي بدأت في الظهور
﴿ فََٔازَرَهُۥ
﴾، بعد ذلك يقوى أكثر
ويكون سميكًا
﴿ فَٱسۡتَغۡلَظَ
﴾ ثمّ ينتصب قائمًا على سويقه
﴿ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ
سُوقِهِۦ
﴾، وحينما ينظر إليه الزرّاع يغمرهم العجب وينبهرون. وهذه هي نفسها حالة
النمو والاستقلال والسموّ الّتي تغضب الأعداء وتكون شوكة في عيونهم، وحينما ينظر
الكفّار إلى تلك الفئة المؤمنة فإنّهم يزدادون غيظًا.
ما هو هذا المثل المذكور؟ يجيبنا القرآن نفسه أنّ هويّة أصحاب هذا المثل، أنّهم
﴿ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا
سُجَّدٗا
﴾.
أرجو منكم أن تنتبهوا إلى هذا الموضوع في ضوء الآية الكريمة المذكورة، وهو أنّ
العبادة لا تنفصل عن صميم الإسلام، وأنّ بعض الأشخاص ممّن اطّلع على الفكر الإسلاميّ
قد سبّب لهم هذا الاطّلاع أن ينظروا إلى العبادة نظرة ازدراء وامتهان، ولكنّ هؤلاء
على خطأ لأنّ العبادة جزءٌ لا يتجزّأ من الإسلام على الصعيد النظريّ والعمليّ في آنٍ
واحد، فلا العبادة لها نكهتها دون الفكر والتعاليم الاجتماعيّة الإسلاميّة، ولا
الفكر والتعاليم لهما طعمهما دون العبادة، فلا بدّ من اجتماع الاثنَيْن.
وقبل هذا يقول القرآن الكريم في وصف تلك الثّلة المؤمنة:
﴿ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا
مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ
﴾ أي أنّهم يريدون من الله الكثير، ولا يقنعون بما
عندهم، بل يريدون أكثر علمًا أنّ ما يريدونه ليس من الأشياء الّتي يطلبها المادّيون
الّذين يلهثون وراء المال والمادّيات فقط.
إنّ هؤلاء المؤمنين، في الوقت الّذي يطلبون فيه الكثير من الخير، فهم يقرنونه
بمرضاة الله تعالى، أي يطلبون رضاه (جلّ شأنه) مقرونًا مع الخير الكثير، فطلبهم
الكثير يصبّ في طريق الحقّ والحقيقة.
بعد ذلك يقول:
﴿ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ
﴾، فالإسلام
ظاهر على ملامح وجوههم، وآثار العبادة بارزة على محيّاهم، وليس المقصود من هذا كثرة
السجود الّذي يؤدّي إلى ظهور ثفنات في جباههم، بل المقصود هو أنّ خصوصيّة العبادة
تترك أثرًا على سيماء الإنسان العابد وتؤثّر في سلوكه. وهناك علاقة عظيمة بين روح
الإنسان وجسده. وأفكار الإنسان، وأخلاقه، وآراؤه، وملكاته تترك بصماتها على محيّاه،
فمحيّا الإنسان المصلّي ليس كمحيّا تارك الصلاة.
ما أعظمه من مثل ضربه الله تعالى للمسلمين الأوائل! إنّه مثل الوعي والتكامل، إنّه
مثل المؤمنين الّذين يرتقون سلّم الرقي والتطوّر، ووجودهم شطر الكمال والتقدّم
دومًا وأبدًا.
والمثل هو تشبيههم بالزرع الّذي تتفتح أوراقه، ثمّ يكون له سويق سميك ذو أوراق
كثيرة، ويكون شجيريًا لا كسائر الشجيرات. إنّه الزرع الّذي يبهر الزرع أنفسهم بل
ويبهر الذين لهم باع في التربية الإنسانيّة كافّة، إذ حينما ينظرون إليه يملأ العجب
كلّ وجودهم من نموّ بهذه السرعة، وجودةٍ بهذه الدرجة، ويملأ العجب كيان سقراط
وأمثاله. أجل، فإنّ من الأمور المحيّرة للبشريّة على الصعيد العالمي تلك السرعة
الفائقة لنمو المسلمين واستقلالهم، والّذي يعبّر عنه القرآن الكريم بالآية:
﴿ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ
﴾، أي يقف وحده على أقدامه.
شخصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القياديّة
قال أحد الأوروبيّين: إنّنا لو أخذنا بعين الحسبان ثلاثة أشياء، فإنّنا سنعترف
عندها أن لا وجود لشخص في العالم كمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا قيادة فيه
كقيادته. وهذه الأشياء هي:
أوّلًا: عظمة الهدف وأهميّته. نعم، لقد كان الهدف عظيمًا ومُهمًّا للغاية، إذ حدث
انقلاب في الروح العامّة للناس ومعنويّاتهم وأخلاقهم وآرائهم ونظمهم وتقاليدهم
الاجتماعيّة.
ثانيًا: ضآلة حجم الإمكانيّات والوسائل آنذاك. ماذا كان عنده من أدوات ووسائل؟ لقد
كانت معه عشيرته الأقربون، فلم يكن لديه مال ولا قوّة، ولا مساند ولا ناصر. إنّها
أعجوبة حقًّا أن يتمكّن شخص واحد من كسب الناس، وجعلهم يؤمنون به، ويلتفّون حوله،
حتّى أصبح أكبر قوّة في العالم.
ثالثًا: سرعة الوصول إلى الهدف، إذ أصبح أكثر من نصف النّاس في العالم مسلمين خلال
أقلّ من نصف قرن. عند ذلك يثبت ما ذكرناه من أنّه لا وجود لقيادة في العالم كقيادته
صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو قصد القرآن من قوله:
﴿ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ
﴾، إذ أنّ الأخصّائيّين والخبراء في التربية الإنسانيّة ينبهرون إلى الأبد بسرعة بظهور
المسلمين ونموّهم واستقلالهم ونتاجاتهم. وهذا المثل قد ذكر في القرآن المجيد للأمّة
الإسلاميّة.
خصائص الإسلام التنمويّة
أوّد أن أطرح هنا سؤالًا، وهو: هل إنّ هذه المواصفات الّتي ذكرها القرآن الكريم تخصُّ
المسلمين الأوائل، وإنّهم يجب أن يتّصفوا بها؟ وهل إنها من خصوصيّاتهم بالذات أو
خصوصيّات الإسلام نفسه؟ وبعبارة أخرى، إذا وجد أناسٌ في أيّ زمان ومكان كانوا،
واعتنقوا الإسلام، وعملوا بأحكامه، فإنّهم سيحملون المواصفات المذكورة ذاتها من نمو،
وتكاثر، وكمال، واستقلال، ونيل إعجاب الآخرين وانبهارهم. فالخصائص إذًا هي خصائص
الإسلام وليست خصائص الناس، وهي نابعة من الإيمان بالإسلام واتّباع تعاليمه. وما
جاء الإسلام ليعطّل طاقات المجتمع ويقف حائلًا دون تفتقها، أو يُرغم المسلمين
ليعيشوا في دوّامة من المراوحة الرتيبة. كلا، إنّه دين التّنمية والتحرّك والنشاط،
ودين برهن من الناحية العمليّة أنّه قادرٌ على الأخذ بيد المجتمع إلى الإمام حيث
الرقيّ والتقدّم. ولاحظوا ماذا أحدث الإسلام من ثورة، وماذا قدّم من عطاء في القرون
الأربعة الأولى من حياته!
يقول "ويل ديوارنت" في "تاريخ الحضارة": "لا حضارة تبعث على الانبهار كالحضارة
الإسلامية". إذًا، الإسلام كشف عن خصوصيّاته على الصعيد العملي، ولو كان الإسلام من
دعاة الجمود والانكماش والرتابة لظلّ يراوح في مكانه بين العرب! ولو لم تكن له
حضارة لما تقدّم، ودعا إلى التطور والتقدّم، وما تلك الحضارة الباهرة الرائعة الّتي
صنعها على مرّ التاريخ، وما تلك المعطيات الحضارية والثقافية ال!تي زخرت بها حضارته
الأولى، إلّا دليل على أنّه لا يتعارض مع تطور الزمن وتقدّمه!
نظرة الغربيّين للإسلام السياسيّ
إنّ من الإنصاف القول إنّ "للغوستاف لوبون" دراسات متعدّدة حول التاريخ الإسلامي،
وكتابه قيّم للغاية. ولكن يتطرّق أحيانًا إلى مواضيع تبعث على العجب والدهشة، ولا
غرو فهذا هو ديدن الغربيّين وأسلوبهم. إنّه عندما يصل به المقام إلى الحديث عن
أسباب انحطاط المسلمين وأفول الحضارة الإسلاميّة، يذكر - غباءً - تعارض الإسلام مع
متطلّبات العصر كأحد الأسباب. وهذا هو فهمه كإنسان غريب عن الإسلام وحضارته، حيث
ينظر إليه من زاويته الخاصّة فيقول: "إنّ الزمن في تطور، لكنّ المسلمين يريدون أن
يبقى الإسلام في كلّ عصر على حالته التّي كان عليها في عصره الأول، وهذا أمر لا
يمكن تحققه. وكذلك فهم بدل أن يتركوا الإسلام جانبًا، ويسايروا تطوّرات العصر،
نراهم بقوا على تمسّكهم بالإسلام فانحطّوا وتخلّفوا".
في ضوء ما تقدّم، فكلّ شخص يرغب أن يتعرّف إلى المثال الذي يذكره هذا المستشرق
الكبير لدعم مزاعمه! يا للعجب العجاب، فأيّ مبدأ من مبادئ الإسلام تمسّك به
المسلمون فتخلّفوا ولم يواكبوا التطوّرات الحاصلة في كلّ عصر؟ وأيّ مبدأ في الإسلام
وجده "غوستاف لوبون" لا يلائم متطلّبات العصر ومستلزماته؟ وأيّ شيء لمسه من
المسلمين حتّى قال: إنّهم كشفوا عن جمودهم وتحجّرهم من خلال عدم مسايرتهم لتطوّرات
العصر، والمفروض - على حدّ قوله - أن لا يتحجّروا ويكونوا ضيّقي الأفق، بل عليهم أن
يواكبوا تلك التطوّرات ويكيّفوا أنفسهم معها؟.
ويستطرد قائلاً: "إنّ من المبادىء الإسلامية الرائعة المعطاءة مبدأ المساواة الّذي
أتى أكله في عصر صدر الإسلام، ومهّد السبيل للشعوب الأخرى لتدخل في دين الله
أفواجًا، ولا سيّما من غير العرب كالفرس الّذين اكتووا بنار ظلم حكّامهم وعلمائهم
من المؤبدين. وهؤلاء عندما اطّلعوا على ذلك المبدأ العظيم انفتحوا على الإسلام
واعتنقوه؛ لأنّهم لم يجدوا فيه تمييزًا عنصريًّا أو طبقيًّا، وراقت لهم تعاليمه
الساميّة. لقد كان هذا المبدأ في بادئ الأمر يصبّ في خدمة المجتمع الإسلاميّ، وظلّ
المسلمون الّذين جاؤوا فيما بعد على إصرارهم وتعنتهم في الاستمرار بتطبيق هذا
المبدأ في العصور اللّاحقة في حين أنّهم لو نبذوه جانبًا لظلّت زمام الأمور بأيديهم،
وكانت لهم السيادة والحاكميّة. وعندما تسلّم العرب مقاليد الأمور، ودخلت الشعوب
الأخرى في الإسلام، كان عليهم أن يفضّلوا السياسة على الدّين، ويقدّموها عليه؛ لأنّ
السياسة تقتضي ترك مثل هذه المفاهيم والمبادئ، واستغلال الشعوب الأخرى، وجرّها
لتكون تحت نيرها وسلطتها حتّى تستطيع توطيد أركان حكومتها. هذه هي السياسة، أمّا
هؤلاء فكانوا لا يفهمون، إذ تشبّثوا بمبدأ المساواة، ولم يفرّقوا بين العرب وغيرهم،
وفتحوا الطريق أمام الأعاجم وكسبوهم إلى صفوفهم، وعيّنوهم قضاة من الدرجة الأولى
بعدما هيّؤوا لهم الفرصة للتزوّد من التعاليم الإسلاميّة. وجاء هؤلاء بالتدريج،
وأصبحوا في موضع قوّة وقدرة، فسحبوا البساط من تحت أرجلهم أي أرجل العرب. وأوّل من
كان لهم قصب السبق في ذلك هم الفُرس الذين سيطروا على الوضع إبّان الحكم العباسي
مثل البرامكة وآل سهل. وعيّنوا أقاربهم ومعارفهم في مناصب الدولة المختلفة بعدما
عزلوا العرب عنها. كانت هذه الحوادث في أوائل القرن الثاني، ومرّت سنون كانت
السيادة فيها للفرس، ولا سيّما في عصر المأمون إذ بلغت أوجها وذلك لأنّ أمه كانت
فارسيّة حتّى يُنقل أنّ المأمون كان مارّاً ذات يوم في طريق، فاعترضه إعرابيٌّ
قائلًا له: "اعتبرني واحدًا من الفرس وأغثني". وظلّت هذه الحالة حتّى عصر المعتصم
حيث تغيّرت الأوضاع تمامًا، وانقلبت ضدّ الفرس والعرب في آن واحد بلحاظ أنّ أم
المعتصم كانت تركيّة، لهذا تعامل المعتصم بقسوةٍ وفظاظة مع الاثنَيْن محافظة منه
على منصبه، فكان سيِّئ المعاملة مع العرب لأنّه كان يعتبرهم من أنصار بني أميّة،
وكانت سياسة هؤلاء عربيّة، وكانوا يفضّلون العرب على غيرهم. نعم، كان العرب من
أنصار بني أميّة، وكان العباسيّون - على العموم - ضدّ العرب لأنّهم كانوا يعتبرونهم
أنصار بني أميّة وحماتهم. وقد عمل العباسيّون على إحياء اللّغة الفارسيّة؛ لأنّهم
كانوا لا يرغبون في تذويب الفرس بالعرب، وقد أصدر إبراهيم الإمام أوامره إلى مناطق
إيران كافّة بقتل كلّ عربي (وقد ذكر هذه التعليمات جرجي زيدان وغيره من المؤرخين).
نعم، وكان المعتصم ينظر إلى العرب على أنّهم أنصار الأمويّين، وإلى الفرس على أنّهم
أنصار العباسيّين ومؤيّدو العبّاس نجل المأمون، لذلك سافر إلى "تركستان" فجلب أقارب
أمّه من هناك، وفوّض لهم كثيرًا من أمور الدولة، وبهذا يكون قد أبعد الاثنَيْن:
العرب والفرس، عن زمام الأمور، وقلّدوها قومًا آخرين وهم الأتراك".
هذا هو كلام "غوستاف لوبون"، وكلّ ما فيه هو لماذا أعرض العباسيّون عن اتّباع
السياسة الأمويّة العربيّة مع أنّهم كانوا عربًا، ولا يدري هذا الرجل فقد غاب عن
ذهنه أنّه رأى في فضيلة من فضائل الإسلام عيبًا ونقصًا فيه، ودليلًا على عدم انسجام
الإسلام مع متطلّبات العصر، وشاهدًا على جمود المسلمين وتحجّرهم.
إنّه يقول: "إنّ هذا المبدأ جيّد من الناحية الأخلاقية، ولكنّه من الناحية
السياسيّة قد يكون كذلك وقد لا يكون، وقد يكون مناسبًا لزمن معيّن، حيث يساعد على
كسب الشعوب الأخرى للإسلام، ولكنّه قد لا يكون كذلك في زمن آخر، حيث ينبغي على
المسلمين أي العرب في تلك الفترة أن يتخلوا عن مبدأ المساواة سياسيًّا؛ لأنّ الظروف
لا تساعد على وجوده".
حقًّا، لقد وقع "غوستاف لوبون" في خطأ؛ لأن التوجه السياسي في الإسلام غير في
أوروبا.
النظرة الصحيحة لمتطلّبات العصر
أولًا: لأنّ المسلمين لو اتّخذوا من الإسلام ألعوبة للسياسة، لما كان له هذا الأثر
الّذي هو عليه، ولما كان المسلمون أمّة بهذا الشكل.
ثانيًا: إنّ هدف الإسلام هو إقرار المساواة بين النّاس بشكل تامّ، ولو شرّع الإسلام
مبدأ نفعيًّا على النحو المؤقّت، أي: مثلًا، لكسب بعض الناس والاستفادة منهم، ثمّ
بعد ذلك نقضه لما كان إسلامًا حقيقيًّا بمعنى الكلمة. ولا شكّ، فإنّ هذا هو دأب
السياسة الأوروبيّة أنّها تسنّ مبدأ، ثمّ تنسفه من وحي الدوافع المصلحيّة. فمثلًا،
تصدر وثيقة حقوق الإنسان لتنضوي بقيّة الشعوب تحت سلطتها وهيمنتها كما حدث ذلك،
وإذا ما انضوت فإنّها تقول لها: كلّ هذا الكلام لا طائل تحته ولا قيمة له.
هذا هو أسلوب التفكير السائد عند هؤلاء. أنّهم يقولون: إنّ الإسلام فظٌّ غير مرن
ولا ينسجم مع متطلّبات العصر، وبعبارة أخرى مع السياسة. ونحن نقول: إنّ الإسلام جاء
لمحاربة أمثال هذه السياسة المنحرفة في العالم. إنّه لا يعتقد بمتطلّبات العصر
الّتي يريدها هؤلاء، ولا يقرّ بها كمستلزمات حقيقيّة للتطوّر والتقدّم. إنّه
يعتبرها انحرافات العصر لا متطلّباته، ويعلن محاربته لها ووقوفه ضدّها.
إنّ ما ذكره "غوستاف لوبون" وأمثاله هو نفس المؤاخذة الّتي تشدّق بها البعض ضدّ
سياسة أمير المؤمنين عليه السلام، فقالوا عنه: "إنّ كل شيء فيه حسن، إذا كان رجل
علم وعمل وتقوى وعاطفة وإنسانيّة وحكمة وخطابة، لكنّ عيبه الوحيد والكبير أنّه لم
يكن سياسيًّا!". لماذا لم يكن سياسيًّا؟ لأنّه - على حدّ زعمهم - لم يكن مرنًا أي:
كانت تعوزه المرونة، وكان متشدّداً للغاية حيث لم يهتمّ ولم يفكر بالمصالح
السياسيّة للدولة. إنّ الشخص السياسي - برأي هؤلاء - ينبغي أن يكذب ويزوّر الحقائق،
ويعد ولا يفي بوعوده، ويوقّع على ميثاق أو حلف، ثمّ ينقض توقيعه بل وينكره، ويظهر
البشاشة والطلاقة بوجه شخص ما حتّى إذا استسلم له قتله. [هذا هو السياسيّ في عرف
هؤلاء دون سواه، فما أجهل هؤلاء وما أغباهم! إنّ هؤلاء يرون أبا جعفر المنصور
سياسيًّا لأنّه تحالف مع أبي مسلم الخراساني وفوّض إليه بعض الأمور، وأبو مسلم هذا
نهض لصالح المنصور ولم يترك جريمة إلّا وارتكبها لصالح بني العباس]. علمًا أنّ بعض
الإيرانيّين - ويا للأسف - يعبّرون عنه بالبطل الوطني. علينا أن نكون حذرين ونعرف
أنفسنا حيث يردّدون دائمًا هذا اللقب. وما أدرى الإيرانيّين كم قتل أبو مسلم منهم؟
لقد قتل أكثر من ثلاثمئة أو أربعمئة ألف، وفي خبر آخر ستمائة ألف. فكم كان مجرمًا!
وإلى أي حدّ يصل الإجرام بالإنسان؟ [لقد كان المنصور سياسيًّا - من وجهة نظر هؤلاء
المتشدّقين - والسياسة الّتي يقصدونها تعني استعمال الخداع ومختلف الحيل، وتعني
البطش والتنكيل، وتعني استغلال الآخرين لتحقيق مآربهم كما نرى المنصور قد استغلّ
أبا مسلم للفتك بأعدائه، وقد نفّذ الأخير ما أُريد منه، وبمجرّد أن أراح الخليفة من
خصومه ومناوئيه، برز نجمه وعلا كعبه تدريجيًّا حتّى أصبح يدًا للمنصور نفسه، فرأى
فيه المنصور خطرًا على حكومته. ففي إحدى السنين، ذهب أبو مسلم إلى مكة على رأس جيش
جرّار، وحينما عاد منها، ووصل مدينة الريّ استدعاه المنصور قائلًا له: "عندي معك
شغلٌ". لكنّ أبا مسلم لم يذهب، وكتب له مرّة ثانية وثالثة فلم يذهب أيضًا وأخيراً
كتب له رسالة هدّده فيها. فتردّد أبو مسلم بين الذهاب وعدمه، واستشار الكثيرين
فأشاروا عليه بعدم الذهاب لوجود خطر عليه. ولكن، كما يقال أتتك بخائن رجلاه، فذهب
وحده بناءً على أوامر المنصور نفسه، فدخل عليه وسلّم معظّمًا إيّاه، وبعد أن سأله
المنصور عن أحواله، طفق يغيّر معه لهجته ويؤنّبه، طارحًا عليه بعض الأسئلة منها:
لماذا لم تنجز العمل الفلانيّ؟ ولماذا عصيتني في الأمر الفلانيّ؟ وهكذا، ولمّا رأى
أبو مسلم أنّه قد وقع في مأزق، وأنّ المنصور مصمّم على قتله، عرض عليه أن يعفو عنه
ليقضي على أعدائه، أي أعداء المنصور، فقال له المنصور: "لا عدوّ لي هذا اليوم أشدّ
منك". وكان المنصور قد وضع خلف الباب عددًا من جلاوزته مع أسلحتهم، وأوصاهم أنّه
بمجرّد أن يعطيهم إشارة متّفق عليها يهجموا على أبي مسلم ويقتلوه. وبينما كان
مشغولًا في تعنيفه وتقريعه، أعطى تلك الإشارة، فهجم الجلاوزة على أبي مسلم وقطّعوه
إربًا إربًا، ثمّ لفّوه في خرقة. نعم، فإنّ المنصور - برأي هؤلاء - سياسيٌّ كبير،
لأنّه يعرف كيف يقضي على مناوئيه.
أمّا الإمام عليّ عليه السلام فإنّهم ينتقدونه لأنّه لم يتعامل مع الأحداث كتعامل
المنصور، مثلًا يقولون: لماذا لم يداهن الإمام معاوية؟ ولماذا لم يكتب له كتابًا
يستغفله فيه؟ ولماذا لم يتركه على حاله؟ وما هو السبب الّذي دعاه أن لا يبقيه على
السلطة ويخدعه بذلك، ثم يستدعيه إلى مركز الخلافة ويقتله وفق خطّة مدبّرة؟ لماذا لم
يكذب في سياسته، ولم يفرّق بين أحد، ولم يرشِ أحدًا؟ ولماذا لم يعمل الإمام في بيت
المال كما عمل معاوية؟، وأمثال ذلك من الأسئلة الّتي يثيرونها مدّعين أنّ نقض
الإسلام يكمن في كونه متشدّدًا، ولا ينسجم مع متطلّبات العصر. وإذا ما أراد السياسيّ
أن يعمل وفق الإسلام فلا يمكنه أن يكون سياسيًا عندئذٍ.
وكما ذكرنا، فإنّ الإسلام ما جاء إلّا ليكافح هذا اللون من السياسة، ويعمل كلّ ما
في وسعه لخدمة البشريّة وإسعادها، وهو - بلا شكّ - الحارس الأمين لها، ولو كان قد
أبدى شيئًا من المرونة والتنازل، فلا يعدو أن يكون إسلامًا، بل حيلة ومكرًا. إنّ
الإسلام هو الحافظ الصحيح للأمور، وهو الحقيقة ذاتها، والعدالة نفسها. وأساسًا، فإنّ
فلسفته في مثل تلك المواقف المذكورة ينبغي أن تكون قويّة متصلّبة.
إنّ سياسة علي عليه السلام هي الّتي جعلت منه حاكمًا على قلوب الناس قرونًا عديدة.
إنّه دافع عن أفكاره في عصره، وظلّت أفكاره بمثابة مبادئ ثابتة ودروس ذات مغزى في
العالم، لهذا فإنّ منهجه صار عقيدة وإيمانًا بين الناس، فلم يخسر في سياسته إذًا،
ولو كانت سياسته وهدفه أن يستعذب متاع أيّام قلائل (كما كان معاوية الّذي كان يصرّح
بأنه غرق في نعم الدنيا ومباهجها)، لقلنا أنّه خسر، لكن بما أنّه كان رجل إيمان
وعقيدة وهدف فلم يندحر ولم يخسر أبدًا. إذًا، من التوقّعات الخاطئة الّتي ينتظرها
هؤلاء فيما يخصّ الانسجام مع متطلّبات العصر، هي أن يتلّون السياسيّون بلون كلّ عصر،
ويتّصفوا بالدّهاء والمكر والخديعة؛ كالثعلب الماكر، مطلقين على ذلك اسم المرونة
والذكاء والانسجام مع الزمان. ويتوقّعون من الإسلام أن يكون كذلك، وأن يسمح
لمعتنقيه بأن يكيّفوا أنفسهم مع الزمن، مدّعين أنّ نقص الإسلام يكمن في عدم مرونته
وانفتاحه على التطوّرات الحاصلة في كل عصر. وقد غاب عنهم أنّ من دواعي فخر الإسلام
واعتزازه أنّه وقف بكلّ صلابة، أمّا هذه الأباطيل ولنا أن نسأل هؤلاء: أين تكمن
عظمة الحسين عليه السلام؟ هذا الإمام الّذي أخذ بمجامع القلوب، وخلّدته الدهور.
إنّها تكمن في أنّه لم يكن متلوّنًا انتهازيًّا، ولم يكن ماكرًا مخادعًا، بل كان
صادقًا نزيهًا عفيفًا في توجّهاته وممارساته، ولم يتأثّر بظروف عصره، كما لم ينتحل
نحلة حكّام عصره، فلم يكن أمويًّا، مثلًا عندما حكم معاوية أو ولده يزيد، وهذه قمّة
النزاهة والصدق، ولمَ لا يكون ذلك؟ وهو لم يألف الوصوليّة والنفعيّة والانتهازيّة
أساليب للانسجام مع كلّ عصر! ولذلك عندما عرض عليه الوزغ الدنيء مروان أن يبايع
يزيد، لم يفكّر بمصلحته الشخصيّة بل فكّر بمصلحة دينه ورسالته، وكانت لا تهمّه
مصلحة أخرى غير هذه المصلحة، وذلك لأنّه الإمام الهادف المسؤول، ولذلك أجاب قائلًا:
"على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمّة براعٍ مثل يزيد"2.
* الإسلام والحياة، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1 سورة الفتح، الآية 29.
2 العلامة المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة
الأطهار، بيروت، نشر دار إحياء التراث العربي، 1403هـ، ط 2، ج 44، ص 326.