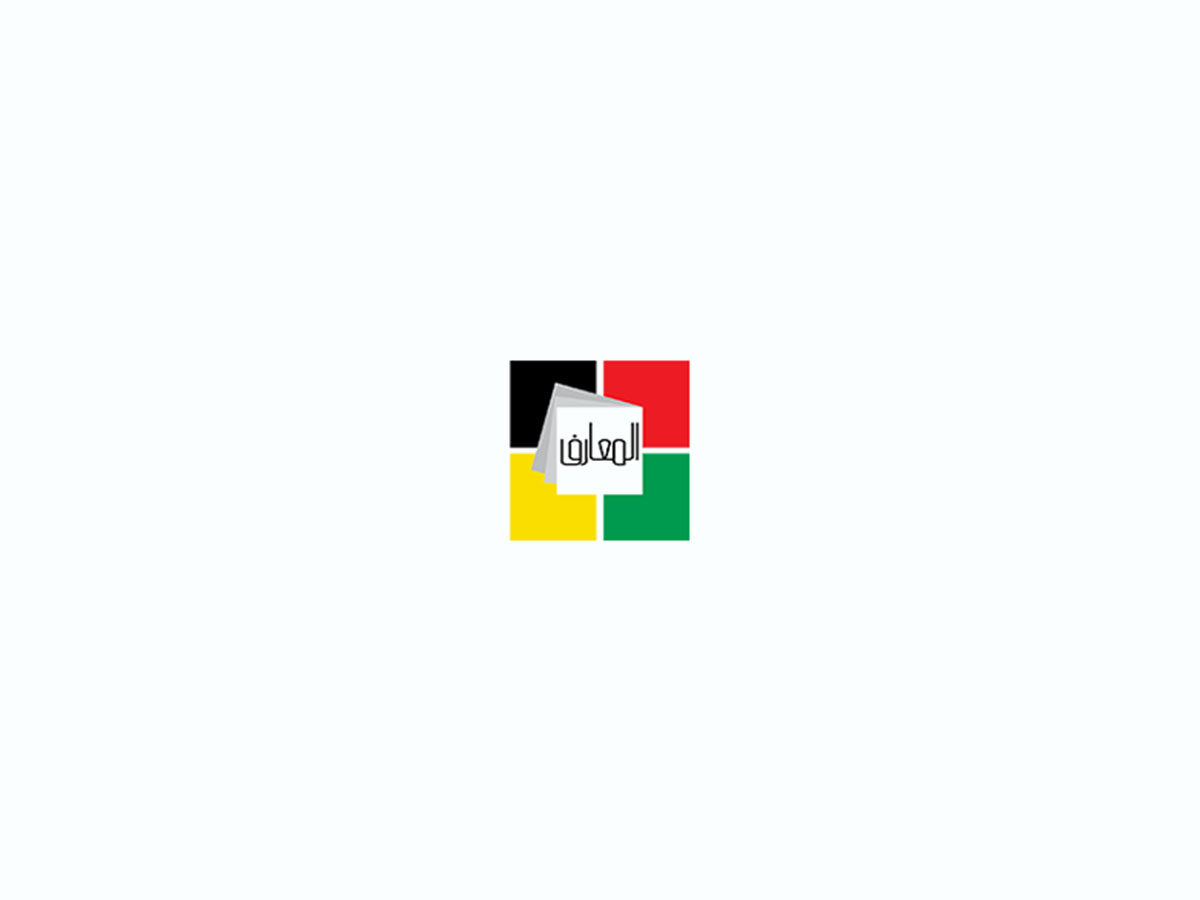الحكمة من وجود المتشابهات في القرآن
هنا ربّما يتبادر هذا السؤال وهو، لماذا لم ينزل القرآن بنحو تكون جميع آياته بيّنةً ومحكمةً بعيدة عن أي إبهام وإجمال، لتكون يسيرة الفهم والفائدة للجميع على حد سواء؟
عدد الزوار: 1159
هنا ربّما يتبادر هذا السؤال وهو، لماذا لم ينزل القرآن بنحو تكون جميع آياته
بيّنةً ومحكمةً بعيدة عن أي إبهام وإجمال، لتكون يسيرة الفهم والفائدة للجميع على
حد سواء؟
للإجابة على هذا السؤال نورد في البداية مقدمةً موجزة: إنّ عقلنا نحن العاديين من
الناس تابع للعوامل الطبيعية، فعندما يولد الناس العاديون يتعرفون على الحسيات في
البداية عن طريق الحواس، وفي البداية يتبلور فهمهم وإدراكهم في حدود المحسوسات
والماديات، لكن القوى الفكرية للإنسان تنمو تدريجياً، وتحصل شيئاً فشيئاً على
القدرة على التجريد، وبالنتيجة تحصل لديه القابلية على إدراك الأمور ما فوق
المادية، فكلما تمتع عقل الإنسان بالمزيد من النمو وقوة التجريد، وخرج عن أجواء
المادة والماديات، فهو يدرك أفضل بنفس هذا المستوى حقائق ما وراء الطبيعة، وبما أنّ
جميع الناس ليسوا سواء من حيث النمو العقلي، فهم لا يكونون سواء أيضاً في إدراك
الأمور غير المحسوسة، فليسوا قلّةً الناس الذين تمضي عشرات السنين من أعمارهم، لكن
فهمهم وإدراكهم يبقى بمستوى فهم وإدراك الأطفال في السابعة أو الثامنة من العمر،
وربّما يمضي عمرهم وهم ما يزالون يتصورون لله والمجردات زماناً ومكاناً، لأنّ فهمهم
وقابليتهم وقدرتهم على التعقّل، وقابليتهم العقلية بقيت في حدود الماديات، في حين
أنّ أساس الدين هو الإيمان بالغيب، أي الإيمان بالحقائق المجردة وغير المادية، يقول
القرآن:
﴿ذلِكَ
الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتّقِينَ * الّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ﴾1.
بناءً على هذا، إنّ أساس الإيمان هو أن يؤمن الإنسان بحقائق غير محسوسة ويعتقد بها،
ولكن ما هي حقيقة وكنه تلك الحقائق؟ إنّه أمر ليس ممكناً إدراكه إلاّ بالإلهامات
الإلهية التي تنزل على قلوب الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام، ونحن البسطاء
من الناس لا سبيل أمامنا لإدراك نفحة من أمور ما وراء الطبيعة وحقيقتها إلاّ بترصين
قوانا العقلية والعبور التدريجي من المحسوسات إلى المجردات وأمور ما وراء الطبيعة.
من ناحية أخرى أنّ الألفاظ التي تُستخدم في دائرة المجردات غالباً ما وضعت من أجل
المعاني المحسوسة:
﴿يَدُ
اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾2
أو:
﴿هُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾3
فمفردات فوق، على، عالي وعلو إنّما تعني جميعها العلو في مقابل الأسفل والداني، من
البديهي أنّ الإنسان لا يدرك في البداية من هذه المفردات معنىً أوسع من المعنى
الحسي، فالإنسان مثلاً يضع رأسه ملاكاً للعلو، وكل ما يقع بمستوى الرأس ويرتفع نحو
السماء يعتبره عالياً، ويجعل من قدمه ملاكاً للداني وكل ما هو أدنى منه يعتبره
دانياً، ولهذا السبب يقول إنّ السماء عالية والأرض، واطئة وبدخوله إلى الحياة
الاجتماعية يخرج تدريجياً عن هذه المعاني الحسية فيدرك المعنى غير الحسي والانتزاعي
لها، أي عندما يقال إنّ فلاناً مقامه عالياً أو ارتفع، لا يدرك الإنسان من هذه
المفردة ذلك المعنى الحسي لِما هو أعلى من الرأس، ولا يتداعى لديه من الهبوط ذلك
المعنى الحسي للكلمة.
من الطبيعي أنّ المعنى المراد في مثل هذه الاستخدامات قد جُرّد من اللوازم المادية
والمحسوسة، فعندما يقال إنّ الذي يخلق الكون بأجمعه بإرادة واحدة منه له مقام عالٍ
جداً، فإنّ العلوّ الذي يُنسب إلى الباري تعالى أكثر مدى إلى ما لا نهاية من ذلك
العلو الذي يُنسب إلى رئيس إزاء مَن هم تحت يديه، والفارق بينهما كالمسافة بين
الصفر وبين ما لا نهاية، وكالمسافة بين الحقيقة والمجاز، لأنّ كل علو وشأن اعتباري
إنّما هو عارية وزائل ما خلا العلو الحقيقي الذي هو جديرٌ بالله خالق الكون وله
وحده فهو الذي:
﴿إِذَا
أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾4.
وعلى هذا الأساس حين يقول القرآن:
﴿هو
العليُّ العظيمُ﴾5
فليس المراد هو العلو المادي والمحسوس لله، ولا المراد من عظمته العِظم والكبر
المادي والمحسوس، وأمّا ما هي حقيقة علو وعظمة الله؟ فهي مسألة لا تبلغها عقول
البشر، وطبعاً في الكثير من الحالات لا يوجد لفظ آخر غير الألفاظ التي تُستخدم
للمعاني الحسيّة، ولا مناص من استخدام تلك الألفاظ للتعبير عن المعاني المجرّدة
كقوله مثلاً: ( هو العليُّ العظيم )، فالعلو هو اللفظ الذي يُستخدم للإشارة إلى علو
السقف بالنسبة إلى الأرضية، والعظيم هو اللفظ الذي يُستخدم للإشارة إلى جبل دماوند،
ولكن حينما تُستخدم هذه الألفاظ بشأن الله فهي تُجرّد من معانيها الحسيّة، ومن
الطبيعي أنّ الأمر ليس بذلك النحو بحيث يودّي تجريدها إلى التوصّل إلى حقيقتها.
يقال إنّ الألفاظ والمعاني التي يحصل التوصّل إلى حقيقتها عن الطريق المذكور، تتّصف
بنوع من التشابه الباعث على الإبهام والمغالطة، فمَن لم يتمكّن حتى الآن من تجريد
المعاني المذكورة من الشوائب والمتعلّقات الحسية، عندما يوصف الله بـ (العليّ)
يتوهّم أنّ الله فوق السموات، في حين أنّ الله ليس بجسمٍ حتى يُتصوّر له مكان:
﴿فَأَيْنَمَا
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾6
لكنّه لا يفهم أكثر من ذلك، ومن الطبيعي أنّه غير مكلّف بأكثر ممّا يفهم، لأنّه لا
طاقة له على ما هو أكثر من ذلك.
وأمّا مَن تجاوز هذه المرحلة، وغدت لديه مقدرة أكثر على الفهم، وأضحى يدرك المعاني
الاعتبارية، عندما يقال (إنّ اللهَ عليٌ عظيمٌ) يظنّ أنّ علو الله يشبه علو ورفعة
مرتبة الرئيس بالنسبة إلى مَن هم تحت إمرته، ولكن أين هذا المعنى من علو الله؟!
إنّ مَن أمضى عمره في اكتساب العلم والحكمة وإدراك المعاني المجرّدة يفهم من العلو
معنىً أبعد من المعاني المذكورة، ويقول إنّ لله علواً وجودياً على ما سواه.
إنّ لكل المخلوقات وجوداً، ولله وجوداً أيضاً، ولكن لا يمكن مقارنة وجود الله تبارك
وتعالى مع الموجودات الأخرى من حيث علو المرتبة الوجودية، ولكن ما هي حقيقة هذا
العلو ورفعة المرتبة الوجودية؟ إنّه أمر يستطيع كل شخص الاقتراب منه على قدر فهمه،
وإن كان إدراك كنهه لا يتيسّر لأحد.
والآن في ضوء التوضيح المذكور، نقول: إنّ الله عندما يريد أن يتحدث لنا نحن بني
الإنسان، عن أمور تفوق فهمنا العادي، فهو يستخدم ألفاظاً يمكننا عند التأمّل فيها
إدراكها على قدر فهمنا، وإن كانت هذه المعاني تفوق فهمنا، ففي مثل هذه الحالات
لابدّ من استخدام ألفاظ متشابهة.
على هذا الأساس فإنّ الآيات التي تتحدث عمّا وراء الطبيعة وتفوق فهم الناس
العاديين، لابدّ أن تنطوي لا إرادياً على مرتبة من التشابه، ولابدّ من الاستعانة
بالمحكمات للاقتراب من حقيقتها، مثلاً عندما يقول القرآن:
﴿هُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾7
ولا ندرك حقيقة وكنه علو المرتبة الوجودية وحقيقة عظمة الله، لابدّ عند ذاك
من تفسيرها عبر الاستعانة بمحكمات القرآن مثل قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ ) (8)، لكي لا نقع في سوء الفهم وخطأ التفسير. تقول الآية الأُولى إنّ الله
عليُّ عظيم، فيما تصرّح الآية الثانية أنّ الله لا مثيل له ولا نظير، أي مهما
تصورتم من العلو والعظمة لله تعالى فإنّكم لم تدركوا علوّه وعظمته، لأنّ الله فوق
كل ذلك.
وهكذا الحال بالنسبة إلى صفات الله أيضاً، فحينما يقال إنّ الله عالم، الله قادر،
فمن البديهي أنّ حقيقة علم الله تعالى تفوق وتختلف عن ذلك المعنى، الذي يتبلور في
الذهن عن الإنسان من خلال إدراكه للصور الذهنية، وأمّا حقيقة علم أو قدرة الله،
وبشكل عام حقيقة أوصاف الله، فهو موضوع ليس ممكناً فهمه إلاّ لله الذي تعتبر ذاته
عين العلم وعين الحياة والقدرة.
لقد استخدم الله تعالى ـ من أجل إرشاد الناس إلى ذاته والى صفاته الإلهية ـ ذات
الألفاظ التي يدرك الناس منها ابتداءً تلك المعاني الحسية، لكي ينتفع الناس من تلك
المعارف السامية ولو قليلاً.
بناءً على هذا، فإنّ وجود الآيات المتشابهة في القرآن من الحكم الإلهية، التي
لولاها لانغلق كلياً أمام الإنسان سبيل إدراك المعاني والمعارف المجرّدة وغير
المحسوسة، بيد أنّ استخدام المتشابهات وتفسيرها وتبيينها ـ كما أشرنا سابقاً ـ يجب
أن يأتي من خلال الاستعانة بالمحكمات، لكن الأمر ليس بالشكل الذي ينتهجه كل مَن
يبتغي فهم القرآن ومعارفه، المسار المنطقي والعقلاني والطبيعي المشار إليه آنفاً
لغرض فهم المعارف الإلهية، ففي الآية موضوع البحث يشير تعالى إلى وجود آيات
متشابهات ومحكمات في القرآن، ويقول وأمّا الذين
﴿فِي
قُلُوبِهِم زَيغٌ﴾9
المصابون بداء روحي وقلبي وانحراف فكري، أو بعبارة أخرى
﴿فِي
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾10
يجعلون الآيات المتشابهات ملاكاً لفكرهم وعملهم، ويحملون الآيات المتشابهات من
القرآن الكريم على معاني حسيّة بدون الالتفات إلى الآيات المحكمات، ويوفّرون بذلك
دواعي ضلالهم وضلال غيرهم.
* تجلي القرآن في نهج البلاغة - مؤلف: آية الله محمد تقي مصباح اليزدي
1- البقرة: 2 و
3.
2- الشورى: 11.
3- الشورى: 4.
4- يس: 82.
5- البقرة: 255.
6- البقرة: 115.
7- الشورى: 4.
8- الشورى: 7.
9 آل عمران: 7.
10- البقرة: 10.