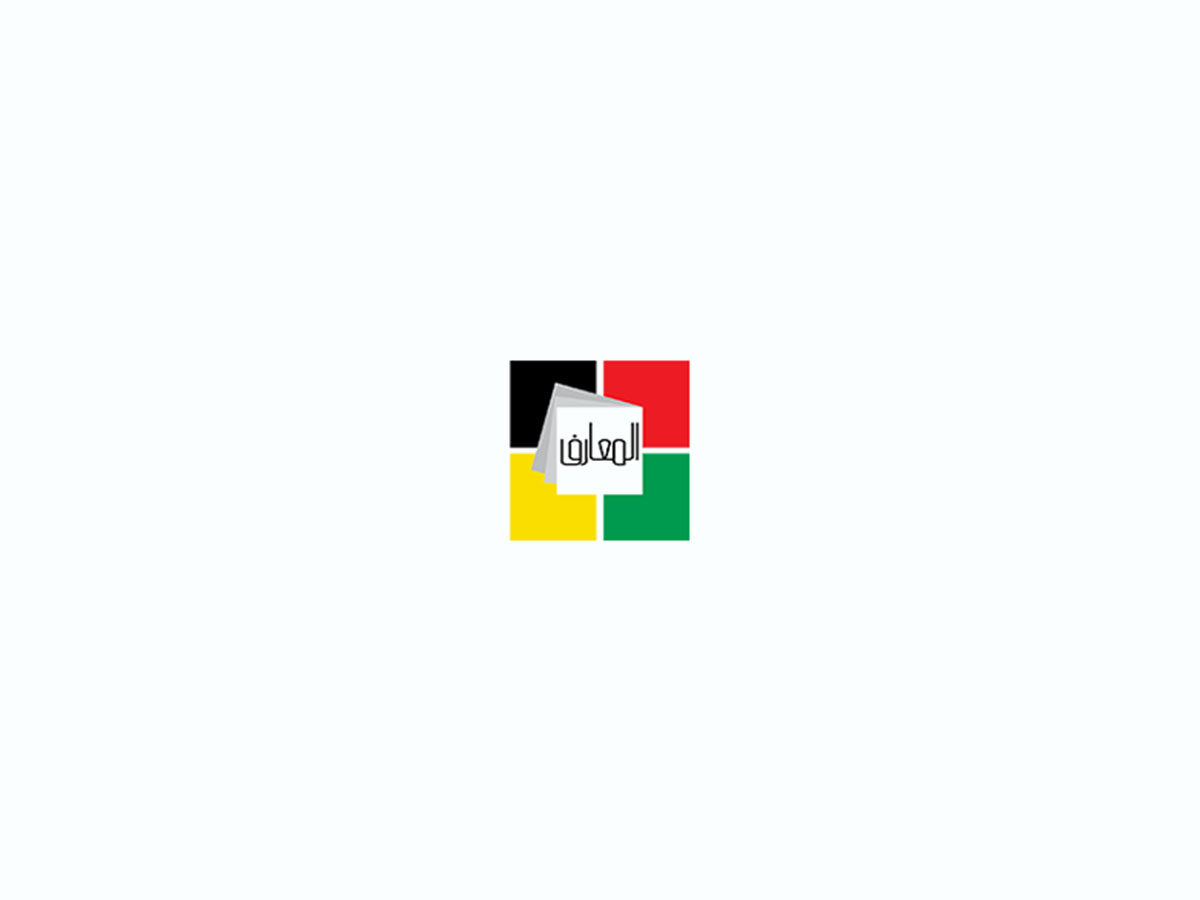(1): ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ﴾: الخطاب لرسول الله (ص) والمراد بالأنفال هنا
كل ما أًخذ من دار المحاربين بلا قتال، والأرض الموات، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية
والأحراج، وميراث من لا وارث له ﴿قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾: وما كان
لله فحكمه لرسوله، ومن كان للرسول فحكمه لمن كان له امتداد من بعده دينًا وإيمانًا
وحرصًا على الإسلام ومصالح المسلمين ﴿فَاتَّقُواْ اللّهَ﴾: ولا تحكموا بأهوائكم
وآرائكم، وعندكم كتب الله وسنة نبيه ﴿وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ﴾: بالاتفاق
كلمة واحدة ضد العدو المشترك. ثم حدد سبحانه المؤمنين المتقين بالصفات الآتية: (1):
(2): ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾:
إذا هموا بالمعصية وعزموا عليها، وأنذرهم نذير بغضب الله وعذابه – أحجموا واتقوا
وإلا فمجرد خشوع القلب بلا أثر فليس من الإيمان والتقوى في شيء (2):﴿وَإِذَا
تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانً﴾: بأنهم على بصيرة من دينهم،
وأنهم يصبرون على الجهاد في سبيله مهما تكن النتائج. (3): ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ﴾: ينهضون إلى العمل، ويبذلون غاية الجهد، وفي الوقت نفسه يفوضون أمر
النجاح لتوفيق الله وعنايته (4):
(3): ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ﴾: أبدًا لا يقبل سبحانه الإيمان بلا صلاة،
ولا مبرر عنده لتركها على الإطلاق، في الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، أجل من نطق
بالشهادتين يعمل في الدنيا معاملة المسلم، وإن ترك الصلاة متهاونًا لا جاحدًا، وهو
في الآخرة من الخاسرين (5): ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾: وحكم الصلاة
والزكاة واحد بنص القرآن.
(4): ﴿أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّ﴾: وبهذا يتبين لنا أنه لا إيمان بلا
عمل، وأن الأقوال بلا أعمال ليس من الإيمان الحق في شيء (كبر مقتًا عند الله أن
تقولوا ما لا تفعلون – 3 الصف) ﴿لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ﴾: تبعًا لما
يقدمون به من خدمات لأخيهم الإنسان، وما أكثر أحاديث هذا الباب: (خير الناس أنفعهم
للناس... أفضل الجهاد أن لا تهم بظلم.. أفضل العبادة كف الأذى... الدين النصيحة
والمعاملة) حتى الملحد إذا ثار على الظلم، وعمل لسعادة المنكوبين والبائسين، فإنه
يلتقي مع الإسلام أراد ذلك أم لم يرد.
(5): ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ..﴾: المراد بهذا البيت
المدينة المنورة، وبالحق: الصواب الذي لا محيد عنه، ويشير سبحانه بهذا إلى غزوة
بدر، وخلاصتها: إن المهاجرين تركوا أموالهم في مكة، وذهبوا مع النبي (ص) إلى
المدينة، فاغتصبها أبو سفيان وغيره من جبابرة الشرك، وحملها أبو سفيان إلى الشام
للتجارة، وعاد إلى مكة بالعير مُثقلة بكل نفيس وثمين، فحث النبي (ص) الصحابة أن
يقطعوا الطريق، ويستولوا على العير، فخرج 313 رجلاً، ولما علمت قريش بذلك خرجت
بقيادة أبي جهل للذب عن العير، ولكن أبا سفيان سلك طريقًا آخر ونجت العير، وأُشير
على أبي جهل بالرجوع فأبى. وكان قد وعد سبحانه نبيه الأكرم بإحدى الطائفتين: عير
أبي سفيان أو نفير أبي جهل، فاستشار الصحابة أيمضون لقتال النفير أو يعودون إلى
المدينة؟ فقال بعضهم: ما لنا وللقتال؟ إنما خرجنا للعير لا للنفير. فقال النبي (ص):
مضت العير على ساحل البحر. فقال سعد ابن عبادة أمض لما شئت، فإنا متبعوك. وقال سعد
بن معاذ لو خضت هذا البحر لخضناه معك. وقال المقداد: لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا
لفعلنا... ولا نقول لك ما قال بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون
ولكنا نقول: أمض لما أمرك ربك، فإنا معك مقاتلون. ففرح رسول الله (ص) وقال: سيروا
على بركة الله.
(6): ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ﴾: وهو قتال النفير بقيادة أبي جهل ﴿بَعْدَمَا
تَبَيَّنَ﴾: بعد ما أخبرهم النبي (ص) بالنصر ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى
الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾: أسبابه عيانًا، وهل ينجو من الموت من خافه، ويُعطي
البقاء من أحبه.
(7) – (8): ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ﴾: العير أو النفير
﴿نَّهَا لَكُمْ﴾: المصدر المنسبك بدل من إحدى الطائفتين ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ
غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ﴾: أي غير ذات القوة وهي العير ﴿تَكُونُ لَكُمْ﴾: من غير
قتال﴿وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾: أن ينصر الإسلام
والمسلمين على الشرك والمشركين بآياته المنزلة في محاربتهم ﴿وَيَقْطَعَ دَابِرَ
الْكَافِرِينَ﴾: قتلاً واسراً.
(9): ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾: إشارة إلى دعاء النبي (ص) يوم بدر: (اللهم
انجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض) ﴿فَاسْتَجَابَ
لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾: أي يتبع
بعضهم بعضًا، وتقدم في الآية 124 من آل عمران.
(10): ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ﴾: أي جعل سبحانه وعده بمحاربة الملائكة معكم ﴿إِلاَّ
بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾: وأنتم تقاتلون العدو في جلد وصبر، لا
لتتكلوا على الملائكة ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ﴾: أبدًا ما من شيء
يحدث إلا ولله فيه تدبير حتى ولو توافرت جميع أسبابه الطبيعية، لأنه الأصل الأول
لكل شيء.
(11): ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ﴾: كان المشركون حوالي ألف
مقاتل، والمسلمون دون الثلث من هذا العدد، فخاف هؤلاء من كثرة أولئك، فعالج سبحانه
خوفهم بالنوم، وما استيقظوا إلا وأنفسهم تغمرها السكينة،والطب الحديث يعالج بعض
الأمراض بالنوم، وبخاصة حالة القلق والإنهيار العصبي ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن
السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾: سبق
المشركون المسلمون إلى الماء في بدر، فوسوس لهم الشيطان بأنهم سيموتون عطشًا لا
محالة، فأنزل سبحانه المطر حتى جرى الوادي، فشربواوتوضئوا واغتسلوا وزالت وسوسة
الشيطان ﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾: بالاطمئنان وعدم الخوف ﴿وَيُثَبِّتَ
بِهِ الأَقْدَامَ﴾: في ميدان القتال.
(12): ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ ...﴾: أمر سبحانه الملائكة أن
يشجعوا المسلمين على الثبات في جهاد المشركين، وفعل الملائكة ذلك بطريق أو بآخر،
وثبت المسلمون وانتصروا، هذا الذي دل عليه ظاهر القرآن، أما الحديث عن نوع التشجيع
والتثبيت من الملائكة فهو رجم بالغيب ﴿فَاضْرِبُو﴾: أيها المسلمون ﴿فَوْقَ
الأَعْنَاقِ﴾: اقطعوا رؤوس الطغاة ﴿وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾: تحمل
سلاح العدوان.
(13): ﴿ذَلِكَ﴾: إشارة إلى السبب الموجب لقتال المشركين الطغاة وقتلهم وهو
﴿بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ﴾: خالفوهما بالتمرد والعدوان على النبي
(ص) والصحابة، وأخرجوهم من ديارهم، ثم أعلنوا عليهم الحرب وهم في دار هجرتهم.
(14): ﴿ذَلِكُمْ﴾: العقاب ﴿فَذُوقُوهُ﴾: أيها المجرمون جزاء بما كنتم تظلمون.
(15): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ
زَحْف﴾: إذا زحف الأعداء لقتالكم ﴿فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ﴾: اثبتوا لهم
ولا تفروا.
(16): ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ
مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ﴾: أبدًا لا عذر عند
الله سبحانه لمن يترك مقامه في القتال إلا لواحد من اثنين: الأول أن يخدع العدو،
ويريه أنه منهزم منه حتى إذا تبعه انعطف عليه: الثاني أن ينحاز إلى جماعة من
المقاتلين المسلمين لأنهم بحاجة إلى نصرته.
(17): ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾: بحولكم وقوتكم ﴿وَلَـكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ﴾: بما
أمدكم به من الملائكة وإزالة الرعب من قلوبكم وإلقائه في قلوب المشركين، وفي الآية
14 من التوبة (يعذبهم الله بأيديكم) ﴿وَمَا رَمَيْتَ﴾: يا محمد﴿إِذْ رَمَيْتَ
وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى﴾: أجل، ولكنه اختار سبحانه لرميته كف محمد الذي فضله على
جميع خلقه. وكان النبي (ص) قد أخذ يوم بدر قبضة من حصى وتراب، ورمى بها وجوه
الأعداء وقال: شاهت الوجوه، فانهزمو﴿وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء
حَسَن﴾: المراد بالبلاء هنا العطاء، والمعنى أن الله سبحانه نصر المؤمنين يوم بدر
تفضلاً منه وكرمًا.
(18): ﴿ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾: الله سبحانه يبطل
كيد المجرمين والمبطلين، ما في ذلك ريب، وأيضًا لا شك ولا ريب أن الله سبحانه يجري
الأمور على أسبابها، والسبب الموجب لانتصار المحق على المبطل أن يعد له العدة وإلا
أخذ الباطل مآخذه، وساد الجور والفساد.
(19): ﴿إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ﴾: الخطاب لمشركي مكة الذين
حاربوا رسول الله (ص) في بدر، ومعنى أن تستفتحوا إلى أن تطلبوا الفتح، والمراد به
النصر. ورب قائل: إن المشركين في وقعة بدر قد جاءهم الكسر والقتل والاسر. فكيف قال
لهم سبحانه: قد جاءكم النصر؟ الجواب: إن المشركين كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحب
الطائفتين إليه، فقال لهم، تقدست كلماته: سمعت منكم الدعاء، ونصرت أحب الطائفتين
إلي، ولكن أخطأتم في التطبيق ﴿وَإِن تَنتَهُو﴾: أيها المشركون عن حرب المسلمين
﴿خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُو﴾: إلى حربهم ﴿نَعُدْ﴾: إلى نصرتهم ﴿وَلَن
تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ﴾: لا غنى لكم في كثرة الرجال
ما دمتم على الشرك والضلال ﴿وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: العاملين بطاعته
المجاهدين في سبيله.
(20): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ
تَوَلَّوْا عَنْهُ﴾: لا تعرضوا عن رسول الله ﴿وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ﴾: كتاب الله.
(21): ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ﴾:
وما أكثر الذين يؤمنون بالله نظريًا، ويتخذون الشيطان وليًا.
(22): ﴿نَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ
يَعْقِلُونَ﴾: الغرض من السمع الفهم والعمل بما يسمع الإنسان من نصح ورشاد، ومن
النطق الإقرار بالحق، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فلا سمع ونطق، بل ولا عقل.
(23): ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ﴾: أي في الصم البكم الذين ذكرهم قبل لحظة
﴿خَيْرً﴾: أي ينشدون الخير لوجه الخير ﴿لَّأسْمَعَهُمْ﴾: بتمهيد السبيل إلى فعل
الخير، ولكنهم لا يرون أي شيء، ولا يؤمنون بشيء إلا بمنافعهم الذاتية الشخصية، فهي
وحدها الخير كل الخير، وما عداها كلام فارغ ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ
وَّهُم مُّعْرِضُونَ﴾: حتى ولو قدم لهم الخير والحق على طبق من بلور لحطموه إلا أن
يتفق مع أهوائهم وأغراضهم، وأكثر الناس ينقادون من بطونهم لا من عقولهم بشهادة
القرآن الكريم: (بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون – 70 المؤمنون).
(24): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا
دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾: لقد حددت هذه الآية الإسلام بالدعوة إلى العمل من أجل
حياة أكمل، أي الدعوة إلى العلم النافع، إلى الحقل والمصنع الذي ينتج الغذاء
والدواء والكساء، وإلى المدرسة والميتم والمستشفى، وإلى المساواة والعدالة
الإجتماعية، وإلى الأخوة والتعاون في هذا الميدان، وإلى التحرر من كل من قد يقف في
سبيل هذه الحياة... هذا هو الجوهر والأساس لمنهج الإسلام وفلسفته في عقيدته وشريعته
وآدابه وأخلاقه وجميع أحكامه. وأخيرًا فكل من يعمل لخير الحياة فإنه يلتقي مع دين
الإسلام على صعيد واحد كائنًا من كان ويكون ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾: يملك عليه قلبه، فيغير نياته، ويفسخ عزائمه، ويبدله
بالذكر نسيانًا، وبالنسيان ذكرًا، وبالخوف أمنًا، وبالخوف أمنًا، وقدمنا مرات ونكرر
أنه لا مسببات بلا أسباب ولا نتائج بلا مقدمات طبيعية وعقلية، وأن كل الأسباب
والمقدمات تنتهي إليه تعالى، ومن هنا صحت النسبة.
(25): ﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ
خَآصَّةً﴾: إذا وقعت الواقعة أخذت مجراها، وأثرت أثرها طبيعية كانت أو اجتماعية،
ولا تدخل في حسابها الأتقياء والأبرياء، فأضرار الحرب – مثلاً – لا تبالي بأنصار
الإسلام والأرامل والأيتام. وأيضًا إذا هبت الريح جنوبًا، وأبحر الولي التقي باتجاه
الشمال، فإن الله سبحانه لا يأمر الريح بالهبوب شمالاً إكرامًا لوليه وصفيه.
(26): ﴿وَاذْكُرُو﴾: يا معشر الصحابة ﴿إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ...﴾: كان العرب قبل
محمد (ص) أُمة أُمية، وبه أصبحوا ما هو معلوم لدى الجميع حتى صار الكلام عنه تمامًا
كالحديث عن فائدة العلم والنور والهواء.
(27): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو﴾: أي يا أيها المنتمون إلى الإسلام ﴿لاَ
تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ﴾: بالخلافات والمشاحنات، والانقياد للأدعياء الطغاة
﴿وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: أي تخونوا مصلحتكم بالصبر
والسكوت عن الذين يفسدون في الأرض، وأنتم على علم اليقين بحقيقتهم، ويروى أن ابن
عباس حين سمع قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار – 13 هود) قال:
إذا كان هذا حال من لا يصدر عنه إلا مجرد ركون، ولم يشترك في قول أو فعل، فالويل كل
الويل لمن أطرى وشارك.
(28): ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾: تقودكم إلى
الإثم والحرام، فكم من رجل آثر زوجته وذويه وأولاده على السائل والمحروم، ومنعهما
من الحق المنصوص عليه بالقرآن، وأسوأ حالاً من هذا من يقبض من أموال الأغنياء أسهم
الفقراء وحقوقهم ليوصلها إليهم كأمين، فيستأثر بها هو وذووه كأنها ميراث من أبيه أو
من كد يمينه! ﴿وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾: إن ثواب الله خير وأفضل من
الأموال والأولاد، ولكن عند المتقين باطنًا وواقعًا لا شكلاً وظاهرًا.
(29): ﴿يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ
فُرْقَان﴾: إذا تحررتم من عاطفة حب المال والأولاد وطغيانها على دينكم وعقولكم
يجعل في قلوبكم هدى ونور تفرقون به بين الحق والباطل والخطأ والصواب.
(30): ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ﴾: يا محمد ﴿الَّذِينَ كَفَرُو﴾: وهم الجبابرة الطغاة
من قريش ﴿لِيُثْبِتُوكَ﴾: ليقيدوك وليوثقوك ﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾:
يشير سبحانه بهذا إلى قصة تآمر قريش على رسول الله (ص) ومبيت عليّ في فراشه،
وخلاصتها أن قريش أجمعت على الخلاص من النبي، فأشار بعضهم أن يوثق ويقيد فتفشل
حركته ودعوته، وقال آخر: انفوه من مكة، ثم اتفقوا جميعًا أن يختاروا من كل قبيلة
رجلاً، ويغتالوه بضربة واحدة مجتمعين وهو نائم في فراشه، فيتفرق دمه في القبائل،
ولا يقوى بنو هاشم على حرب الجميع، فأوحى الله إلى رسوله بقصتهم، وأمره أن يبيت علي
في فراشه بعد أن يتشح ببرده، ولما بادر القوم إلى مضجع الرسول (ص) أبصروا عليًا،
فبهتوا وأُبطل كيدهم ومكرهم، وإلى هذا أشار سبحانه بقوله: ﴿وَيَمْكُرُونَ﴾: أي
يدبرون قتل محمد بوسيلة لا يؤاخذون معها بدمه ﴿وَيَمْكُرُ اللّهُ﴾: أي يُبطل سبحانه
مكرهم وكيدهم بما دبر من مبيت علي وهجرة النبي ﴿وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾: أي
أن تدبيره تعالى فوق كل تدبير وتقدير، وتقدم مثله في الآية 54 من آل عمران.
(31): ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَ﴾: القرآن ﴿قَالُو﴾: بعض مشركي قريش:
﴿قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَـذَ﴾: ولماذا سكتوا؟ وقد تحداهم
أن يقلدوا سورة واحدة، وقرعهم بالعجز والقصور، وهم الحريصون على تكذيبه... ولا شيء
أيسر على اللسان... لقد أنكر السفسطائيون وجود كل شيء حتى وجودهم!.
(32): ﴿وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء ...﴾: هم يعلون علم اليقين أن محمد
نبي حقًا وصدقًا، ولكنهم يفضلون الهلاك والخلود في العذاب الأليم على الخضوع له
والاعتراف بفضله، وهكذا يفعل الحقد والحسد إذا تأججت ناره في الصدور، وإني لأعرف
معرفة شخصية في هذا الوصف أكثر من واحد.
(33): ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ﴾: لا يعذب الله أهل
مكة، وإن كانوا أهلاً له ما دام محمد (ص) بين أظهرهم: وفيه إيماء إلى أنه تعالى
يعذبهم إذا هاجر عنهم النبي كم تأتي الإشارة ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾:وأيضًا لا يعذبهم الله سبحانه ما دام في بلدهم قوم من
المسلمين المستضعفين، وهم الذين بقوا في مكة بعد خروج رسول الله منها لعجزهم عن
الهجرة.
(34): ﴿وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ﴾: أي لم لا يعذب مشركي مكة بعد
خروج النبي منها والبقية الباقية من المسلمين! وقد عذبهم يوم بدر، وأذلهم يوم فتح
مكة ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: أي شيء يمنع من عذابهم، وقد
منعوا المؤمنين من التعبد لله في الكعبة المقدسة ﴿وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ﴾:
ليس المشركون أصحاب المسجد الحرام، ولا هم أولياء عليه، بل هم أعداء الله ورسوله
﴿إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ﴾: وفي هذا المعنى قول الإمام علي (ع):
(إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته (أي نسبه) وإن عدو محمد من عصى الله وإن
قربت قرابته).
(35): ﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ﴾: أي صلاة المشركين ﴿عِندَ الْبَيْتِ﴾: الحرام
﴿إِلاَّ مُكَاء﴾: صفيرًا بالفم﴿وَتَصْدِيَةً﴾: تصفيقًا باليد.
(36): ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾: يبذلونها بسخاء وعن
طيب نفس، لا لشيء إلا ﴿لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ﴾: والآن تبذل الملايين على
الإعلام الملغوم، والتوجيه المسموم، وتشويه الحقائق لتضليل الآراء والمعتقدات
﴿فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ....﴾: يضحون بكل غال ونفيس
ليقضوا على الإسلام، ويأبى الله سبحانه إلا أن ينصر الإسلام ونبي الإسلام، ويظهره
على الدين كله.
(37): ﴿لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾: لا يستقيم في عدله أن يستوي
المجرم والبريء: (أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون – 18 السجدة) بل يثيب
المؤمن ويعاقب الفاسق ﴿وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ
جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ﴾: يجمع سبحانه غدًا المجرمين بعضهم فوق بعض
متراكمين متراكمين، ثم يلقي بهم في نار جهنم تمامًا كحزمة من حطب تطرح في الأتون
دفعة واحدة.
(38): ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُو﴾: أن يتوبوا ﴿يُغَفَرْ لَهُم مَّا
قَدْ سَلَفَ﴾: وفي نهج البلاغة: ما كان الله ليفتح على عبد باب التوبة ويغلق عنه
باب المغفرة ﴿وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ﴾: أي مضت سنة
الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً، وهي عقوبة الكافرين في
الدنيا قبل الآخرة، ونصر المرسلين إليهم.
(39): ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ...﴾: تقدم في الآية 193 من
البقرة.
(40): ﴿وَإِن تَوَلَّوْ﴾: أصروا على الكفر والجحود بنبوة محمد (ص) ﴿فَاعْلَمُواْ
أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ﴾: يحميكم ويرعاكم ﴿نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
النَّصِيرُ﴾: بل لا نصر إطلاقًا إلا من عند الله بشرط واحد فقط، وهو أن نطيعه في
قوله: (ولا تنازعوا فتفشلوا – 46 الأنفال... وأعدوا لهم ما استطعتم – 60 نفس
السورة).
(41): ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ﴾: هذا اللفظ يشمل ويعم كل
غنيمة دون استثناء، لأن (ما) اسم موصول وهي تدل على العموم هنا، و (من شيء) بيان
لما تدل عليه (ما) أي من كل شيء. وعمل الشيعة بهذا العموم وأوجبوا الخمس في كل
فائدة على البيان والتفصيل المذكور في كتبهم الفقهية، وقال السنة: لا ريب في أن
دلالة الآية عامة لكل فائدة، ولكن ثبت عندنا تخصيصها بما أخذ من الكفار على وجه
القتال والغلبة، ولو ثبت هذا التخصيص عند الشيعة لعملوا بقول السنة، وأيضًا لو لم
يثبت عند السنة لعملوا بقول الشيعة ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾: هذا بيان للذين
يستحقون الخمس، وقال الشيعة: حيث لا نبي بعد محمد (ص) ولا إمام ظاهر يقسم الخمس
نصفين: ينفق الأول في تأييد الدين، وترويج الشريعة، وكل ما نعلم علم اليقين بأنه
يرضي الله ورسوله. والنصف الثاني ينفق على اليتامى والمساكين وابن السبيل من بني
هاشم بالخصوص عند أكثر علماء الشيعة، وقال بعضهم: بل لكل مسلم من الأصناف هاشميًا
كان أو غير هاشمي، ولا يتسع المجال لأكثر من هذا البيان. ﴿إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ
بِاللّهِ﴾: حقًا وصدقًا فعليكم أن توجبوا الخمس في كل غنيمة وفائدة بلا استثناء،
وأن تنفقوها على الذين نصت عليهم هذه الآية ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَ﴾:
محمد وهو القرآن، وأيضًا أنزل عليه النصر ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾: وهو يوم بدر حيث
فيه فرق سبحانه بين الكفر والإيمان بإعلاء كلمة الإسلام على الشرك ﴿يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعَانِ﴾: جمع المؤمنين وجمع المشركين.
(42): ﴿إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَ﴾: أي جانب الوادي، والدنيا مؤنث
الأدنى ﴿وَهُم﴾: المشركون المحاربون بقيادة أبي جهل المعبر عنهم بالنفير
﴿بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى﴾: أي بالجانب الأبعد من الوادي ﴿وَالرَّكْبُ﴾: أي العير
التي مع أبي سفيان ﴿أَسْفَلَ مِنكُمْ﴾: حيث سلك أبو سفيان ساحل البحر خوفًا من
النبي (ص) ﴿وَلَوْ تَوَاعَدتَّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ﴾: لو خرجتم أنتم
أيها المسلمون منذ البداية إلى قتال المشركين متواعدين معهم على ذلك في أمد معين،
ثم علمتم بأنهم أكثر منكم لأخلفتم الميعاد، ولم تذهبوا إلى القتال خوفًا منهم
﴿وَلَـكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُول﴾: ولكن دبر هذا اللقاء
للقتال على غير ميعاد حيث خرجتم للعير لا للنفير، فحوله سبحانه عن العير إلى
النفير، ليقع ما أراد من إعزاز الدين وإذلال المشركين ﴿لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن
بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ﴾: المراد بمن هلك، من كفر، وبمن حي،
من آمن، والمعنى أن الله نصر أولياءه ليكون ذلك حجة قاطعة على أهل الكفر، وقهر
أعداءه ليكون ذلك حجة ظاهرة لأهل الإيمان.
(43): ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّهُ﴾: أي يريك المشركين المحاربين ﴿فِي مَنَامِكَ﴾: في
عينك لأنها مكان النوم كما في بعض التفاسير﴿ قَلِيل﴾: كي تجسروا على قتالهم
﴿وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ﴾: لهبتم وجبنتم عن
قتالهم﴿وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ﴾: في الرأي، وتفرقت كلمتكم ﴿وَلَـكِنَّ
اللّهَ سَلَّمَ﴾: أنعم عليكم بالسلامة من الفشل وتفتيت الصفوف.
(44): ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيل﴾: ليشد
من عزمكم أيها المسلمون على قتال المشركين﴿وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ﴾: كي
لا يبالغوا في الاستعداد لقتالكم وإن سأل سائل عن هذا التكرار أجبناه بأنه نوع من
أساليب الدعاية. قال غوستاف لوبون في كتاب الآراء والمعتقدات: (إن التوكيد والتكرار
عاملان قويان في تكوين الآراء وانتشارها).
(45): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً﴾: باغية تسعى في
الأرض فسادًا ﴿فَاثْبُتُو﴾: في جهادهم وقتالهم﴿وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرً﴾: أي
يجب أن يكون الجهاد خالصًا لوجه الله لا للغنيمة أو السمعة ونحوها ﴿لَّعَلَّكُمْ
تُفْلَحُونَ﴾: فيه إيماء إلى أن النصر والظفر في القتال والجهاد لا يتحقق إلا مع
شرف الغاية ونزاهة القصد.
(46): ﴿وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾: أي قوتكم وهيبتكم... إن جراحنا نحن المسلمين لا تلتئم،
وأدواءنا لا تنحسم إلا نكون كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضًا، وهل من مسلم يجهل
بأن هذا الخصام والإنقسام بين قادة المسلمين هو أشد فتكًا بالإسلام والمنتمين إليه،
من أي سلاح حديث؟ ونحن الذين صنعوا هذا السلاح القاتل، وقدمناه لعدونا وعدو ديننا
بلا مقابل إلا الخزي والهوان... لقد ابتدأ الإسلام من جمع الشمل، وانطلق نبي
الإسلام من المؤاخاة بين أصحابه وأتباعه، ومن هنا يجب أن نبدأ وننطلق وإلا فلا وزن
للمسلمين وإن كانوا مئات الملايين وأغنى أغنياء الأولين والآخرين.
(47): ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرً﴾: يشير
سبحانه بهذا إلى النفير بقيادة أبي جهل، خرجوا من مكة ليحموا العير، فقيل لهم:
ارجعوا لقد سلمت العير، فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نقدم بدرًا، ونشرب فيها الخمور
وتعزف علينا القيان، وهذا بطرهم وغرورهم، الذي أشارت إليه الآية بكلمة (بطرًا) أما
قوله تعالى:﴿وَرِئَاء النَّاسِ﴾ فهو إشارة إلى قول أبي جهل: نريد أن يسمع الناس
بشجاعتنا وعظمتنا.
(48): ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾: في عداوة رسول الله
وحربه ﴿وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ﴾: فاقدموا على حرب محمد
والصحابة ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ﴾: مجير ونصير ﴿فَلَمَّا تَرَاءتِ﴾: تلاقت
﴿الْفِئَتَانِ﴾: المسلمون والمشركون ﴿نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾: رجع إلى الوراء
﴿وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ﴾: أشعل النار ونجا بنفسه، أما الذين غرهم واغتروا
به فإلى داهية ﴿إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ﴾: من أن الله منجز وعده وناصر جند
المسلمين لا محالة، ونسي ما قاله للمشركين قبل ساعة: (لا غالب لكم) ولكن المنافق
يحيك الكلام بما يأتي على لسانه، له كان أو عليه.
(49): ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾: وهم
الذين حسدوا محمدًا على ما آتاه الله من فضل النبوة: ﴿غَرَّ هَـؤُلاء﴾: المسلمين
﴿دِينُهُمْ﴾: حيث تصدوا لقتال قوم أكثر منهم عددًا وأقوى عدة ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾: ليس النصر بالكثرة، ولا الخذلان
بالقلة، وإنما النصر بالإخلاص والصبر على الجهاد والتضحية والتوكل على الله.
(50) – (51): ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ
...﴾: يبدأ عذاب المجرمين منذ الساعة الأخيرة من حياتهم وهم على فراش الاحتضار،
ويمضي معهم إلى القبر والنشر والحشر...إلى ما شاء الله، والمراد بضرب الوجوه
والأقفية أن العذاب محيط بهم من كل ناحية.
(52): ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ...﴾: أخذ سبحانه المشركين يوم بدر بالعذاب كما أخذ
آل فرعون وغيرهم، لأن الأشياء المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة، وتقدم في الآية 11
من آل عمران.
(53): ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى
قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾: ليس المراد بالنعمة هنا الرزق فإن
محمداً كان أخمص الناس بطنًا، وقال كليم الله: ( رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
– 24 القصص) وإنما المراد بها الشأن والكرامة – مثلاً – كان للعرب هيبة وسلطان حين
اتحدوا وجاهدوا ولما تخاذلوا وتكاسلوا سقوا كأس المذلة والهوان بأيدي الأسافل
والأراذل... أبدًا لكل حادثة سبب، وما ربك بظلام للعبيد.
(54): ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ...﴾: أعاد سبحانه لمجرد الإشارة إلى أنه قد كان
لهم سلطان غالب فمحقوا بعد أن غيروا وبدلوا.
(55) – (56): ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ...﴾: قال المفسرون: المراد بهم اليهود،
لأنهم عاهدوا النبي (ص) أكثر من مرة، ونقضوا عهدهم في كل مرة.
(57): ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ﴾: تصادفنهم ﴿فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم﴾: خذهم
بالشدة والقسوة والاحتقار والجفوة ﴿مَّنْ خَلْفَهُمْ﴾: ليس المراد إضرب اليهود من
الخلف، بل المراد أن وراء اليهود قومًا مشركين يشدون أزرهم، فإذا ضربت اليهود ضربة
قاسية اتعظ واعتبر الذين يؤازرونهم.
(58): ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً﴾: إذا كان بينك يا محمد وبين قوم
عهد، وأيقنت أنهم يتخذون من هذا العهد ستارًا يدبرون من وراءه الغدر والاغتيال
﴿فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء﴾: عاملهم بالمثل في رد العهد حتى يكون تصرفك
معهم بمنزلة سواء: قال الإمام علي (ع): الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر
بأهل الغدر وفاء عند الله.
(59): ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُو﴾: فاتوا ونجوا من العقاب
﴿إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ﴾: لا يعجزه من طلب ولا يفوته من هرب.
(60): ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ
الْخَيْلِ﴾: والمراد بهذا الرباط وتلك القوة كل ما يتم به النصر على الأعداء وأثبت
العصر الراهن أنه لا حول ولا قوة لأي مجاهد في ميدان القتال أو الإعلام إلا بالعلم،
بل لا حياة إلا به، وإنه لا وسيلة للجهل إلا الاستسلام للعلم ... أجل، إن العلم
المعملي وحده لا يقود البشرية إلى السعادة والهداية إلا مع الدين والتقوى، ولكنه
يصون من الصغار والهزيمة – على الأقل – وقد بين سبحانه في الكثير من آياته كيف أخذ
المجرمين والطغاة بالبركان وال
2015-12-10