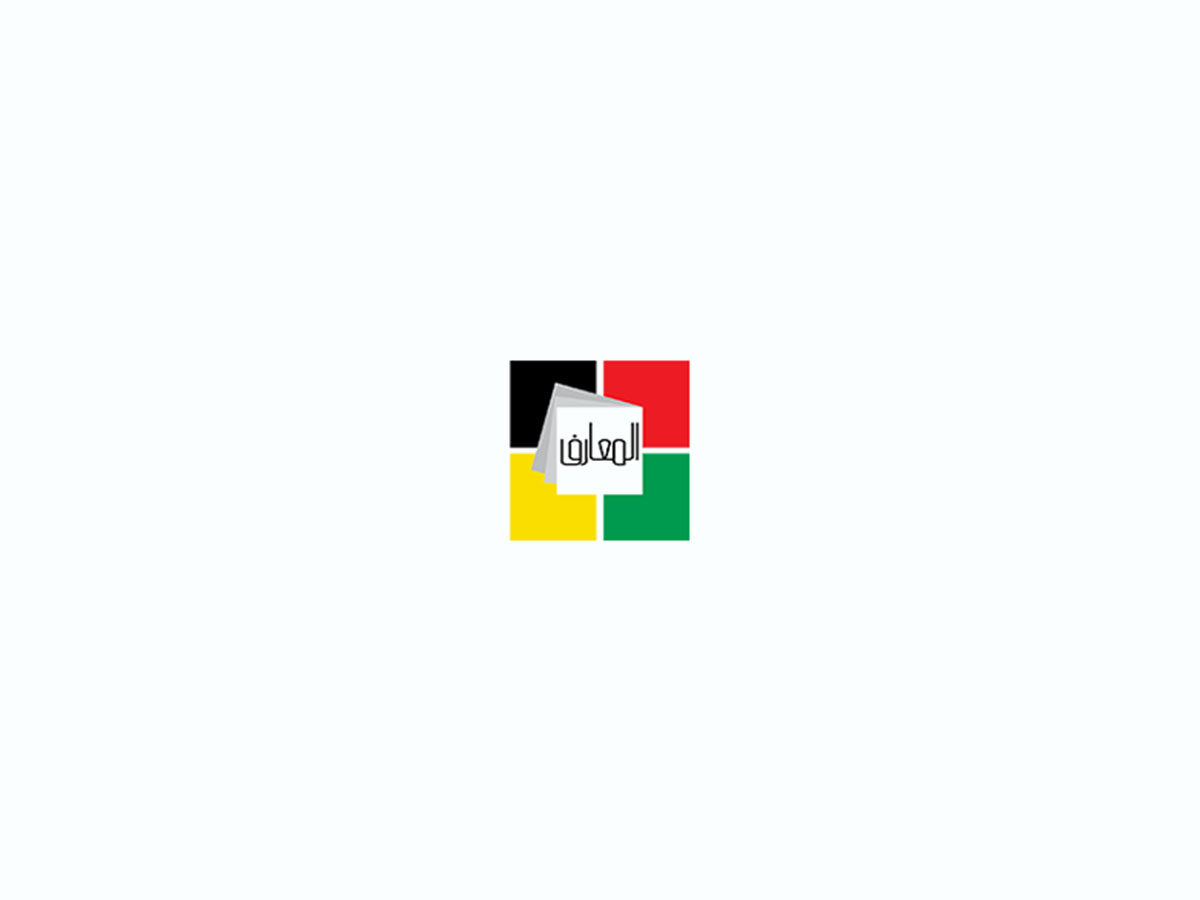(1): ﴿بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ
الْمُشْرِكِينَ﴾: فتح النبي (ص) مكة في العام الثامن للهجرة، وفي العام التاسع نزلت
هذه السورة، تعلن البراءة من المشركين وتنذر بالحرب كل مشرك يقيم في الجزيرة
العربية، وقال المفسرون: رسول الله دفعها إلى أبي بكر ليقرأها على المشركين، ثم
أخذه منه بأمر الله وأعطاها لعلي بن أبي طالب.
(2): ﴿فَسِيحُو﴾: أيها المشركون ﴿فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾: بعد إعلان
الحرب على المشركين أمهلهم سبحانه 4 أشهر ينتقلون فيها آمنين حيث يشاءون، فإن
أسلموا وإلا فجزاؤهم القتل، وهذا الحكم لا يُقاس عليه، لأنه استثنائي خاص لسبب خاص
﴿وَاعْلَمُو﴾: أيها المشركون ﴿أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ﴾: لا نجاة لكم
منهم.
(3): ﴿وَأَذَانٌ﴾: إعلام ﴿مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ﴾: بالبراءة من
المشركين ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ﴾: وهو يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وكان
ابتداء الأشهر الأربعة بهذا اليوم من العام التاسع الهجري، وانتهاؤها في اليوم
العاشر من ربيع الآخر من سنة عشر، وبعد هذه المدة يكون مصير المشركين في الجزيرة
العربية الإسلام أو القتل ﴿فَإِن تُبْتُمْ﴾: أسلمتم أيها المشركون ﴿فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ﴾: حيث يكون لكم ما للمسلمين، وعليكم ما عليهم.
(4): ﴿إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ...﴾: استثنى سبحانه من قتل
المشركين بعد الأشهر الأربعة قومًا كان بينهم وبين المسلمين عهد المهادنة والمسالمة،
وحافظوا على هذا العهد، ولم يغدروا ويخونوا ولا تعاونوا مع أعداء المسلمين عليهم.
استثنى سبحانه هؤلاء، وأمهلهم إلى مدتهم جزاء على وفائهم. ومضت مع الزمن هذه
الأحكام الخاصة بأهل الشرك والجاهلية وأصبحت من أخبار كان الناقصة، ولا جدوى عامة
من إطالة الكلام فيها.
(5): ﴿فَإِذَا انسَلَخَ﴾: انقضى ﴿الأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾: والأشهر الحرم التي يحرم
القتال فيها إطلاقًا وعمومًا هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وليست هذه
بمرادة هنا، بل المراد في هذه الآية الأشهر التي حرم الله فيها قتال المشركين الذين
تكلمنا عنهم في الأسطر السابقة، وتبدأ من 10 ذي الحجة سنة 9هـ إلى ربيع الآخر سنة
10هـ ، وقيل: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وقيل غير ذلك ﴿فَاقْتُلُواْ
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾: قسرًا ﴿وَخُذُوهُمْ﴾: أسرًا ﴿وَاحْصُرُوهُمْ﴾:
حبسًا ﴿وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾: راقبوهم في كل طريق يمرون به، ولا
تدعوا أحدًا يفلت منهم ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ ...﴾: إن أظهروا
الإسلام قبل الأجل المضروب، وأقاموا الشعائر الإسلامية، وأهمها الصلاة وإيتاء
الزكاة – فلا تتعرضوا لهم بسوء.
(6): ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ...﴾: إذا طلب المشرك الذي
يحمل قتله أمانًا من أي مسلم فعليه أن يجيره ويعطيه الأمان على نفسه وماله، ويدعوه
إلى الإسلام بالحكمة وسبل الإقناع، فإن أسلم فذاك وإلا فعلى المسلم أن يوصله إلى
مكان يأمن فيه على نفسه، وكان هذا يوم كان الإسلام قويًا بأهله، أما اليوم فأهله
يستجيرون بأعدائه!.
(7): ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ﴾:
الله والرسول لا يفيان بعهد الكاذب الجحود، والخائن العنود ﴿إِلاَّ الَّذِينَ
عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: يشير سبحانه بهذا الاستثناء إلى أن
النبي كان قد عاهد قبيلة من العرب تُدعى كنانة، فعلى المسلمين أن يفوا لها بالعهد
حتى ولو أصروا على الشرك إلا أن ينكثوا العهد، فعندئذ يسوغ قتلهم، وإلى هذا أشار
سبحانه بقوله: ﴿فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ﴾: وإلا فالوفاء
لأهل الغدر غدر.
(8): ﴿كَيْفَ﴾: يجب عليكم الوفاء بعهد الناكثين العهد ﴿وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً﴾: إن يظفروا بكم لا يراعوا فيكم
قرابةً ولا عهدًا ﴿يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ﴾: إلا الحسد
واللؤم والحقد، ولا يختص هذا الوصف بالمشرك أو الملحد، فكم من ملحد هو أزكى نفسًا
وأوفى عهدًا من الأدعياء وحسده الرخاء.
(9): ﴿اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيل﴾: باعوا دينهم إلى الشيطان
بأخس الأثمان.
(10): ﴿لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً﴾: هم أعداء ألداء لكل
طيب ومخلص لا للنبي والصحابة فقط، وهذا هو الفرق بين الآية وآية (لا يرقبوا فيكم
إلاً ولا ذمة) تمامًا كما تقول لصاحبك: فلان لا يحبك، بل لا يحب الخير على الإطلاق.
(11): ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ﴾: والفرق بين
هذه والسابقة هو في جواب الشرط حيث جاء الجواب هناك (فخلوا سبيلهم) أما الجواب هنا
﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾: يجري عليهم ما يجري عليهم.
(12): ﴿وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم﴾: مواثيقهم معك ﴿مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾:
الذي أبرموه معكم ﴿وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾:
لا يعارض الإسلام أي إنسان في دينه أو يضطهده من أجله، بل يبين له طريق الرشد
والغي، ويدع الآخرين، قال سبحانه لنجيه ونبيه: (ما عليك من حسابهم له الخيار في أن
يعبر عما يشاء، شريطة أن لا يطعن في عقيدة من شيء وما من حسابك عليهم من شيء – 52
الأنعام) وقال الرسول (ص) للكافرين: (لكم دينكم ولي دين – الكافرون).
(13): ﴿أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ﴾: عاهد الجبابرة
الطغاة من قريش رسول الله (ص) على ترك القتال عشر سنين يأمن فيها الفريقان على
أنفسهم وأموالهم، وكان ذلك سنة ست للهجرة، لكنهم خالفوا ونكثو﴿وَهَمُّواْ
بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ﴾: أرادوا ذلك ونفذوه ﴿وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾:
بأنواع التنكيل والإيذاء حين أعلن الرسول دعوة الإسلام ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ
أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ﴾: ومعنى هذا أن الذي يؤثر الخوف من
الناس على الخوف منه تعالى فهو تمامًا كالذي تطيع المخلوق في معصية الخالق، وقد
فلسف الإمام علي (ع) خوف أكثر الناس من الله بكلمة واحدة، وهي (معلول) أي مريض حيث
قال: كل خوف محقق إلا خوف الله، فإنه معلول.
(14): ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾: قتلاً ﴿وَيُخْزِهِمْ﴾:
أسرًا ﴿وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ﴾: حقًا ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾:
وهم الذين استضعفهم جبابرة الشرك قبل الهجرة وأذاقوهم ألوانًا من التحقير والتنكيل.
(15): ﴿وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء﴾: يشير
إلى من أسلم بعد فتح مكة وأحسن، وكان قد طغى من قبل وبغى.
(16): ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُو﴾: دون حساب وجزاء ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ
اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ﴾: لنصرة الحق وإقامة العدل ﴿وَلَمْ
يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾:
أي بطانة، وأفضل الطاعات جهاد الفاسد المفسد، وأكبر المعاصي الركون إليه، وعل كل
مؤمن بالله حقًا أن يكشف هوية من يسعى في الأرض الفساد.
(17): ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله﴾: بزيارتها
والتعبد فيها للأصنام، كما كانوا يفعلون أيام الجاهلية.
(18): ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ...﴾: أبدًا لا يسوغ لأحد أن
يدخل المساجد، ويتعبد فيها، أو يتولى شيئًا من أمورها إلا من دان بدين الله الواحد
الأحد ملتزمًا بكتابه وسنة رسوله.
(19): ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ
يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ﴾: جاء في أكثر التفاسير، ومنها تفسير الطبري والرازي
والنيسابوري والسيوطي: (أن العباس بن عبد المطلب كان يسقي الناس في الحج، وإن طلحة
بن شيبة كان يحمل مفاتيح الكعبة، فقال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفاتيحه، وقال
العباس: أنا صاحب السقاية، فقال علي بن أبي طالب: لا أدري ما تقولان، لقد صليت إلى
القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله: (أجعلتم سقاية الحاج.).
(20): ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ ...﴾: تقدم في الآية 72 من
الأنفال.
(21) – (22): ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ﴾:
في تفسير البحر المحيط: (اتصف المؤمنون بصفات ثلاث: الإيمان والهجرة، والجهاد،
فقابلهم سبحانه بثلاث: الرحمة والرضوان والجنان) والأصل والأساس لكل منقبة وفضيلة
هو الإيمان القوي الذي لا تقف دونه الحواجز. وبدافع منه يستهين بالديار والمال
والعيال، وبالحياة أيضًا.
(23): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ
وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ﴾:
الوفاء للأهل والأصدقاء فضيلة ما في ذلك ريب. وبشرط أن لا يكون هذا الوفاء على حساب
الدين والإيمان وإلا تحول إلى رذيلة، قال الإمام(ع): (كنا مع رسول الله (ص)، وإن
القتل ليدور على الأبناء والآباء والإخوان والقرابات، فما تزداد كل مصيبة وشدة إلا
إيمانًا، ومضيًا على الحق، وتسليمًا للأمر، وصبرًا على مضض الجراح). ﴿وَمَن
يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ﴾: في معصية الله وحرامه ﴿فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾:
لأنفسهم. قال الإمام أمير المؤمنين(ع): (ولا عدو أعدى على المرء من نفسه، ولا عاجز
أعجز ممن أهمل نفسه فأهلكها).
(24): ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَ﴾: اكتسبتموها ﴿وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ
وَرَسُولِهِ﴾: أي من طاعة الله ورسوله، فتؤثرون العاجلة على الآجلة في جميع
تصرفاتكم ﴿وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ
بِأَمْرِهِ﴾: كل ما نزل في كتاب الله من آيات وثبت في سنة نبيه من روايات في ذم
الدنيا – فالمراد بها دنيا الشيطان ومعصية الرحمن، أما دنيا الله وطاعته فهي السبيل
الوحيد إلى رضوانه وجنته، قال رجل للإمام جعفر الصادق (ع) إني أحب الدنيا. فقال له
تصنع بها ماذا؟ قال أتزوج منها، وأحج وأُنفق على عيالي، وأُنيل إخواني وأتصدق. قال
الأمام: ليس هذا من الدنيا هذا من الآخرة، وعليه فمعنى الآية: للإنسان أن يحب المال
والأرحام والعيال وكل ما لذ وطاب، على أن لا يتجاوز الحلال والحرام، ولا يكون شيء
من ذلك على حساب الآخرين.
(25): ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾: في العديد من مواقف
الحرب، منها بدر وخيبر وفتح مكة ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾: وادٍ بين مكة والطائف ﴿إِذْ
أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾: كان المسلمون آنذاك 12 ألفًا، فقال بعضهم: لن نغلب
اليوم من قلة ﴿فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا
رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾: وهذه هي عاقبة الغرور، فمن الإعجاب
بالعدة والعدد إلى أبشع الهزائم، وثبت مع رسول الله علي بن أبي طالب حامل الراية
يقاتلهم بسيفه دفاعًا عن رسول الله، والعباس آخذ بلجام بغلته، والفضل بن العباس عن
يمين النبي والمغيرة بن الحارث بن عبد المطلب عن يساره في تسعة من بني هاشم أيمن بن
أم أيمن، وقصة حنين مذكورة في كتب التاريخ والسيرة.
(26): ﴿ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾:
تطلق كلمة السكينة على ثقة الإنسان واطمئنانه إلى رأيه وبرهانه وعقيدته وإيمانه،
ومن ذلك قوله تعالى: (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة
التقوى – 26 الفتح) وأيضًا تطلق على التفاؤل بالخير والاطمئنان إلى الربح والنصر
وهذا المعنى هو المراد هنا بقرينة السياق، ولا مانعة الجمع بين المعنيين، وعلى أية
حال فإن السكينة هي المصدر الأساس للصبر والصمود في كل جهاد ونضال أيًا كان نوعه.
﴿وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَ﴾: وليس من الضروري أن تكون هذه الجنود ملائكة
من السماء ما دامت لم تذكر وتطلق الآية بذلك، فإن كل شيء هو من جنوده تعالى حتى
الرعب والجبن وما إلى ذلك من أسباب الضعف والهزيمة ﴿وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُو﴾:
بالقتل والأمر.
(27): ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء﴾: بعد أن يسلك
طريق الهداية والتوبة، وقد جاء وفد من هوازن من الذين حاربوا المسلمين يوم حنين،
إلى رسول الله (ص) تائبين مسلمين، فقبل إسلامهم، ورد عليهم ما طلبوه من الغنائم.
(28): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾: نجاسة
ذاتية، لأن الشرك بالله ظلم عظيم من حيث هو لا بسبب طارئ ولا بد من الإشارة إلى أن
القرآن الكريم يفرق في بعض أحكامه بين المشركين وأهل الكتاب، ويعتبرهما صنفين لا
صنفًا واحدًا، وقد عطف المشركين على أهل الكتاب في أكثر من آية، ومن ذلك: (ما يود
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين – 105 البقرة) وأيضًا لا بد من الإشارة إلى
أن أنصار الرأسمالية الغربية الحديثة هم بحكم المشركين تمامًا كالشيوعيين. وليسوا
من أهل الكتاب في شيء وإن تستروا بقناع مسيحي، ذلك بأن الشيوعيين يؤمنون بأن المادة
هي الموجود الوحيد، لأما أنصار النظام الرأسمالي الاحتكاري الحديث فإنهم من وجهة
عملية لا يقيمون وزنًا للمادة، ويتسلطون على الناس عن طريق العلم المعملي، ويعملون
على تجهيلهم وإبعادهم عن الله والحق بكل سبيل ووسيلة لا لشيء إلا لاستغلالهم
واستنزاف مقدراتهم وأقواتهم. ﴿فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَامِهِمْ هَـذَ﴾: قال أبو حنيفة: لا يمنعون من المسجد الحرام ولا من غيره بطريق
أولى. وقال الشافعي: يمنعون منه دون غيره من المساجد. وقال مالك: يمنعون منه ومن كل
المساجد. ونحن على ذلك. لأن علة المنع النجاسة واحترام المسجد، وكل مسجد طاهر
ومحترم بمجرد نسبته إلى الله تعالى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾: أي فقرًا حيث كان
المشركون يجلبون معهم الأطعمة إلى مكة المكرمة﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن
فَضْلِهِ﴾: لأن أسباب الرزق عنده بعدد أنفاس الخلائق، وقد فتح سبحانه على الإسلام
والمسلمين البلاد وخيراتها ودخل الناس في دين الله أفواجًا، وتوجهوا بقلوبهم
وأموالهم إلى مكة، أما اليوم فخيرات الحجاز تجاوزت الحد والعد، وساهمت في حضارة
الغرب بقسط وافر.
(29): ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾:
والمراد بهم أهل الكتاب: اليهود والنصارى كما يأتي البيان، ونفى عنهم الإيمان بالله
حيث ينسبون إلى إلههم التجسيم ومم إليه مما لا يليق بجلال الله تعالى وكماله وكذلك
يؤمنون بالبعث كما هو في تصورهم لا كما هو في الواقع وعند الله، ومن هنا ساغ النفي
﴿وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ﴾: كابن الله والخمر ﴿وَلاَ
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾: الذي لا يفرق بين أحد من أنبياء الله ورسله ﴿مِنَ
الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾ هذا بيان للذين لا يؤمنون ولا يدينون دين الحق
﴿حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾: والكلام الآن عن
الجزية تكثير ألفاظ بلا جدوى، وأيضًا الخلاف بين المسلمين وبعدهم الآن عن الدين
ونظمهم الدكتاتورية وجمود الجامدين منهم – يلجمنا عن صغار الأولين وهوان الآخرين.
(30): ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ﴾: في قاموس الكتاب المقدس:
(عزرا اسم عبري معناه عون، والاسم نشأ كاختصار لاسم عزريا، وهو كاهن عاد من بابل
إلى القدس) ﴿وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ﴾: في قاموس الكتاب
المقدس ص 865: ( شعر (أي المسيح) في سن مبكرة أنه ابن الله الوحيد) وتقدم الكلام عن
ذلك في تفسير الآية 73 من المائدة ﴿ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ﴾: أما الدليل
على صدق هذا القول فهو أن ألسنتهم نطقت به!. وبعضهم يستدل على ربوبية السيد المسيح
بالانجيل، ويستدل على صحة الانجيل وصدقه بربوبية المسيح (ع) ﴿يُضَاهِؤُونَ﴾:
يشابهون ﴿قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ﴾: كاليونانيين وغيرهم من
المشركين﴿قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾: لعنهم كيف يصرفون عن الحق إلى
الباطل وعن الصواب إلى الخطأ.
(31): ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ﴾: وهم خلف السيد المسيح في الأرض
﴿وَرُهْبَانَهُمْ﴾: الذين اعتزلوا الناس في الأديرة للعبادة، ﴿أَرْبَابًا مِّن
دُونِ اللّهِ﴾: ويروى أن عدي بن حاتم قال لرسول الله: لسنا نعبدهم. فقال له: أليس
يحرمون ما أحل الله وتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: بلى. قال النبي
(ص) فتلك عبادتهم﴿وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾: أي واتخذوا المسيح ربًا من دون
الله ﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ
هُوَ﴾: لأن الشريك لا يخلو من أحد فرضين: إما أن يسد نقصًا، وهذا ينافي الكمال
المطلق، وإما أن لا يؤثر أثرًا، فيكون وجوده لغوًا.
(32): ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ﴾: نبوة محمد والإسلام
﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾: بالكذب والافتراء ﴿وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ
نُورَهُ﴾: بانتصار محمد (ص) وانتشار دينه.
(33): ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾: أي بالإسلام
العقلي في عقيدته، الإلهي في شريعته، العلمي في تجربته، الحياتي في تطبيقه
﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾: لا بالسيف والعنف، بل بشريعة الخير والحياة
(وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا – 30 النحل).
(34): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللّهِ﴾: كالرشوة على الحكم بغير الحق، والربا الذي فشا بين اليهود، وبيع
صكوك الغفران وأذرعا في الجنة عند الكاثوليك، وفي قاموس الكتاب المقدس (وقد صنعت
أصنام كثيرة من الذهب كما صنعت تيجان وسلاسل)﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ﴾: على كل غني أن يعلم ويؤمن بأن في أمواله حقًا لازمًا للفقراء والمساكين،
وأن هذا الحق هو أمانة في يده يجب عليه أن يؤديها كاملة لأهلها وإلا فجزاؤه عند
الله سبحانه ما نص عليه بقوله:
(35): ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا
كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾: وهذا الوعيد والتهديد الغاضب أقوى وأوضح في الدلالة على ثبوت
حق الفقراء في أموال الأغنياء من قوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل
والمحروم – 22 المرسلات) وأيضًا يدل هذا التهديد على أن الفقراء أو وليهم الشرعي أن
يقاتل الأغنياء لاستيفاء هذا الحق. وفي الدر المنثور للسيوطي وغيره من التفاسير (أن
عثمان لما كتب المصاحف أرادوا أن يحذفوا واو العطف من قوله تعالى: (والذين يكنزون
الذهب ...) كي يختص تحريم الكنز بأهل الكتاب أو بالأحبار والرهبان منهم، فعارض بعض
الصحابة وقال: لتلحقن الواو، أو لأضعن سيفي على عاتقي فألحقوها.
(36): ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ
اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ﴾: لاشيء في الوجود مستقل بذاته اسمه
شعبان أو نيسان، أو يوم الإثنين والأحد وإنما الموجود أرض تدور حول نفسها في اليوم
وليلته دورة كاملة، فجزأ الإنسان هذه الدورة إلى 24 جزءًا، واخترع الساعة كرمز إلى
دورة الأرض بالثواني والدقائق والساعات المشار إليها بانتقال العقرب من رقم إلى
رقم، ثم أطلق على هذه العملية اسم الزمان الذي قسمه إلى أيام وشهور، ومعنى هذا في
جوهره أن الزمان هو دورة الأرض أو الساعة بل عقربها، ولا شيء وراء ذلك، هذا ما
أراده اينشتين بقوله: (الزمان – مكان) وهذا المعنى لا يتناقض مع ظاهر الآية، لأنه
تعالى هو الذي خلق الأرض وغيرها من الكواكب، وأودع فيها النواميس التي تتحكم
بحركاتها المنظمة المحكمة بحيث نعرف منها أن هذا متقدم، وذاك متأخر، وأن الذي
بينهما هو الحاضر، وهذا هو الزمان الذي فطر الناس على معرفته بلا كسب واستدلال،
والكسل من خلقه تعالى المحكم او تدبيره المتقن ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ﴾: أشهر
﴿حُرُمٌ﴾: وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾: أي
أن تقسيم الأشهر إلى 12 شهرًا وتحريم الأشهر الأربعة هذه هو الدين المستقيم، وفي
هذا النص دلالة قاطعة على أن علوم الدنيا هي علوم الدين بالذات ما دامت صالحة
ونافعة في جهة من الجهات ﴿فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾: باستحلال
القتال واعتداء بعضكم على بعض ﴿وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا
يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً﴾: قاتلوا عدوكم بنفس السلاح الذي يقاتلكم فيه، ونفس
الطريقة التي يحاربكم بها، فهل استجبنا نحن المسلمين لأمره تعالى ونصحه؟ ولو كنا
مسلمين حقًا لسمعنا لله وأطعنا، وكان معنا حافظًا ونصيرًا، كما قال سبحانه:
﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾: الذين وحدوا صفوفهم كافة ضد عدوهم
المشترك ولم يتفرقوا شيعًا، ويسفكوا دماءهم، ويهدموا كيانهم وسلطانهم بأيديهم.
(37): ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ﴾: كان عرب الجاهلية أصحاب حروب وغارات، وأيضًا كانوا
يعتقدون بتحريم القتال في الأشهر الحرم، فإذا اضطروا إلى الحرب في شهر منها كالمحرم
– مثلاً – قاتلوا فيه، وحرموا بدلاً عنه شهر صفر الذي لا يحرم فيه القتال، وهذا هو
المراد بالنسيء هنا، وهو كما قال سبحانه: ﴿زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾: بضم تحليل
الحرام إلى الشرك أو إلى الحرب العدوانية ﴿يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ
يُحِلِّونَهُ عَامً﴾: حيث يريدون الحرب﴿وَيُحَرِّمُونَهُ عَامً﴾: حيث لا
يريدونها، وبكلمة الدين أهواء تتبع، وأحكام تبتدع ﴿لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا
حَرَّمَ اللّهُ﴾: ليوافقوا عدد الأشهر الأربعة، كأن المهم هو عدد الأشهر لأنفسها.
(38): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ
فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ﴾: بلغ النبي (ص) أن الروم اعتزموا
غزو المدينة المنورة، فأعلن النفير العام لغزوة تبوك فشق ذلك على فريق من الصحابة
لبعد الشقة وكثرة العدو، وآثروا إقامة على أرضهم وبيوتهم، فعاقبهم سبحانه أولاً
بقوله: (ما لكم...) ؟ وثانيًا بقوله:﴿أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ
الآخِرَةِ ...﴾: هل يليق بإيمانكم أن تؤثروا العاجلة على الآجلة؟
(39): ﴿إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئً﴾: تدعون الإيمان ولا تنفرون إلى جهاد
الكافرين؟ فإن الله ينزل بكم العذاب تمامًا كما ينزله بالجاحدين، وينصر نبيه ودينه
بأيدي غيركم، ولا يضر الله ورسوله تثاقل الخائفين ونفاق المنافقين.
(40): ﴿إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ
كَفَرُو﴾: إشارة إلى هجرة النبي (ص) من مكة إلى المدينة التي كانت البداية لتحطيم
قوى الشر والضلال ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾: رسول الله وأبو بكر ﴿إِذْ هُمَا فِي
الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ﴾: خاف أبو بكر فطمنه النبي بقوله:
﴿إِنَّ اللّهَ مَعَنَ﴾: وفي تفسير الرازي أن أبا بكر قال للنبي (ص): إن الله معنا؟
قال الرسول: نعم ﴿فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾: على رسول الله حيث أوحى
إليه بأن الله معه يحرسه ويرعاه كم أخبر النبي أبا بكر ﴿وَأَيَّدَهُ﴾: يوم بدر
وغيره ﴿بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ
السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَ﴾: وكلمة الله هي الإسلام، وكلمة
الكفر هي الأصنام:
(41): ﴿انْفِرُواْ خِفَافً﴾: جمع خفيف، وهو هنا من يستطيع الجهاد بيسر
﴿وَثِقَال﴾: جمع ثقيل والمراد به هنا من يستطيع الجهاد بشيء من المشقة
﴿وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾: إن أمكن وإلا
فبأحدهما وإلا فما على العاجز من حرج، ومن المسلمات الأولية في دين الإسلام أن أي
عدو يحاول الاعتداء على الدينبتحريف كتاب الله أو بصد المسلمين عن إقامة الفرائض
والشعائر الدينية أو بالاستيلاء على بلد من بلادهم، وعجز أهل هذا البلد عن صد العدو
وقاومته – وجب كفاية الجهاد والدفاع عن كل مسلم: الذكر والأنثى والسليم والمريض
والأعمى والأعرج، من كل على قدر طاقته ماديًا أو أدبيًا، ولا يتوقف هذا الجهاد على
إذن الإمام أو نائبه.
(42): ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبً﴾: غنيمة باردة ﴿وَسَفَرًا قَاصِدً﴾: غير شاق
وبعيد ﴿لاَّتَّبَعُوكَ﴾: وهذا من جبلة الإنسان وفطرته، قال الإمام علي (ع): (الناس
أبناء الدنيا، ولا يلام الرجل على حب أمه) ولكن إذا أدى هذا الحب إلى الضرر الأشد
وحب دفعه بالضرر الأخف، وفي الجهاد مصلحة عامة، وهي مقدمة على مصلحة الآحاد، لأن
الضرر في فوات الأولى أعم وأشمل وأشد وأبلغ ﴿وَلَـكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ
الشُّقَّةُ﴾: المسافة شاقة بعدًا وحرًا مع قلة الزاد إلا التقوى، وليسوا لها بأهل
﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾: هذا إخبار
بالشيء قبل وقوعه وقال المفسرون: هو من المعجزات!. ولكنه ليس منها في شيء، لأن هذا
دأب المنافق وديدنه ﴿يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ﴾: كل من يعصي الله في شيء فهو يسيء
إلى نفسه بنفسه.
(43): ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ﴾: الخطاب من الله لرسوله والمراد بالعفو هنا العتاب على
وضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾: كان بعض المنافقون قد
استأذن رسول الله بالتخلف عن غزوة تبوك فأذن له ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ
صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾: كان المنافقون على نية التخلف عنك، وإن لم
تأذن به، ولولا الإذن لظهرت هذه النية الخبيثة المبيتة، وافتضح أمرهم بعصيانهم
لأمرك.
(44): ﴿لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن
يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ﴾: إن مجرد طلب الإذن بالتخلف عن الجهاد
تهاون بالدين وجرأة على المعصية تمامًا كطلب الإذن بالفسق والفجور.
(45): ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ...﴾: هذه الآية
من مضامين التي قبلها، لأنك إذا قلت صاحب البيت لا يستأذن، تبادر إلى الأفهام أن
الغريب هو الذي يستأذن. قيل للإمام علي (ع): صف لنا العاقل، فقال: هو الذي يضع
الشيء مواضعه، فقيل: صف لنا الجاهل، فقال: قد فعلت.
(46): ﴿وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً﴾: لكل شيء موجب
وسبب، ولا موجب للجهاد عندهم إطلاقًا وإلا لاستعدوا له ولم يستأذنوا بالتخلف
﴿وَلَـكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ﴾: لسلوكهم طرق الضلالة والخيانة، وتمسكهم
بأسبابها ﴿فَثَبَّطَهُمْ﴾: أخرهم ﴿وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾: بعد أن
اختاروا لأنفسهم الكسل والخمول والتأخير والقعود، تمامًا كما هي حال العرب
والمسلمين الآن حيث يقع الذنب عليهم لا على الإسلام في كل ما يعانونه من ويلات
ومشكلات.
(47): ﴿لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَال﴾: شرًا وفسادًا
﴿ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ﴾: سعوا بينكم بالنميمة والفتنة..
(48): ﴿لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ﴾: يشير بهذا إلى سيرة المنافقين
مع النبي وإصرارهم على الكيد له والمكر به قبل تبوك ﴿وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ﴾:
دبروها ضدك من كل وجه ولكن الله أبطل سعيهم، وخاب من افترى وبالمناسبة نشير بإيجاز
أن ما ذكره القرآن الكريم من صفات أهل النفاق والشقاق، ينطبق بالكامل على ما يسمى
الآن بالحرب الباردة أو الحرب النفسية التي تثيرها وتتولاها قوى الشر والخيانة من
نشر الشائعات المغرضة، وتجريح الوطنيين، وإثارة الفتن والقلاقل والاستفزازات، ووصم
الحركات الوطنية بالتهديم والتخريب، وعملية الاغتيالات وتدبير المؤامرات
والانقلابات، كل ذلك وما إليه يقوم به المنافقون في عصرنا بطريقة محكمة ومنظمة، بل
وعلمية حيث يستخدمون أساليب ترتكز على علم النفس والاجتماع، ويدخلون إلى كل قلب من
نافذته وعاطفته، أو كما قال الإمام علي (ع): (أعدوا لكل باب مفتاحًا، ولكل ليل
مصباحًا).
(49): ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي﴾: تشير هذه الآية إلى
حادثة خاصة، وهي أن الجد بن قيس كان من شيوخ المنافقين، وقد اعتذر من الذهاب إلى
تبوك بأنه يحب النساء، ويخشى إن هو رأى الروميات الفاتنات أن يقع بغرامهن فنزلت
الآية ﴿أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُو﴾: فر من سيء إلى أسوأ، من الشهوات إلى جهنم
وبئس المصير.
(50): ﴿إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾: شأن الحسود اللئيم، يموت بغيظه إذا رأى
نعمة على غيره ﴿وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن
قَبْلُ﴾: حذرنا ﴿وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ﴾: بهزيمة المسلمين ولا يشمت
بالمصيبة إلا خسيس وضيع. وتقدم في الآية 120 من آل عمران.
(51): ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا...﴾: نحن نؤمن بالله،
ونعمل بأمره في كل شيء متكلين عليه وحده في جهادنا وسائر تصرفاتنا، ولا نخاف حربًا
ولا تجمعًا ولا مكرًا من ماكر، وأيضًا لا نحزن على فشل وهزيمة، ولا نغتر بربح ونصر،
لأننا نعتقد ونوقن بأن مقاليد الأمور كلها بيده تعالى.
(52): ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾: وهما النصر
أو الشهادة، والمعنى أن المقاتل من غيرنا قد ينجح وقد يفشل، أما المقاتل منا فهو
الرابح الناجح على كل حال، لأنه إن ظفر بخصمه فذاك، وإن قتل في سبيل الله فإلى
الجنة ﴿وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ
عِندِهِ﴾: في الدنيا أو الآخرة ﴿أَوْ بِأَيْدِينَ﴾: بأن ينصرنا عليكم
﴿فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ﴾: ا
2015-12-10