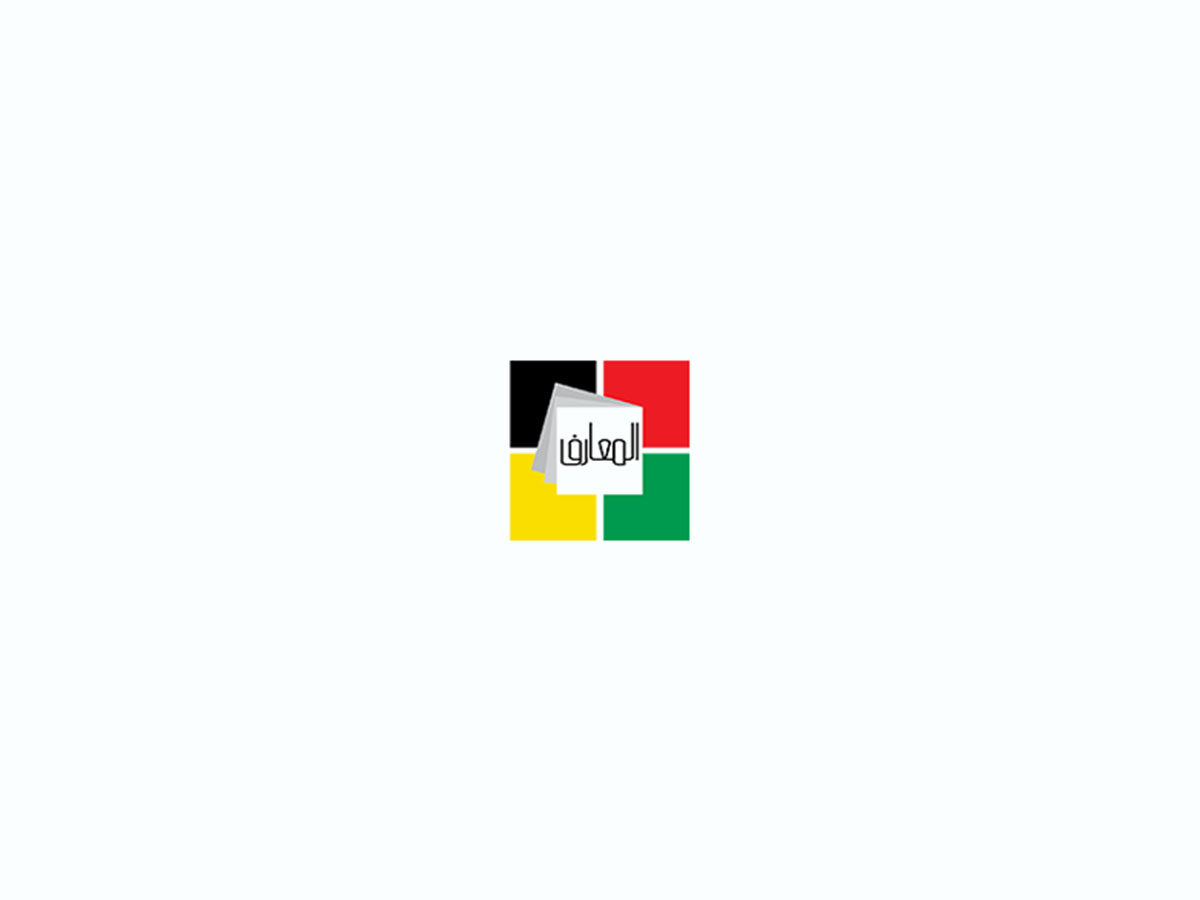(1) – (2): ﴿الَر﴾: تقدم الكلام عن مثله في أول البقرة ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ
إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾: الخطاب لمحمد،
والمراد بالكتاب القرآن، وبالظلمات الجهل والتخلف، وبالنور العلم والتقدم، وحين
نزلت هذه الآية وأخواتها كان العرب أهل جاهلية وأُمة أُمية، يعبدون الأحجار، ويأتون
القبائح والفواحش، ويأكل القوي منهم الضعيف، وبعد القرآن أصبح العرب قادة العلم
الحديث ورادة الخلق الكريم، ومعنى هذا أن القرآن قد صدق بنبوءته هذه تمامًا كما صدق
بنبوءته عن وقعة بدر، وعن انتصار الروم بعد هزيمتها وغيرها من النبوءات، وأيضًا
معنى هذا أن القرآن حق وصدق.
(3): ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ﴾: يؤثرون
الباطل على الحق لا لشيء إلا لأنهم ينقادون بمعدتهم وشهوتهم لا بعقلهم وفطرتهم
﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ﴾: قد ضلوا وأضلوا كثيرًا عن سواء
السبيل﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجً﴾: يطلبون الاعوجاج لسبيل الله بالتحريف والتزييف
والدس والمؤامرات ولا يختص هذا بالملحدين والمشركين، فإن كثيرًا من المسلمين يكذبون
ويخونون ويحرفون ويتآمرون على الإسلام والمسلمين مع أعدائه وأعدائهم.
(4): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ
لَهُمْ﴾: سبيل الحق والنجاة، ويفهموا عنه، وتتحقق الغاية من رسالته ونبغي التنبيه
إلى الفرق بين كلمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وبين كلمة ما أرسلنا رسولاً
إلا لأهل لسانه ولغته، فالصيغة الأولى لا تمنع أن يكون الرسول عامًا ولغته خاصة،
على عكس الصيغة الثانية، فإنها تحصر رسالة الرسول بقومه وحدهم ﴿فَيُضِلُّ اللّهُ
مَن يَشَاء.. ﴾:
ولا يشاء إلا بعد البيان والعصيان، قال سبحانه: (وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ
هداهم حتى يبين لهم ما يتقون – 115 التوبة) وتقدم في الآية 26 من البقرة وغيرها.
(5): ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَ﴾: كالعصا واليد البيضاء والجراد
وغير ذلك ﴿أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾: من الكفر
والضلال إلى الهدى والإيمان تمامًا كغيره من الأنبياء ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ
اللّهِ﴾: ومنها التحرر من أسر فرعون وظلمه، وإنزال المن والسلوى.
(6): ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ... ﴾: ذكر موسى
(ع) بني إسرائيل بنعمة الخلاص من الذبح والاسترقاق ومن كل بلاء، فلم يذكروا ولم
يشكروا، بل جحدوا وتمردوا على الله وعلى موسى.
(7) – (8): ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ﴾: آذنكم وأعلمكم ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ
لأَزِيدَنَّكُمْ﴾: من ثواب الآخرة بدليل قوله تعالى:﴿وَلَئِن كَفَرْتُمْ﴾: من
الكفران لا من الكفر ﴿إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾: وما من شك أن المراد بهذا العذاب
عذاب الآخرة، وإذا كان جزاء كفران النعم، في الآخرة فكذلك جزاء شكرها بدلالة السياق
وطبيعة الحال، إضافة إلى أن اليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل، وإلى قوله
تعالى: (لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة ومعارج عليها يظهرون – 33
الزخرف).
(9): ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ
وَثَمُودَ﴾: قال كثير من المفسرين: إن هذا من قول موسى لقومه، والسياق لا يأباه،
ولكن ما رأيت في فهرس الكتاب المقدس ولا في قاموسه، ذكرًا لعاد وثمود، وإذن فلا ذكر
لهما في التوراة المعروفة، وعليه يكون الكلام مستأنفًا لا من قول موسى ﴿لاَ
يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ﴾: أي لا يعلم عدد أنبياء الله إلا هو، وفيه تكذيب لمن
قال: هم 124 ألفًا وألف أو ثلاثمئة... إلى آخر الأقوال، إضافة إلى قوله تعالى،:
(ورسلاً لم نقصصهم عليك – 164 النساء) ﴿فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي
أَفْوَاهِهِمْ﴾: الضمير لقوم نوج ومن بعدهم، ورد اليد في الفم كناية عن الغيظ،
ومثله (عضوا عليكم الأنامل من الغيظ – 119 آل عمران).
(10): ﴿أَفِي اللّهِ شَكٌّ﴾: أي ينبغي أن لا يكون في وجود الله شك، لأن سلطانه
وبرهانه قائم في كل شيء حتى في الجاحدين والمشككين، وفي يقيني أن ما من جاحد بالله
على وجه الأرض، يتحرر من كل طارئ يصده عن معرفة الحق ويستهدف الكشف عنه لوجه الحق –
ألا تحول جحوده هذا إلى الإيمان الراسخ، ولكن أين هو هذا؟ ولماذا لا يوجد إلا
قليلاً؟ لأن الإنسان بطبعه أناني ينجذب ويتصرف على أساس المصلحة التي يحسها وينتفع
بها في الحياة الدنيا، أما بعد الموت فهو غيب في غيب! ﴿قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ
إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَ﴾: فكيف اختاركم الله لوحيه من دون الناس أجمعين؟
﴿فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾: بمعجزة نقترحها نحن كما نهوى ونريد.
(11): ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾: هل
ادعينا نحن بأننا آلهة أو نصف آلهة أو ملائكة حتى تقولوا إن أنتم إلا بشر؟
﴿وَلَـكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ﴾: إنه تعالى يختار من
عباده البشر من هو كفء لوحيه ورسالته كما يختار أحدكم من هو أهل لوديعته وأمانته؟
﴿وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى
اللّهِ﴾: لقد أتيناكم بالمعجزات الكافية الوافية في الدلالة على صدقنا، أما ما
تقترحون علينا من الخوارق فهي في قبضة الله وحده، وتقدم في الآية 37 من الأنعام
وغيرها.
(12): ﴿وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ﴾: كيف لا نتوكل عليه وقد أتم
علينا نعمته الكبرى، وهي التي أشاروا إليهابقولهم: ﴿وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَ﴾:
التي يجب أن نسلكها إلى طاعته ومرضاته ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا
آذَيْتُمُونَ﴾:والصبر على الأذى في سبيل الله والحق من شيم الأحرار والصفوة
الأخيار، أما الذين ينهارون للصدمة الأولى فهم داء الحياة وأعداؤها ﴿وَعَلَى اللّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾: التوكل الأول في صدر الآية كان من أجل الشكر
على الهداية، أما التوكل الثاني في آخر الآية فهو للاستعانة بالله على وطأة الصبر
وثقله.
(13) – (14): ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ
أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَ﴾: في الآية 82 من الأعراف: (أخرجوهم من
قريتكم إنهم أُناس يتطهرون) هذا هو ذنب الطاهر عن العاهر، والمخلص عند
الخائن﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ... ﴾: أوحى سبحانه إلى رسله: لا تفكروا
إطلاقًا بتهديد الطغاة ووعيدهم، سنقضي عليهم، ونورث المؤمنين أرضهم وديارهم
وأموالهم وفي الحديث من آذى جاره ورثه الله داره.
(15): ﴿وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾: استنصر الأنبياء ربهم
على قومهم بعد اليأس من هدايتهم فاستجاب، وأهلك الطغاة والمستبدين.
(16): ﴿مِّن وَرَآئِهِ﴾: أي بين يدي الجبار العنيد ﴿جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاء
صَدِيدٍ﴾: وفي بعض التفاسير: (أن الصديد خليط من قيح دم، يسيل من فروج الزناة في
النار) وهذه أبشع صورة وأفظع عقاب للطغاة والزناة، هؤلاء يبولون الصديد، وأولئك
يكرعون منه ويتجرعون! فيا له من درس لمن اعتدى أو يعتدي على عرض أو نفس أو حرية أو
مال! سبحانك ربنا ما خلقت عذابك إلا بالحق والعدل وما أخذت به إلا من هو أهل لأكثر
منه.
(17): ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾: لنتنه وقذارته وحرارته ومرارته،
فإذا بلغ الأمعاء قطعها، وأذابها حتى تخرج من أسفله، ثم تتبدل الأمعاء من جديد
ويكرع، وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية أو يشاء الله.
(18): ﴿مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ
اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾: وكل من يعمل الخير بدافع شيطاني
تجاري لا إلهي إنساني – فهو بحكم الذين كفروا من حيث الأجر والثواب. وفي نهج
البلاغة: (اعملوا بغير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله يكله الله إلى من لا
عمل له) ﴿لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ﴾: لا يرون يوم القيامة
ثوابًا لعملهم، وإن كان خيرًا لأنه وسيلة الماكر المحتال ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ
الْبَعِيدُ﴾: كل البعد عن الخير والهداية.
(19)- (20): ﴿أَلَمْ تَرَ﴾:ألم تعلم، والخطاب موجه لكل من يقرأ ويسمع ﴿أَنَّ اللّهَ
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحقِّ﴾: لحكمة اقتضت ذلك، ومن طبيعة العالم
القادر أن يعمل بموجب علمه وقدرته، وإلا فأيه جدوى من العلم والقدرة ﴿إِن يَشَأْ
يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾: أجل من خلق الكون بمن فيه وما فيه قادر
على أن يفنيه، ويأتي بغيره بمجرد أن يريد ذلك بلا آلات وأدوات، وجوارح ومواد.
(21): ﴿وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعً﴾: يخرج كل الخلائق يوم القيامة من القبور
ويقفون بين يدي الله لنقاش الحساب، وجاء الفعل بصيغة الماضي، لأنه محقق الوقوع
﴿فَقَالَ الضُّعَفَاء﴾: وهم الأتباع للقادة الأقوياء ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُو﴾:
وهم الأقوياء الذين استنكفوا عن دعوة الحق، وحاربوه بكل سلاح: ﴿إِنَّا كُنَّا
لَكُمْ تَبَعً﴾: في الحياة الدنيا، نسمع لكم ونطيع. وفي نهج البلاغة: لا تطيعوا
الأدعياء الذين شربتم بصفوكم كدرهم، وخلطتم بصحتكم مرضهم، وأدخلتم في حقكم باطلهم
﴿فَهَلْ أَنتُم﴾: الآن في ساعة العسرة هذه ﴿مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ
مِن شَيْءٍ﴾: أين قوتكم التي تشمخون بها وتتعالون ﴿قَالُو﴾: أي القادة للأتباع:
﴿لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ﴾: المراد بالهداية هنا النجاة والخلاص من
عذاب الله ، لأن الجواب يأتي على وفق السؤال ﴿سَوَاء عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ
صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ﴾: أبدًا لا مهرب من موقف العرض والحساب وموضع
الثواب والعقاب. وتدلنا هذه الآية على أن ظلم الظالم ليس بأسوأ عند الله من صبر
المظلوم على الظلم، وأن عليه أن يجاهد فير سبيل حقه بكل ما يملك من طاقة، وما من شك
أن الموت دفاعًا عن الحرية والكرامة خير ألف مرة من حياة الذل والهوان، قال الإمام
علي (ع): (الموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين). وأخيرًا: هل جرَّأ
الظالم على ظلمه إلاّ سكوت المظلوم عنه؟ ولو علم الظالم أن بين جوانح المظلوم نفسًا
أبية لتحاماه.
(22) – (23): ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ﴾: وجاء الحق وزهق
الباطل، ودالت دولة أنصار الشيطان وأعوانه: ﴿إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ
الْحَقِّ﴾: في كتبه وعلى لسان رسله، وأن الجنة لمن أطاع، والنار لمن
عصى﴿وَوَعَدتُّكُمْ﴾: وقلت لكم: أن الجنة والنار كلام فارغ وحديث خرافة
﴿فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾: لأنه لا يملك إلا التضليل والتزوير، ولا يصدقه ويتبه إلا من
عمي عن الحق لجهل أو هوى ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ﴾: من قوة
قاهرة أو حجة ظاهرة.. هذا هو الشيطان في واقعه تمامًا كالتاجر، يعرض السلعة في
الأسواق على المستهلكين، ويدعوهم إليها بكل ما يملك من وسائل الرواج والإغراء،
وللمستهلك أن يختار، ولكن العاقل لا يأخذ بشهادة من يجر النار إلى قرصه والمنفعة
إلى نفسه، بل ينظر ويبحث، ولا يقدم إلا بعد العلم واليقين، ودعوة الشيطان وحجته زور
وبهتان بشهادته واعترافه، ﴿إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ﴾: بلا حجة أو بحجة زائفة
كاذبة﴿فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾: بنفس راضية تمام الرضا إذن ﴿فَلاَ تَلُومُونِي
وَلُومُواْ أَنفُسَكُم﴾: حيث تركتم الحجة اللازمة الكافية، واتبعتم الحجة الكاذبة
الزائفة ﴿مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ﴾: الصارخ هو
المستغيث، والمصرخ هو المغيث، والمعنى أن الشيطان يقول غدًا لحزبه وأتباعه: ما أنا
بمغن عنكم شيئًا، وما أنتم مغنون عني شيئًا، وليست بيني وبينكم أي صلة ﴿إِنِّي
كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ﴾: إبليس يجحد بالشرك، ما في ذلك ريب،
لأنه علامة وفهامة! ولكنه إمام الدعاة إلى الشرك وأتباعه الذين على سنته، يطرون
ويدعون إلى من يفسد في الأرض، وهو أعلم الناس بمساوئه ومثالبه.
(24): ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾: وهي كلمة
الحق والخير التي تشمل بمفهومها العام كل كلمة تهدي إلى التي هي أقوم، وتدفع الحياة
إلى ما هو أفضل وأحسن ﴿كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ﴾: لا تزعزعه أعاصير
الأكاذيب والافتراءات، ولا معاول الدس والمؤامرات ﴿وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء﴾:
بعيد عن أوباء الأرض وأقذارها.
(25): ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَ﴾: لا تجود آنًا وتبخل
آنًا، بل تفيض بالخيرات ما بقي الليل والنهار﴿وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾: فيشبه المعنى الباطن غير المحسوس بالمعنى
الظاهر المحسوس، ليفهم الناس الهدى فيتبعوه، والضلال فيجتنبوه.
(26): ﴿وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾: وهي كلمة السوء والشر ﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ﴾:
بثمارها وآثارها ﴿اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ﴾: هذا أصدق
مثل للباطل وأهله، وأنهم يبنون من غير دعائم وأساس، فإذا هبت رياح الحق أتت على
بنيانهم من القواعد.
(27): ﴿يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾: المراد بالمؤمنين هنا الذين ترجموا إيمانهم بالإخلاص
والعمل الصالح، ومعنى تثبيتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا أن الله سبحانه قد
أخبرهمفي كتابه وعلى لسان نبيه أنهم في رعايته وعنايته، أما تثبيتهم في الآخرة فهو
بالأمن والأمان من الأفزاع والأسقام والتعرض للأخطار ﴿وَيُضِلُّ اللّهُ
الظَّالِمِينَ﴾: لأنهم ظالمون كما قال سبحانه: (وما يضل به إلا الفاسقين الذين
ينقضون عهد الله.... ويفسدون في الأرض – 26 و 27 البقرة.).
(28) – (29): ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا
وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾: نقل الطبري في تفسير هذه الآية أن عمر
بن الخطاب قال: الذين بدلوا نعمة الله كفرًا. وأحلوا قومهم دار البوار هما
الأفجران: بنو المغيرة وبنو أُمية، فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر، وأما بنو
أُمية فمتعوا إلى حين. ومثله في تفسير ابن كثير نقلاً عن علي وعمر.
(30): ﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ أَندَادً﴾: جمع ند، وهو المثل والشريك، والضد المخالف،
وأيضًا يطلق على المثل والنظير، وبعض الناس يجعلون مع الله شركاء في خلقه، وهم
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، ولكن النتيجة سفاهة وضلالة وعليه تكون اللام في قوله
﴿لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ﴾: للعاقبة لا للتعليل تمامًا كاللام في قول القائل،
لدوا للموت وابنوا للخراب ﴿قُلْ﴾: يا محمد للمشركين ﴿تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ
مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾: وامتثل النبي (ص) فذكّر وحذر، ولكن أكثر الناس لا
يفهمون إلا بلغة المكاسب والأرباح.
(31): ﴿قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾: التي تُذكّر
المصلي بالله، وتردعه عن الجرائم والمآثم، وتبعث فيهم روح الحرية وعدم العبودية إلا
للواحد القهار ﴿وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً﴾: وإنفاق
المال في سبيل الله والصالح العام عز وقوة للإسلام والمسلمين.
(32) – (33): ﴿اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ – إلى قوله تعالى _
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾: كل ما جاء في هاتين الآيتين من ذكر
السموات والأرض والبحر والفلك والشمس والقمر والليل والنهار – تقدم ويأتي، وتسأل:
لماذا يعيد القرآن الكريم ويكرر الآيات الكونية وهي واضحة بلا تفسير؟ الجواب: فعل
القرآن ذلك إيقاظًا للبصائر والأبصار لكي تستدل بمظاهر الموجودات على وجود الله
تعالى، وأن هذه الكائنات بنظامها وإتقانها، لا تكون ويستحيل أن تكون صدفة واتفاقًا،
بل استدلّ بعض العارفين على نبوة محمد (ص) وصدقه، بهذا الإمعان والاستغراق في
الاستدلال بالكون وأسراره، حيث يستحيل على ذهن محمد (ص) بحكم بيئته أن يدرك كل ما
ذكره القرآن في هذا الباب، إضافة إلى التركيز عليه والاهتمام به بالتكرار والإعادة
مرات ومرات.
(34): ﴿وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾: أعطى سبحانه الإنسان كل ما يحتاج
إليه في حياته حتى أسباب الكمال والرفاهية التي أشار إليها بقوله: (قل من حرم زينة
الله التي أخرج لعباده – 32 الأعراف) ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ
تُحْصُوهَ﴾: نحن عاجزون عن تعداد أنعم الله علينا فكيف نؤدي شكرها؟ وأفضل أنواع
الشكر لله أن نطيعه ولا نعصيه ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾: كل من منع
حقًا عن أهله، أو بدد المال وأسرف للتضاهي والتباهي، أو اغتر به واستكبر – فهو
ظلوم، أما الذي يحسب المال هو الدنيا والآخرة جميعًا فهو كفّار، ما في ذلك ريب.
(35): ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنً﴾: من كل
المخاوف، واضح، وتقدم بالحرف الواحد في الآية 126 من البقرة ﴿وَاجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾: ليس هذا خوفًا من الميل إلى عبادة الأصنام،
كيف وقد حطمها إبراهيم الخليل بيده؟ وإنما هو خوف من الله تعالى لأن مجرد الخوف من
سطوته طاعة وعبادة وتعظيم وتمجيد، ومجرد الأمن من هذه السطوة معصية ورذيلة، قال
سبحانه: (فلا يأمن مكر الله – أي عذابه – إلا القوم الخاسرون – 99 الأعراف) وقال:
(إنما يخشى الله من عباده العلماء- 28 فاطر) والله المسؤول أن يهدينا ويهدي من قال
أو يقول: (من مثلي)! ويقول الإمام السجاد وسيد العباد: أسألك اللهم خوف العابدين
وعبادة الخاشعين).
(36): ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ﴾: أي الأصنام ﴿كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾: عبادة
الأصنام سبب للخروج من الهدى ودين الحق ﴿فَمَن تَبِعَنِي﴾: إيمانًا وعملاً
﴿فَإِنَّهُ مِنِّي﴾: كناية عن أن القريب من الله ورسله من قربه الدين والخلق الكريم
﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾: اترك أمر عصاه وخالف أمره ورضاه...
هذه هو رب العباد، وهذا كتابه، وهؤلاء رسله وأنبياؤه: رحمة وسعت كل شيء، وعطاء دونه
كل عطاء، وخير يعم ويشمل كافة الخلق التقي منهم والشقي.. ولن يكون الخالق وأنبياؤه
وأولياؤه إلاّ هكذا.
(37): ﴿رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾: ولكن ليس بالصلاة
وحدها يحيا الإنسان، فإن آفات الفقر ومساوئ المرض والجهل تسمم الحياة، وتهدمها من
الأساس، ولذا قال إبراهيم لربه: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي
إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ﴾ إذا لم يكن عند بيت الله زرع وضرع
فلتتوافد عليه الناس للعبادة أو للتجارة، ومعهم الخبز والإدام، وعندها تأكل ذرية
إبراهيم، وتصلي وتشكر... هذا ما كان أيام الزمان، أما اليوم فينابيع الذهب الأسود
تفور من هنالك، وتسلك السبيل المقرر لها.
(38): ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ... ﴾: بأني ما سألتك الذي سألت لأهل بيتك المحرم
إلا إخلاصًا لك واعترافًا بجودك وكرمك، وأشار إبراهيم بقوله: (وما نعلن) إلى هذا
الذي طلبه من الله تعالى، وبقوله: (ما نخفي) إلى أشياء ومآرب أُخرى لم يذكرها لأنه
تعالى أعلم بها وأدرى.
(39): ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَقَ﴾: تقدم في الآية 71 من هود.
(40): ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ﴾: وصلاة خليل الرحمن تمامًا كنفسه
طهرًا وصفاء حتى ولو كانت سريعة وخفيفة... وما جدوى الإطالة في الصلاة إذا كانت نفس
المصلي تغلي وتفور بالحقد والحسد؟ يقول الإمام علي (ع): ما طاب سقيه طاب غرسه وحلت
ثمرته، وما خبث سقيه خبث غرسه و أُمرَّت ثمرته.
(41): ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ﴾: طلب خليل الرحمن (ع) المغفرة لوالديه في يوم الحساب تمامًا كما طلبها
للمؤمنين، أليس في هذا دليل على أن (آزر) المذكور في الآية 74 من الأنعام – هو عمه
أو جده لأمه كما قال كثير من علماء المسلمين؟.
(42): ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾: بل هم
الغافلون عن الله وحسابه، بل وعن أنفسهم، أمّا هو جل وعز فلا يفوته شيئًا من
عدوانهم وطغيانهم ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾:
وهو يوم يخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
(43): ﴿مُهْطِعِينَ﴾: مسرعين تلبية لدعوة الداعي ﴿مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ
يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء﴾:يرفعون رؤوسهم إلى
السماء لا يرى واحدهم موطئ قدمه من الذهول والدهشة، أما قلوبهم فلا شيء فيها
إطلاقًا إلاّ الهلع والجزع... فأللهم ربنا... ما أحلمك... صبرت على الظالم وأنت
تسمع صراخ المظلوم، يستغيث ولا يغاث حتى جاء اليوم الموعود، فكان أشد على الظالم من
يومه على المظلوم.
(44): ﴿وَأَنذِرِ النَّاسَ﴾: يل محمد ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ
الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ
وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ﴾: بالأمس كانوا يسخرون من البعث ويضحكون على حديثه، واليوم
يتذلّلون ويقولون صاغرين نادمين: هل إلى مرد من سبيل فنسمع ونطيع ما كان أغناهم عن
الحالين! ثم هل الخضوع بالعصا يسمى طاعة؟ ﴿أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن
قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ﴾: وانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة وإنه لا جنة
ولا نار، فذوقوا هذا بذاك.
(45): ﴿وَسَكَنتُمْ فِي مَسَـاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُو﴾: يقول سبحانه غدًا
للمكذبين والمعاندين، أهلكنا من كان قبلكم لأنهم كذبوا الرسل وعاندوا الحق، وأتيتم
من بعدهم، وسكنتم في ديارهم، وسمعتم بأخبارهم، وكان الأجدر أن تتعظوا وتخافوا أن
يصيبكم ما أصابهم، ولكن أبيتم إلا السير على طريق الهالكين، فذوقوا ما قدمتم
لأنفسكم.
(46): ﴿وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ﴾: ما أرسل الله رسولاً إلا مكر به الجبابرة
المترفون من قومه وتآمروا عليه ﴿وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ﴾: أي جزاء مكرهم والعذاب
عليه ﴿وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾: مهما بلغ كيدهم ومكرهم
من القوة والإحكام حتى ولو أزاح الجبال الرواسي فلن يضر دين الله شيئًا، بل يعود
عليهم بالهلاك والوبال.
(47): ﴿فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾: وهو قوله سبحانه
لأنبيائه ورسله: إنّا من المجرمين منتقمون. وقوله تعالى الصدق والعدل، وحكمه الحق
والفصل.
(48): ﴿يَوْمَ﴾: القيامة ﴿تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ﴾: حيث تصبح هباء
منبثًا كم في الآية 6 من الواقعة﴿وَالسَّمَاوَاتُ﴾: أيضًا تتبدل، فإنها تتساقط
وتتناثر بكل ما فيها من كواكب كما في سورة الانفطار وغيرها (إذا السماء انفطرت وإذا
الكواكب انتثرت) ﴿وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾: على المكشوف لا حجاب
وحيل وألعاب، وتقدم في الآية 21 من هذه السورة.
(49): ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ﴾: تربط
بالقيود والأغلال ملائكةُ العذاب أيدي المجرمين وأرجلهم وأعناقهم بعضها ببعض، كل
صنف مع صنفه.
(50): ﴿سَرَابِيلُهُم﴾: جمع سربال وهو القميص ﴿مِّن قَطِرَانٍ﴾: سائل أسود أشبه شيء
بالحديد المذاب، نتن الرائحة، تسرع فيه النار اشتعالاً، تُدهن به الإبل إذا جربت
﴿وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ﴾: تعلوها وتغطيها.
(51): ﴿لِيَجْزِي اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾: لكل جريمة عقوبتها الخاصة
بها، ومن أجل هذا تفاوتت العقوبة وتنوعت كمًا وكيفًا، قال سبحانه: (ومن جاء بالسيئة
فلا يجزلا إلا مثلها وهم لا يظلون) ﴿إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾: لا يحكم
القاضي حتى يحقق ويدقق، وتتوافر له جميع الدلائل و الوسائل، ومن أجل هذا تتعدد
جلسات المحاكمة في دعوى واحدة، وقد تبلغ العشرات، والله سبحانه يحاكم الخلائق
بالكامل ويحكم ويعاقب في سرعة تتناسب وتتفق مع علمه الذي لا يعزب عنه شيء وقدرته
التي لا يعجزها أي شيء.
(52): ﴿هَـذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ... ﴾: يشير سبحانه بهذا إلى القرآن الكريم، وأن
فيه تعاليم ما يكفل للإنسان سعادة الدارين، ومن الترغيب والترهيب ما فيه الكفاية
وزيادة إذا هو أدرك معناه وعمل بمقتضاه. وبكلمة الله وقرآنه لا بكلام الشارحين له
والمفسرين: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر – 17 القمر).
* التفسير المبين / العلامة الشيخ محمد جواد مغنية.
2015-12-10