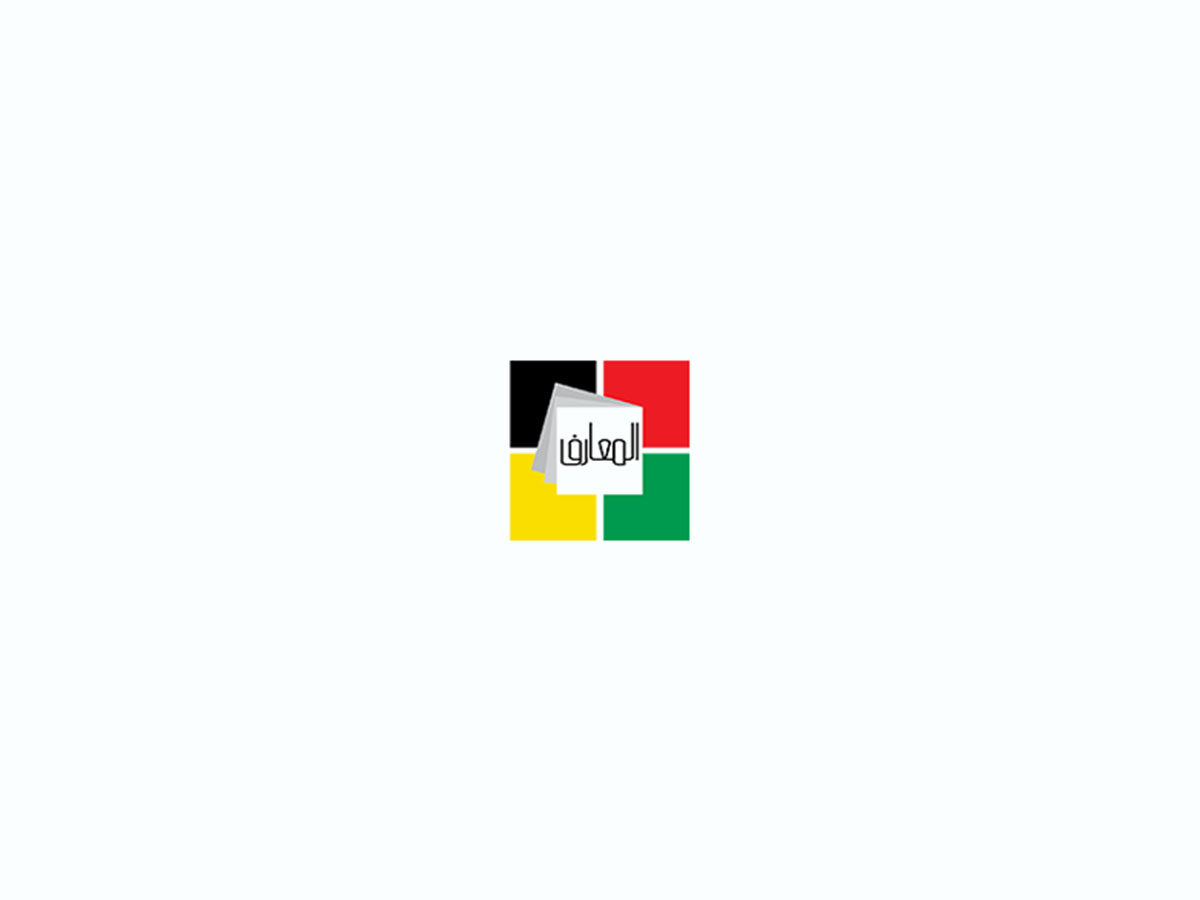(1): ﴿أَتَى أَمْرُ اللّهِ﴾: وهو وقت الحساب وجزاء الأعمال، ووضع الفعل الماضي وهو
أتى مكان الفعل المضارع لأنه واقع لا محالة، وكل آت قريب ﴿فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ﴾:
إشارة إلى قول الجاحدين بالبعث وعقابه: (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين-70
الأعراف).
(2): ﴿يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ
عِبَادِهِ﴾: المراد بالروح هنا الوحي، لأنه للنفوس تمامًا كالأرواح للأبدان، ومثله
ما جاء في الآية 52 من الشورى: (وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما
الكتاب والإيمان) ﴿أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ﴾:
هذا هو الأصل الأصيل لدعوة الأنبياء بالكامل: آمنوا بالله الواحد الأحد واتقوا
معصيته وعقوبته.
(3): ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ...﴾: واضح وتقدم في العديد من الآيات،
وآخرها الآية 85 من الحجر واتقوا معصيته وعقوبته.
(4): ﴿خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾: أول
الإنسان نطفة وآخره جيفة، وهو ما بين ذلك ضعيف تؤلمه البقة، وتقتله الشرقه، وتنتنه
العرقة، كما قال الإمام أمير المؤمنين (ع) ومع هذا يجادل في الله والحق بغير علم
ولا هدى ولا كتاب منير.
(5): ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾: في القرآن الكريم براهين وآيات متنوعة على
وجود الله، منها أن وجوده تعالى مستقر في كيان الإنسان وفطرته حتى في كيان الذين لا
يؤمنون إلا بما يرون ويسمعون، والدليل على ذلك أنهم يلجأون إلى الله تلقائيًا إذا
ضاقت بهم مسالك النجاة بعد أن فروا منه، ومن هذا الباب الآية 22 من يونس: (وجاءهم
الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من
هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض). ومن البراهين على
وجوده تعالى الآيات الكونية والمصنوعات الطبيعية. ومنها التذكير بآلاء الله ونعمائه
كالآيات التي نحن بصددها ﴿فِيهَ﴾: أي في الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ﴿دِفْءٌ﴾:
والمراد به اتقاء البرد بما يصنع من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعاره﴿وَمَنَافِعُ﴾:
بنسلها ودرها وركوبها وإثارة الأرض- أي حرثها- . ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾: اللحم
المذكى.
(6): ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾: حسن المنظر ﴿حِينَ تُرِيحُونَ﴾: حين رجوعها عشيًا
من المرعى إلى المأوى ﴿وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾: تبعثونها صباحًا من المراح إلى المرعى.
(7): ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾: والأثقال تشمل كل ما يمكن نقله من زاد وسلعة
ومتاع ﴿إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ﴾:
وأيضًا السفر ونقل الأمتعة على الإبل والدواب تستدعيه الكثير من المشاق. بخاصة إذا
كان الطريق على الصحراء... ولكن لا وسيلة للنقل أيام زمان إلا الأنعام، وبدونها لا
تستقيم الحياة، وكان الناس يدركون هذه النعمة وعظمتها، ولذا امتن سبحانه بها عليهم،
وفضل الله على إنسان القرن العشرين أجل وأعظم حيث مهد له السبيل لصنع السيارة
والطائرة وغيرها لما وهبه من عقل وطاقات، يكتشف بها العناصر والأسرار التي أودعها
سبحانه فيما خلق وصنع من أشياء الكون والطبيعة.
(8): ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾: بعد أن
أشار سبحانه إلى منافع الأنعام الثلاث: الإبل والبقر والغنم، أشار إلى منافع الخيل
والبغال والحمير، وأهمها الركوب والزينة في ذاك العصر ﴿وَيَخْلُقُ مَا لاَ
تَعْلَمُونَ﴾: لله مخلوقات لا يحيط العقل بعلمها، وكذلك آلاؤه ونعمه، لا عدّ لهذه
ولا حدّ لتلك، والعلّة واضحة، وهي قدرته التي توجد الشيء من لا شيء دون أن تستعين
بشيء.
(9): ﴿وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾: أي عليه سبحانه البيان الواضح المقنع
بطبعه الذي يميز الخبيث من الطيب والحلال من الحرام والخطأ من الصواب ﴿وَمِنْهَا
جَآئِرٌ﴾: ضمير منها يعود إلى السبيل، لأنه هذه الكلمة تذكر وتؤنث، وهي نوعان:
مادية كالسبيل إلى السوق والمدرسة، ومعنوية كالآراء والمعتقدات، ومنها ما هو مستقيم
كالإسلام، ومنها ما هو معوج كغيره، وإلى الرأي والدين المائل المعوج أشار سبحانه
بكلمة جائر ﴿وَلَوْ شَاء﴾:أن يلجئ ويقهر ﴿لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾: ولكنه ترك
الإنسان وما يختار حرصًا على حريته وإنسانيته، وتقدم في الآية 118 من هود.
(10): ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ﴾: عذب
فرات لا محل أجاج ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾: كل ما قام على ساق من نبات
الأرض فهو شجر وتسيمون: ترعون فيه مواشيكم.
(11): ﴿يُنبِتُ لَكُم بِهِ...﴾: أنبت سبحانه بالماء كل ما يأكله الإنسان والحيوان
من حب وخضار وربيع وثمار. وتقدم في الآية32 من إبراهيم و22 من الحجر.
(12): ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ...: تقدم في الآية 2 من الرعد و33
من إبراهيم.
(13): ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾: سخر سبحانه لنا
ما أ,دعه في الأرض من معادن جامدة ومائعة ونبات وغير ذلك.
(14): ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ...﴾: نأكل منه السمك ونستخرج منه الجواهر
وتمخر أي السفن الماء يمينًا وشمالا... إلى غير ذلك من المنافع والفوائد
﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾: ولا تكفرون بالله، وتتخذون من دونه أشباهًا وأندادًا،
وأنتم تتمتعون بخيره وفضله.
(15): ﴿وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾: تقدم في الآية19 من الحجر
﴿وَأَنْهَارً﴾: أي وجعل سبحانه في الأرض أنهارًا ينبع الواحد منها من بلد، ويجري في
أرض العديد من البلاد يمينًا وشمالا وشرقًا وغربًا رزقًا للعباد والدواب والأنعام
﴿وَسُبُل﴾: طرقًا واضحة سالكة إلى ما تقصدون.
(16): ﴿وَعَلامَاتٍ﴾: كالجبال والوديان والتلال ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾:
إذا سافروا في الليل برًا وبحرًا.
(17): ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ﴾: هذا إشكال وإفهام بالحجة لا سؤال
واستفهام ﴿أَفَلا تَذَكَّرُونَ﴾: وتميزون بين الخالق والمخلوق.
(18) – (19): ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَ﴾: تقدم بالحرف
الواحد في الآية 34 من إبراهيم ﴿إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾: يتجاوز ويعفو عن
كثير.
(20): ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يُخْلَقُونَ﴾: من شأن المعبود أن يكون خالقًا لا مخلوقًا، ولكن المشركين يتركون
الخالق، ويعبدون المخلوق.
(21): ﴿أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء﴾: الأصنام لا جماد لا حياة فيها، فكيف تكون آلهة؟
﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾: قال بعض المفسرين ما يشعرون يعود
للأصنام، وضمير أين يبعثون للمشركين. وفي رأينا أن الضميرين يعودان إلى الأصنام،
على أن يكون معنى أيان يبعثون لا يبعثون إطلاقًا، وما من شك أن الحي الذي يموت ثم
يبعث أحسن حالًا من الذي لا حياة فيه ولا بعث له.
(22): ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾: ولكن أرباب الأهواء يرفضون ذلك ويقولون: أجعل
الآلهة إله واحدًا إن هذا لشيء عجاب ﴿فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ
قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ﴾: تنكر الوحيد، وتشمئز من ذكره كما جاء في الآية 45 من
الزمر(وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) ولا بشيء على
الإطلاق إلا بالربح والمنفعة في الحياة الدنيا ولا يعملون إلا لها ﴿وَهُم
مُّسْتَكْبِرُونَ﴾: عن الحق عتوًا وعنادًا.
(23): ﴿لاَ جَرَمَ﴾: حقًا أو ما من شك ﴿أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا
يُعْلِنُونَ﴾: ويعاملهم بما يستحقون ﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾:
الذين يستنكفون عن التسليم بالحق والخضوع له.
(24): ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ
الأَوَّلِينَ﴾: إذا سألهم سائل عن القرآن الكريم نعتوه بما في عقولهم من جهل وسفه
وما في نفوسهم من لؤم وحسد. وفي المقابل إذا سئل المتقون عن القرآن قالوا هو خير
بما فيه هداية وأحكام وآداب وثواب للذين أحسنوا في هذه الدنيا ولدار الآخرة خير
ولنعم دار المتقين كما يأتي في الآية 30 من هذه السورة.
(25): ﴿لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً﴾: الأوزار: الجرائم والآثام، وكاملة:
يحكم عليهم بأشد العقوبات التي يستحقونها بلا تخفيف ورحمة ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾: يؤخذ هؤلاء بعذابين لا
بعذاب واحد: الأول. على بغيهم وضلالهم والثاني على إضلالهم وإغوائهم الآخرين
التابعين ﴿أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ﴾: حيث أضافوا وزرًا إلى زور، وحملوا ثقلا على
ثقل.
(26): ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ...﴾: حاول الطغاة أن تكون كلمتهم هي
العليا، وتحصنوا بالقلاع وخطوط الدفاع! ولكن الله سبحانه أتى عليها من الأساس، وهذا
هو مصير كل طاغ وباغ.
(27): ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ﴾: بأنواع العذاب وأشدها ﴿وَيَقُولُ
أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ
أُوتُواْ الْعِلْمَ﴾: بالحق وعملوا به: ﴿إِنَّ الْخِزْيَ﴾: الذل والفضيحة
﴿الْيَوْمَ وَالْسُّوءَ﴾: التنكيل والعذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾: بالله والحق
والإنسانية.
(28) – (29): ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ﴾:
بمعصيتهم لله وعدوانهم على عباده وعياله﴿فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ﴾: استسلموا حيث لا
سبيل للنفاق ولا للفرار ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ﴾: أي ما كنا نعتقد أنا
ضالون مضلون ﴿بَلَى إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: لا تعتذروا
إن الله يعلم المفسد من المصلح.
(30): ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ
خَيْرًا...﴾: بعد الإشارة إلى الأشقياء المجرمين الذين وصفوا القرآن بالخرافة
والأساطير – أشار سبحانه إلى الأتقياء المنصفين وأنهم إذا سئلوا عن القرآن ذكروه
بكل تقديس وتعظيم... وليس الإنصاف وقفًا على المسلمين، فكل من تحرر من الهوى
والتعصب، وفهم القرآن على حقيقته، يقول: هو خير للناس وصلاح بهديه وتعاليمه.
(31): ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ...﴾: ملك دائم ونعيم قائم لمن أصلح وأحسن عملًا ﴿كَذَلِكَ
يَجْزِي اللّهُ الْمُتَّقِينَ﴾: لأنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى.
(32): ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ﴾: أي راضين مرضيين حيث
تقول لهم الملائكة فيما تقول: سلام عليكم لا تخافوا ولا تحزنوا، أدخلوا الجنة بما
كنتم تعملون.
(33) – (34): ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ
يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾: تقدم بالحرف الواحد في الآية 158 من الأنعام ﴿كَذَلِكَ
فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ...﴾: لج وتمادى في البغي والضلال أسلاف هؤلاء
وأشباههم، فدارت دائرة السوء على رؤوسهم، وهذي هي بالذات عاقبة الأنداد والأمثال
لأن الأشياء المتماثلة تؤدي حتمًا إلى نتائج متماثلة.
(35): ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ...﴾: وهكذا المجرم والمقصر
يلقي المسؤولية على القضاء والقدر أو على الآخرين أو على الزمان أو الصدفة!. وتقدم
في الآية 148 من الأنعام ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ﴾: إن
الله سبحانه لا يتدخل في أفعال العباد بإرادته الشخصية التكوينية، بل يشرع ويبلغ
بلسان رسله، وقد بلغوا وأنكروا على المتمردين المعاندين أشد الإنكار، فأعترضوا
وسخروا، فحقت عليهم كلمة العذاب.
(36): ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ
وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾: تدل هذه الآية بوضوح أن الله سبحانه قد أرسل رسولًا
لكل أمة في كل قرن وإلى كل قطر، وهذا ما يقتضيه العدل، ويحكم به العقل، حيث لا عقاب
بلا تكليف وبيان، وليس من الضروري أن يكون هذا الرسول نبيًا، له تاريخ مذكور وأثر
مشهور، فقد يكون عالمًا بدين الله أو عقلًا خالصًا من الشوائب ﴿فَمِنْهُم مَّنْ
هَدَى اللّهُ﴾: وهو الذي سلك طريق الهدى والتقى (ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته
ويعظم له أجرًا- 5 الطلاق) ﴿وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ﴾: وهو
الذي سلك طريق الضلال، وأسرف في الفساد (إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب-28 غافر).
(37): ﴿إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ﴾: لقد جاهدت يا محمد، وحرصت كل الحرص على
هداية الناس بعامة وقومك بخاصة، ولكن مجرد الحرص ليس سببًا لوجود الهداية، وإنما
السبب الأول هو رغبة الإنسان في الهدى وتحرره من الهوى ﴿فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي
مَن يُضِلُّ﴾: وهو مصر على الضلالة ﴿وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾: إلا الندم
والتوبة قبل فوات الأوان.
(38): ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن
يَمُوتُ﴾: ولا دليل على هذا النفي إلا الاستبعاد والشك، والشك عند العلماء باعث
وسبب للبحث والتنقيب لا للنفي بلسان الجزم ﴿بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّ﴾: لا مفر
منه لأسباب، منها:
(39): ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾: اختلف الناس في ربهم
وأنبيائهم وفي عاداتهم وآرائهم وفي العديد من الأشياء، ولابد من الحكم والفصل بين
المحق والمبطل والطيب والخبيث، ويوم القيامة هو يوم الحساب بالحق والعدل حيث لا حجج
زائفة ولا أعذار كاذبة. ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ
كَاذِبِينَ﴾: في قسمهم: لا يبعث من يموت، ويقولوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا،
وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
(40): ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن
فَيَكُونُ﴾: تمامًا بدأ الخلق بهذه الكلمة وبها يعيده، وتقدم في الآية 117 من
البقرة وغيرها.
(41) – (42): ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ...﴾ :
وتصدق هذه الآية على الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة والمدينة المنورة، وأيضًا
تشمل الذين شردوا عن ديارهم وأموالهم قسرًا وعدوانًا.
(43): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ﴾: قالوا
المعاندون لمحمد: أنت بشر، والله فوق البشر باعترافك، ومن كان فوق الناس لا يختار
رسولا منهم، فإذن ما أن لله برسول! هذا هو منطق الشيطان وحزبه، فأبطل بحانه وعمهم
بأن جميع أنبياء الله ورسله كانوا رجالا من أهل الأرض وملائكة من أهل السماء. هذا،
إلى أن رسالة محمد (ص) هي بذاتها تدل على أنها لسان الله وبيانه، وهل من ذي لب
عليهم وسليم يجرأ على القول بأن القرآن ينطق عن محمد لا عن الله؟ ﴿فَاسْأَلُواْ
أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾: قال جماعة كثر من المفسرين: إن
المراد بالسؤال هنا سؤال خاص ومعين بدلالة سياق الآية، وهو هل أرسل الله إلى الأمم
السابقة بشرًا أو ملائكة؟ وعليه يتعين أن يكون المراد بأهل الذكر المسؤولين هم
علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وفي تفسير ابن كثير القرشي: (أن محمدًا
الباقر قال: نحن أهل الذكر. وعلماء أهل بيت رسول الله عليهم السلام والرحمة من خير
العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة).
(44): ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾: متعلق بأرسلنا: والبينات: الحجج والدلائل،
والزبر: الكتب ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ﴾: يا محمد﴿الذِّكْرَ﴾: القرآن ﴿لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾: هذه هي مهمة الأنبياء أن ينقلوا عن الله لعباده
حرامه وحلاله وثوابه وعقابه، لا أن يتنبأ كل نبي ويجتهد طبقًا لمزاجه وخياله وإلا
كان الأنبياء تمامًا كأبي حنيفة والمالكي والشافعي وغيرهم من أئمة المذاهب, وبهذا
يتبين الخطأ في قول من قال من علماء السنة: يجوز للنبي أن يجتهد فيما لا نص فيه.
(45) – (46): ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّئَاتِ﴾: قال المفسرون:
المراد بالماكرين هنا مشركو مكة ، لأنهم ألبوا على النبي (ص) وتآمروا على قتله ﴿أَن
يَخْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الأَرْضَ﴾: فتبتلعهم أحياء كما فعل سبحانه بقارون ﴿أَوْ
يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ﴾: يهلكهم بغتة كما فعل بقوم
لوط ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ﴾: في أسفارهم وحال اشتغالهم في أمورهم
الخاصة والعامة.
(47): ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾: أي وهم خائفون يترقبون أن يحل بهم هذا
العذاب ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾: لا يجعل العقوبة لمن يستحقها، بل
يمهل ويفتح باب التوبة، ويقول: من دخله كان آمنًا.
(48): ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ
ظِلاَلُهُ﴾: قد يقال: وأي عجب أن يكون للشيء ظل وفيء مادام هناك شمس وأرض تدور
حولها؟ الجواب: ليس القصد من ذلك مجرد الإخبار بأن لكل جسم ظلًا كي يكون تحصيلًا
للحاصل وكتفسير الماء بالماء، وإنما القصد التنبيه إلى نظام الكون بأسره، وأنه
تعالى أتقن كل شيء من خلقه ووضعه في فلكه تمامًا كما قال: الرجل المناسب في المكان
المناسب، وضرب مثلا لذلك بالظل، وأنه لو لم تكن الشمس في فلكها والأرض في مكانها ما
كان لكل جسم ظل، وكذلك سائر المخلوقات، وكل في فلك يسبحون ﴿سُجَّدًا لِلّهِ﴾: أي كل
الكائنات تخضع لتدبير الله، وتنطق بكماله وجلاله وبالغ قدرته وحكمته ﴿وَهُمْ
دَاخِرُونَ﴾: أي منقادون صاغرون ولمناسبة الإشارة إلى الفيء ننقل هذه الكلمات من
دعاء للإمام زين العابدين وسيد الساجدين (ع) (سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور،
سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء) فمن أين جاءه هذا العلم يومذاك إذا لم يكن عن أبيه
عن جده عن جبريل عن الباري؟.
(49) – (50): ﴿وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ...﴾: قال الإمام الصادق
(ع): (السجود على نوعين: إرادي وطبيعي) والأول سجود العقلاء، والثاني سجود سائر
الموجودات بمعنى أنها في قبضة الله، وتدل على قدرته وعظمته من باب دلالة المصنوع
على الصانع. وتقدم في الآية13 وما بعدها من الرعد.
(51) - (52): ﴿وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلـهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ
إِلهٌ وَاحِدٌ﴾: قال الإمام علي (ع) في وصيته لولده الحسن (ع) : (لو كان لربك شريك
لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد) وتقدم
في الآية171 من النساء و73 من المائدة ﴿وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبً﴾: المراد بالدين
هنا الطاعة، وبالواصب الدائم، والمعنى تجب طاعة الله في كل شيء، ومن أطاعة في الصوم
والصلاة، وعصاه عند بروق المطامع فما هو من دين الله في شيء ﴿أَفَغَيْرَ اللّهِ
تَتَّقُونَ﴾: وترجون أن يحقق ما في نفوسكم من ميول ورغبات.
(53) - (54): ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ﴾: مالا كانت أو ولدًا أو جاهًا أو عافية
﴿فَمِنَ اللّهِ﴾: لا من سواه، فكيف تلجأون وتتذللون إلى مخلوق مثلكم طمعًا بما في
يده ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾: ترفعون أصواتكم
مستغيثين بالله أن يكشف عنكم الضر علمًا منكم بأنه تعالى وهو وحده الذي يدفعه
ويزيله. وهنا مكان الغرابة: تلجأون إلى الله مضطرين، وتبتعدون عن طاعته مختارين!
وتقدم في الآية 12 من يونس.
(55): ﴿لِيَكْفُرُواْ بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾: المراد بالكفر هنا كفران النعمة
وجحودها، واللام في ليكفروا للعاقبة، والمعنى أن الله أنعم عليهم بالكثير، فكانت
عاقبة الحسنى كفرًا لا شكرًا ﴿فَتَمَتَّعُو﴾: بما أنعم الله عليكم واعملوا ما
شئتم﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾: عاقبتكم الوخيمة، وتندمون حيث لا ينفع الندم.
(56): ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾: يشير
سبحانه بهذا إلى الجاهلية المشركة وأن أهلها كانوا يعبدون الأصنام، ويجعلون لها
نصيبًا في أموالهم، وتقدم في الآية 136 من الأنعام.
(57): ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ﴾:
قالوا: الملائكة إناث وهن بنات الله، فنسبوا إليه أخس القسمين من الأولاد، أما
القسم الأفضل الذين يحبون وهو الذكور فنسبوه لأنفسهم كما في الآية 22 من النجم:
(ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى).
(58): ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ﴾: كناية عن
الهم والكآبة ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾: ممتلئ بالغيظ، ولكن يتجرعه ولا يظهره.
(59): ﴿يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾: حتى كأنه ارتكب
أبشع الأفعال وفكر: ﴿أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ﴾: هل يبقي المولود المشؤوم صابرًا
على المذلة والمهانة ﴿أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾: حيًا كما كانوا يصنعون في
الجاهلية.
(60): ﴿لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ﴾: أي الوصف القبيح
كقتل الأطفال وغيرهم من الأبرياء والسلب والنهب والسفه والجهل ﴿وَلِلّهِ الْمَثَلُ
الأَعْلَىَ﴾: أي الوصف العلي العظيم. وتجدر الإشارة أن القصد من ذكره تعالى مع ذكر
هؤلاء الرد على قولهم: لله البنات ولهم البنون.
(61): ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن
دَآبَّةٍ﴾: اليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل، ولو كان الجزاء منه تعالى في
دار الدنيا لكانت الآخرة لزوم ما لا يلزم، إضافة إلى أن الخضوع خوفًا من السيف
المشهور فوق الرأس، لا يعد طاعة ومنقبة ﴿وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ
مُّسَمًّى﴾: لتظهر أفعالهم التي يستحقون عليها الثواب والعقاب بعد تراكم الأدلة
وتكرارها وقيام الحجة ولزومها وفتح باب التوبة بمصراعيه﴿فَإِذَا جَاء
أَجَلُهُمْ...﴾: واضح، وتقدم في الآية 34 من الأعراف و49 من يونس.
(62): ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾: لأنفسهم من البنات والشركاء في
السيادة والرياسة ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ﴾: ومنه إدعائهم ﴿أَنَّ لَهُمُ
الْحُسْنَى﴾: العاقبة الحسنة، فرد سبحانه هذا الإدعاء الباطل بقوله: ﴿لاَ جَرَمَ﴾:
لا شك فيه ﴿أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ﴾: وبئس القرار ﴿وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ﴾: بفتح
الراء مع تخفيفها من الفرط بمعنى السبق لا من الإفراط. بمعنى التجاوز، والمعنى أنهم
السابقون إلى النار.
(63): ﴿تَاللّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ﴾: رسلا ﴿إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾: يا محمد
فلم يستجيبوا لرسلهم، بل قاسوا منهم ألوانًا من الأذى ﴿فَزَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾: فاستمعوا له وأطاعوه، وعصوا الرسل كما عصاك وآذاك
مشركوا قريش، فهون عليك ولا تحزن، فإن لك أسوه بإخوانك النبيين.
(64): ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي
اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾: تشير هذه الآية إلى
أن الله سبحانه أنزل القرآن على محمد (ص) لغايات 3. الأولى: أن يرد إليه كل قضية
دينية يختلف فيها اثنان. الثانية: أن يهدي به من ضل سواء السبيل. الثالثة: أن شريعة
القرآن عدل ورحمة للعالمين، لأن أحكامها بالكامل تهدف إلى جلب المصلحة ودرء
المفسدة، فما من شيء فيه خير وصلاح إلا وأمرت به وجوبًا أو ندبًا، وما من شيء فيه
شر وفساد إلا ونهت عنه تحريمًا لا كراهة.
(65): ﴿وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ الْسَّمَاء مَاء...﴾: كلنا يعلم أنه لا حياة بلا ماء،
ولكن القرآن يذكر بنعم الله وإفضاله من له أذن تسمع وقلب يخشع، وتقدم في العديد من
الآيات منها الآية 22 و 164 من البقرة.
(66): ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ﴾: الإبل والبقر والغنم ﴿لَعِبْرَةً﴾: دلالة
على قدرة الخالق وحكمته ﴿نُّسْقِيكُم مِّمَّ﴾: من هنا للتبعيض أي من بعض الأنعام
وهو الإناث لأن الذكور لا لبن فيها ﴿فِي بُطُونِهِ﴾: يعود الضمير إلى بعض الأنعام
﴿مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾: والفرث ما
يبقى في الكرش بعد الهضم، ويقول العارفون: إذا هضمت معدة الحيوان الغذاء طردت
الفضلات الضارة إلى الخارج، وتمتص العصارة النافعة، فتتحول إلى دم يسري في العروق
والغدد التي في ضرع الأنثى، ويصبح لبنًا خالصًا من رائحة الفرث والدم ولونهما
وطعمهما.
(67): ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا
وَرِزْقًا حَسَنً﴾: الظاهر من كلمة السكر الشراب المسكر خمرًا كان أو غيره، ولا
تومئ هذه الآية من قريب أو بعيد إلى تحليل المسكر أو تحريمه، وإنما حكت عن عادة
الناس وأنهم يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب شرابًا مسكرًا، أم الرزق الحسن
فالمراد به التمر والرطب والزبيب والعنب وما إلى ذلك، وتحدثنا عن حكم الخمر في
القرآن والإسلام عند تفسير الآية 219 من سورة البقرة، وفي الجزء الرابع من كتاب فقه
الإمام جعفر الصادق(ع) باب الأطعمة والأشربة.
(68): ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾: المراد بالوحي هنا الغريزة، لأن
الحيوان لا يفكر ويخطط بعقل بل بغريزة تقوده آليًا وتلقائيًا إلى ما يطر إليه في
حياته وبقائه تمامًا كالكون تسيره وتتحكم به النواميس الطبيعية التي أودعها الله
فيه ﴿أنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ﴾: قال الرازي: (النحل نوعان: نوع يسكن في الجبال والغياض – أي مجتمع
الشجر- ولا يتعهده أحد، وهو المراد بقوله تعالى: أن إتخذي من الجبال بيوتًا ومن
الشجر، ونوع يسكن بيوت الناس، ويكون في تعهدهم وهو المراد بقوله: (ومما يعرشون).
(69): ﴿ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾: الطيبة اليانعة ﴿فَاسْلُكِي سُبُلَ
رَبِّكِ ذُلُل﴾: سيري أنى تشائين، فكل الطرق سالكة أمامك ومذللة ﴿يَخْرُجُ مِن
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾: بياضًا وحمره وصفره تبعًا للمرعى
﴿فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ﴾: من بعض الأمراض كفقر الدم وسوء الهضم والتهاب الفم وغير
ذلك.
(70): ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ﴾: كل فرد من أفراد الإنسان كان في
طي العدم والكتمان ثم أنشأه الله حيًا يقاسي عذاب النزع والإحتضار من ولادته إلى
ساعة أجله، فيعود إلى عالم العدم من هذه الدنيا كأن لم يكن شيء ﴿وَمِنكُم مَّن
يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئً﴾: ضعيف
في الجسم، وقلة في العلم، وخرف في العقل، وسوء في الحفظ، وفوق ذلك علل وأسقام أشكال
وألوان حتى كرهه وجوده وضاق به أهله، ومل ممرضه.
(71): ﴿وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ﴾: هذا مجرد تعبير
وحكاية عما هو الواقع بالفعل تمامًا كما لو قال: بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء،
وأسند الرزق إلى مشيئته تعالى لأنه جرى على الأسباب التي تنتهي إليه (وخلق كل شيء
فقدره تقديرا-2 الفرقان) أي بنظام وحكمة وفي الآية 20 من الشورى ربط سبحانه رزق
الدنيا والآخرة بإرادة الإنسان: (من كان يريد حرث الآخرة نزد له حرثه ومن كان يريد
حرث الدنيا نؤته منها) وفي الآية 18 و19من الإسراء: (من كان يريد العاجلة عجلنا له
فيها ... ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا)
وأخيرًا نكرر ونؤكد لا طبقات في الإسلام على أساس الجاه والمال والأنساب ﴿فَمَا
الَّذِينَ فُضِّلُو﴾: وهم الأغنياء ﴿بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ﴾: على مماليكهم وعبيدهم ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَاء﴾: أي لا يرضي الأغنياء
بالمساواة بينهم وبين العبيد في الأموال، والآية بجملتها رد على المشركين الذين
جعلوا لله أندادًا وأشباهًا من خلقه، ووجه الرد أن هؤلاء لا يرضون بحال أن يشاركهم
في أموالهم أحد من عبيدهم، فكيف يرضى سبحانه بالمساواة بينه وبين عبيده في الألوهية
والكمال والجلال؟ وهل شأن الله تعالى دون شأنكم أيها المشركون؟ وبكلمة هل لكم شركاء
من عبيدكم فيما تملكون حتى نسبتم إلى الله شركاء من عبيده فيما خلق.
(72): ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجً﴾: من جنسكم لا من جنس
آخر، كي يتم الإنس والمشاركة في الحياة الزوجية بين الزوجين... هذا ما يجب أو ينبغي
أن يكون، أما ما هو كائن بالفعل فمطلب آخر... ويستحيل أن تتآلف الأخلاق والأرواح
إلا إذا تعارفت، وتعاطفت كما في الحديث الشريف ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم
بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾: أولا أولاد، كان أكثرهم من قبل نعمة، أما بعد (الخنافس
والمنيجوب) فالكثير منهم نقمة. وفي سفينة البحار للقمي حديث طويل عن الذين يأتون في
آخر الزمان، جاء فيه: (فعند ذلك حلت العزوبة، قالوا يا رسول الله أمرتنا بالتزويج،
قال: بلى ولكن إذا كان ذلك الزمان فهلاك الرجل على يد زوجته وولده... يكلفونه ما لا
يطيق حتى يوردوه موارد الهلكة) ﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾: مطعمًا ومشربًا،
إضافة إلى الأزواج والأولاد وغير ذلك من المستلذات.
(73): ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ...﴾: تقدم في الآية 18 من يونس.
(74): ﴿فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ﴾: لا تجعلوا لله أمثالا وأشباهًا في
الخلق والالوهية.
(75): ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾:
هذا مثل للأصنام التي يصنعها الوثنيون بأيديهم ثم يعبدونها! أنها تمامًا كالعبد
المملوك الذي لا يرجى خيرا، ولا يخشى شره، بل أسوأ منه وأضعف ﴿وَمَن رَّزَقْنَاهُ
مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرً﴾: هذا مثل لحر غني
قوي وكريم، يتصرف في نفسه وماله كيف يشاء ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾: الحر القادر والعبد
العاجز، وإذا رفضت الفطرة والبديهة هذه المساواة، فكيف صح في أفهام الوثنيين أن
يساووا بين الخالق الرازق وبين وثنهم الذي تبول عليه القطط والكلاب؟ وكل دين أو
2015-12-10