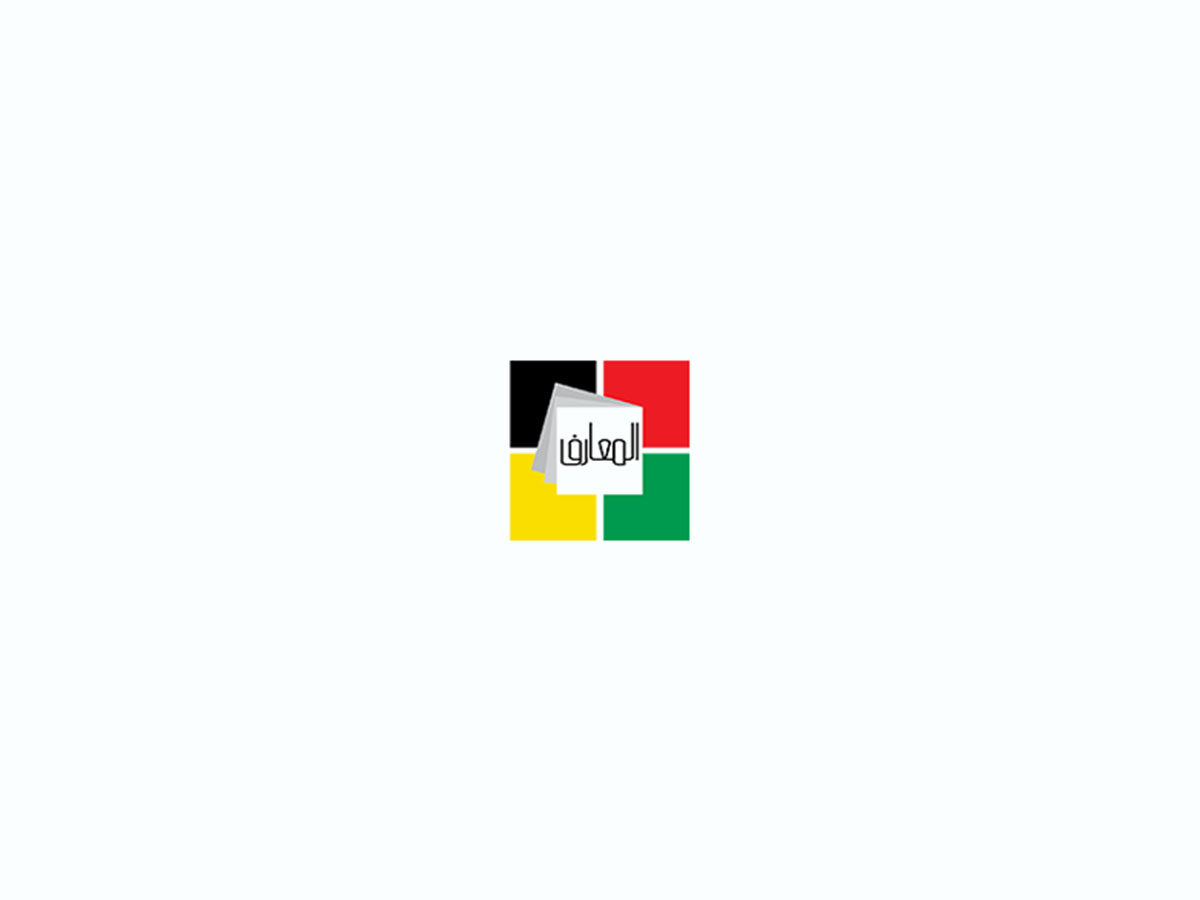(1): ﴿الم﴾: تقدم في أول البقرة.
(2): ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا
يُفْتَنُونَ﴾: لا يبتلون ويمتحنون بالضراء والسراء، وخلاصة المعنى أن الإيمان ليس
لعقًا على اللسان، ولا صورة وشكلاً، ولا تسبيحًا وتهليلاً على عدد حبات المسابح،
وإنما هو فعل الواجب وترك الحرام، وعلى سبيل المثال: إن كنت غنيًا أديت حق الله
والناس من أخماس وزكوات عن طيب نفس، وإن كنت فقيرًا لم تبع دينك للشيطان، ورضيت بأي
عمل.. الأعمال المحللة السائغة لسد الحاجة والجوعة.
(3): ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾: وجاء في التفاسير أن هذه الآية
نزلت في عمار بن ياسر وغيره من المعذبين على الإسلام، والقصد منها أن يوطنوا النفس
على الأذى من أجل الحق، وينالوا الدرجات عند الله، ويؤيد هذا قوله تعالى بلا فاصل:
(ولقد فتنا الذين من قبلهم) أي من قبل المعذبين على الإسلام فصبروا صبر الأحرار
﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُو﴾: الله يعلم الصادقين والكاذبين لأنه
يعلم ما هو كائن وما كان وما يكون وما لا يكون، ولكن لتظهر الأفعال التي يستحق
عليها الإنسان الثواب والعقاب.
(4): ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَ﴾: أن
يمتنعوا منا بهرب أو حصن أو حيلة؟.
(5): ﴿مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾: من آمن
باليوم الآخر وعمل له، فإيمانه حق وصدق، وعمله خير وأجر، وسيرى ذلك لا محالة، وكل
آت قريب.
(6): ﴿وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾: الله يقول، والعقل يقول،
والفطرة والناس والأديان والشرائع كلها تقول: ليس للإنسان إلا ما سعى. أما العمل
والتنفيذ فكل يعمل على شاكلته أو منفعته أو دينه وعقيدته وإنسانيته. وما ربك بغافل
عما يعملون.
(7): ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ﴾: هذه الآية تختص بمن كفر أو أذنب، ثم ندم وتاب، فيعفو سبحانه عما
سلف، ويزيده من فضله، ومن عاد فينتقم الله منه.
(8) – (9): ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنً﴾: الوالد يحسن إلى
ولده بالإنفاق والإشفاق، لا يريد منه جزاءًا ولا شكورًا، وكل الذي يبتغيه أن يكف
أذاه عنه، وهذا وحده في عصرنا من أحسن الإحسان ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ﴾: إن كنت موحدًا، وكان أبواك
مشركين، وحرضاك على دينهما فإياك وإياهما، وفيما عدا ذلك لا تغضبهما ﴿إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: حساب الشرك والكفر بالله
لله وحده لا لوالد أو ولد ولا لشيخ أو خوري.
(10) – (11): ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾: وما هو من الإيمان
الحق في شيء، ولكن إبليس حاك له خرافة على منواله، وصبغها بلون الإيمان وشكله،
وباعها لأبله مسكين، فانطلت عليه الحيلة، وأخذ ينشر ويذيع من مثله إيمانًا بوحي من
الشيطان وهو على يقين بأنه من إملاء الدين! وكيف يكون من الدين وما دخل العجب شيئًا
إلا أفسده وأهلكه، وفي الحديث: لولا العجب ما ابتلى المؤمن الحق بذنب وفي ثان: ضحكك
وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل، إن المدل لا يصعد من عمله شيء ﴿فَإِذَا أُوذِيَ
فِي اللَّهِ... ﴾: يذهب إيمانه مع الريح، لأنه مجرد لون ومظهر ﴿وَلَئِن جَاء نَصْرٌ
مِّن رَّبِّكَ... ﴾: تقدم في الآية 141 من النساء.
(12): ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا
وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾: قال الذين كفروا بمحمد (ص) للذين آمنوا به: ما آمنتم
به إلا خوفًا من نار جهنم، ارتدوا عن دينه إلى ديننا، ونحن نحمل العذاب عنكم، قالوا
هذا ساخرين من خرافة النشر والحشر ﴿وَمَا هُم بِحَامِلِينَ﴾: أبدًا لا أحد يحمل على
أحد، كل أمرئ وما كسب.
(13): ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾: كل من
ضلَّ وأضلَّ آخرين يبوء بوزرين: وزر نفسه، ووزر من اغتر به دون أن ينقص من وزر هذا
شيئًا.
(14) – (15): ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ
سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامً﴾: قيل: هذه تسلية من الله لمحمد (ص) أن لا يأسف
ويحزن لإعراض من أعرض عنه، فإن نوحًا مكث في قومه يدعوهم ليلاً ونهارًا فما زادهم
ذلك إلا فرارًا، وتقدم الحديث عن نوح مرات منها في الأعراف وهود والشعراء.
(16): ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ...﴾: دعا إبراهيم (ع) إلى التوحيد،
ولاقى الكثير في سبيل دعوته حتى أُلقي في النار، وما زاده ذلك إلا قوة وصلابة في
دينه وحزمًا وثباتًا على ثورته وقال لقومه من جملة ما قال:
(17): ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكً﴾:
تبتدعون أشياء لا أساس لهل إلا الجهل والضلال.
(18): ﴿وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ﴾: وبلغكم ما حلَّ
بهم من بوار ودمار.
(19): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾: أما
الخلق الأول فندركه بالحس والعيان، ونحن منه والخلق الثاني ندركه بالعقل، لأن الذي
أحيا وأمات يهون عليه أن يحيي الأموات بحكم البديهة.
(20): ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾: أي من لا
شيء مادي؛ بل بكلمة (كن) وإلا لما وجد شيء إطلاقًا، لأن السؤال يبقى قائمًا إلى ما
لا نهاية تمامًا كسؤال السائل لماذا لا تسقط الأرض في الفضاء؟ فأُجيب بأنها تستند
إلى قرن الثور. ثم سأل ثانية ولماذا لا يسقط الثور؟ فأُجيب بأنه يستند إلى سلحفاة.
فسأل للمرة الثالثة ولماذا لا تسقط السلحفاة؟ ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ﴾: حيث تجزى كل نفس الجزاء الأوفى على ما قدمت.
(21): ﴿يُعَذِّبُُ مَن يَشَاء وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء﴾: وما من شك أن مشيئته تعالى
تصدر عن علمه وعدله وحكمته لا يشغله غضب عن رحمة، ولا تولهه – أي لا تذهله – رحمة
كما قال الإمام أمير المؤمنين (ع):
(22): ﴿وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء﴾: لا ملجأ
ولا مهرب من الله لأهل الأرض والسماء إلا إليه.
(23): ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾: الدالة على وجوده وقدرته على إحياء
الموتى ﴿أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي﴾: لا نصيب لهم فيها.
(24): ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ
حَرِّقُوهُ﴾: عجزوا عن رد الدليل بالدليل والحجة بالحجة فهددوا وتوعدوا، ولكنه في
حصن أمين من حول الله وقدرته وتقدم في الآية 69 من الأنبياء.
(25): ﴿وَقَالَ﴾: إبراهيم لقومه: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ
أَوْثَانً﴾: كرمز وعنوان لوحدتكم وكيانكم الإجتماعي، وأنكم قلب واحد ويد واحدة على
عدوكم، ولكنكم غدًا وفي دار الحق سترون أن هذه الأصنام هي السبب الأساس والأصيل
لعذابكم وتباغضكم حيث ﴿يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضً﴾:
إن ذلك لحق تخاصم أهل النار – 64 ص. على العكس من أهل الجنة الذين قال عنهم سبحانه:
(ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانًا على سرر متقابلين – 47 الحجر).
(26): ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ﴾: ابن أخي إبراهيم ﴿وَقَالَ﴾: إبراهيم: ﴿إِنِّي
مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾: داعيًا إليه وإلى العمل بدينه وشريعته.
(27): ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ﴾: بن إسحاق، وتقدم في الآية 49 من
مريم و72 من الأنبياء.
(28) – (29): ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾: أنكر عليهم هذا الفعل القبيح
الشنيع، وقوله: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ﴾: يدل بصراحة أنهم أول من اكتشف
ومارس، وسمعنا وقرأنا أن في الغرب والشرق أسافل وأراذل على دين قوم لوط! فبعدًا لهم
وسحقًا ﴿وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ﴾: أي سبيل النسل بترك النساء ﴿وَتَأْتُونَ فِي
نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ﴾: النادي: مجلس تجتمع فيه الرجال، والمنكر: فعلهم بالذكور.
(30): ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي﴾: بنزول العذاب عليهم استغاث بالله، وتضرع إليه أن
يتولى حربهم بنفسه لأن الله سبحانه لم يهيء له أسباب الجهاد والقتال كالسلاح
والرجال.
(31) – (33): ﴿وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾: المراد
بالرسل هنا الملائكة، وبالبشرى البشارة بولده إسحق ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ
مِنَ الْغَابِرِينَ﴾: الباقين مع الهالكين، ودخل الملائكة على لوط في هيئة شبان
حسان، ولما رآهم ﴿سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعً﴾: المراد بالذرع هنا الطاقة
والمعنى أن لوطًا أضافهم، ولكنه أحس بكابوس على قلبه مخافة أن ينالهم أذى من قومه.
(34) – (37): ﴿إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزً﴾: عذابًا
من السماء لا يبقى منهم إلا الآثار عبرة لأولي الأبصار، وتقدمت هذه الآيات في سورة
الأعراف وهود ﴿وَارْجُواْ الْيَوْمَ الآَخِرَ﴾: على حذف مضاف أي ثواب اليوم
الآخر﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾: الزلزلة الشديدة ﴿جَاثِمِينَ﴾: باركين على
الركب ميتين، وتقدم في سورة الأعراف.
(38): ﴿وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ﴾: عاد قوم
هود، وثمود قوم صالح، قال ابن كثير في تفسيره كانت العرب تعرف مساكنهما جيدًا وتمر
عليها كثيرًا.
(39): ﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ﴾: مثلث الرجس والعتو والضلال: قارون
الغني الشقي العالمي، وتقدم عنه الحديث في الآية 76 من القصص. وفرعون الرب الغريق
الصفيق، وسبق ذكره في سورة الأعراف وهامان وزير فرعون، وأُشير إليه في القصص.
(40): ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ﴾: ولا مناص ولا محالة، فكل مجرم مرتهن بجرمه،
وحبيس بإثمه ﴿فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبً﴾: كقوم لوط، والحاصب:
الرمي بالحصباء ﴿وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَ﴾: كقوم نوح وفرعون ﴿وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾: كيف وهو القائل: (أن لعنة الله على الظالمين – 44
الأعراف) ﴿وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾: قال رجل لأبي ذر: عظني، قال:
لا تسيء إلى نفسك. قال: وهل من أحد يسيء إلى نفسه، قال: من يعرضها للمهلكات
والعثرات.
(41): ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ
الْعَنكَبُوتِ... ﴾: جاء في كتاب القرآن محاولة لفهم عصري ما شرحه وتوضيحه: كشف
العلم الحديث أن الإنسان لو اتخذ لنفسه خيمة من خيوط الصلب بدقة خيط العنكبوت لكان
بيتها بالنسبة إليها أقوى ثلاثة أضعاف من خيمة هذا الإنسان بالنسبة إليه، ومعنى هذا
أن بيت العنكبوت حصن حصين لها، ولكن إذا تحصن به الإنسان والتجأ إليه يكون هذا
الحصن (العنكبي) بالنسبة إليه لا شيء على الإطلاق تمامًا كما لو تحصن بالضياء أو
بالهواء ... وهذا شأن من اعتز بغير الله، وتوكل على سواه.
(42): ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ﴾: ليس هذا
إخبارًا بأن الله يعلم هوية المعبود من دونه كلا، بل هو تهديد ووعيد للعابد
المعاند.
(43) – (44): ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾: تلك إشارة إلى بيت
العنكبوت ونظائره ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾: هذا هو دين الحياة
والإنسانية والحق والواقع، يخاطب العلماء والعقلاء والمفكرين لا الجهلة المقلدين
الذين يريدون من أهل العلم بالدين أن يشفوا المرضى، ويردوا الضائع، ويعقد اللسان
الوحش بالرقية والتميمة.
(45): ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾: القرآن، وتقدم في الآية 27 من
الكهف ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ﴾: لتشريع وجوب
الصلاة علة وحكمة، وعلة الوجوب مشيئة الله وكفى، أما الحكمة منه فهي أن يبتعد
المصلي في جميع تصرفاته ومقاصده عن الفحشاء والمنكر أي عن الحرام بشتى أنواعه،
ومعنى هذا أن الإنتهاء عن المنكر حكمة لوجوب الصلاة في عالم التشريع لا لوجود
الصلاة في الخارج، فمن صلى وانتهى يسقط عنه وجوب الصلاة ويثاب عليها أيضًا، ومن صلى
ولم ينته يسقط عنه الفرض قطعًا، أما الثواب فبعلم الله، تقول هذا علمًا بأن الفقهاء
ربطوا بين الثواب على الصلاة، والتوجه إليها فكرًا وقلبًا لا بين الثواب والإنتهاء
﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾: أي ذكر الله تعالى للمصلي بالرضا والأجر أكبر من
ذكر المصلي لله في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده، ومثله قوله تعالى: (فاذكروني أذكركم
– 152 البقرة).
(46): ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: أهل
الكتاب: اليهود والنصارى، والأحسن: الأصلح والأنجح الذي يقرب ولا يبعد، ويبشر ولا
ينفر، وإنما خص سبحانه أهل الكتاب بالذكر علمًا بأن الأسلوب هو المطلوب من غير قيد
لأن المفروض من أهل الكتاب أن يتقبلوا الحق ما داموا يؤمنون بالله واليوم الآخر كما
يزعمون ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾: وهم الذين إذا سمعوا القول لا يتبعون
أحسنه تعنتًا وتعصبًا. فهؤلاء لا يسوغ الحديث معهم بحال ﴿وَقُولُو﴾: أيها المسلمون
لأهل الكتاب: ﴿آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ... ﴾:
لماذا التعصب والتباغض؟ فعلى الصعيد الإنساني نحن وأنتم سواء في الحقوق والواجبات،
أما على الصعيد الديني فكلنا نؤمن بوحي السماء. هكذا ينظر الإسلام إلى أهل الكتاب
نظرة التسامح والإخاء لا نظرة التعصب والعداء، وشهد بذلك العديد من أقطاب المسيحيين
المنصفين منهم (جيدر بامات) في كتابه مجالي الإسلام تعريف عادل زعيتر، فقد جاء في
الفصل الثاني نظرة في مذهب الإسلام (من النادر أن لاقى دين ما لاقى من جحود وتشويه
من المبشرات البالغة الغلظة والمقترحات البالغة الوقاحة حول محمد وتعاليمه ... مع
العلم بأن المسلمين منعوا من أن يمس النصارى بسوء، وتركوا المغلوبين أحرارًا في
المحافظة على دينهم، ولما صار الصليبيون سادة ذبحوا المسلمين بلا رحمة).
(47): ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾: أي كما أنزلنا على من قبلك من
الرسل كذلك أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن ﴿فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾:
يريد سبحانه العلماء المنصفين من أهل الكتاب ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾: يصدقون كل ما جاء
في القرآن ﴿وَمِنْ هَؤُلَاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ﴾: هؤلاء إشارة إلى مشركي قريش فقد
أسلم بعضهم عن صدق وإخلاص.
(48): ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ
إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾: هل يخطر على ذهن عاقل بأن هذا القرآن من إنشاء
محمد وفيه من الحقائق والعلوم ما يجهله محمد وغيره قبل نزول القرآن إضافة إلى أنه
لا يقرأ ولا يكتب كي يتشدق ويتحذلق جاهل سافل بأن محمدًا قرأ ونقل بقلمه من أسفار
الأولين.
(49): ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾: وهم
محمد وأهل بيته (ص) الذين هم خزنة علمه، والعلماء المتمسكون بعروته.
(50): ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ﴾: يريدون بالآيات
ما يقترحون ويشتهون كتحويل الجبل ذهبًا، وتقدم في الآية 37 من الأنعام ﴿قُلْ
إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ﴾: وليس لي من الأمر شيء ﴿وَإِنَّمَا أَنَا
نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾: مهمتي التبليغ وكفى.
(51): ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾: القرآن، وكل
ما فيه من حقائق علمية وشريعة حياتية وتحديات ونبوءات حدثت وتحققت – تشهد بأنه من
عند الله هدى لعباده على مدى الحياة.
(52): ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدً﴾: بأنه أرسلني إليكم،
وأني قد بلغت رسالته على أكمل وجه، وأنكم قد كذبتم وأعرضتم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا
بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾: كل ما نهى الله عنه فهو باطل، وكل من عصى الله
فهو فاسق أو كافر، والكل جائر وخاسر.
(53): ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾: أن يحل بهم ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ
مُّسَمًّى﴾: أي تأخير العذاب إلى يوم القيامة﴿لَجَاءهُمُ الْعَذَابُ﴾: قريبًا
وسريعًا.
(54): ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ
بِالْكَافِرِينَ﴾: هم يستعجلون العذاب ويسخرون؟ وهو آت لا محالة.
(55): ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ﴾: من كل جهة، فتأكل النار الجلود واللحوم
والعظام والقلوب تمامًا كما تأكل الحطب... رحماك يا رحيم. وشفيعي إليك قلبي الذي
يحبك، ودليل حبه لك نصحه لعيالك، وأنت أعلم بذلك مني ومنه.
(56): ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ
فَاعْبُدُونِ﴾: على كل مسلم، بنص هذه الآية، أن يهجر ويفر من أي أرض يتعذر عليه
فيها أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات حتى ولو كانت الأرض بلده ووطنه.
(57): ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾: مقيمة كانت أم مهاجرة.
(58): ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ
الْجَنَّةِ غُرَفً﴾: مقيمين أم مهاجرين، بل فضل الله على المجاهدين في سبيل الله
درجة وكلا وعد الله الحسنى.
(59): ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾: ثبتوا على دينهم
وهاجروا به، وتوكلوا على الله في كل حال، وقد رأينا أرزاق المهاجرين أكثر وأوسع،
وأطيب وأنفع.
(60): ﴿وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا
وَإِيَّاكُمْ﴾: الله سبحانه هو الذي يعطي كل نفس جميع ما تحتاج، ولكن مع الحركة
والعمل لأنه أبى سبحانه إلا أن يربط المسببات بأسبابها والنتائج بمقدماتها، وحركة
كل حي بحسبه، كما نرى من سعي النحلة والنملة والطير ووحش الغاب، ومن الإنسان وكل
حيوان أما المريض أو الكسيح فإن الله يسخر له من يقوم بحاجته، وفي شتى الأحوال فإن
أسباب الرزق وغيره تنتهي إليه لأنه خالق كل شيء. وكتبت كثيرًا حول الرزق، ولعل
أفضله – فيما أظن – ما ذكرته في شرح الحكمة 378 من حكم نهج البلاغة. أنظر في ظلال
نهج البلاغة ج4 ص440.
(61): ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... ﴾:
المسئولون هم الجبابرة المترفون، وقد أعلنوا إيمانهم بالله الذي منحهم الحرية
المطلقة في أن يزلزلوا الأمن والأمان، ويرهبوا العالم، وينهبوا الأمم! وما من شك أن
هذه الفئة الحرة القذرة هي أسوأ حالاً عند الله ممن كفر به أو أشرك.
(62): ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾: أي
يضيق، وقلنا فيما تقدم ونكرر أن مشيئة الله منزهة عن العبث والمجازفة وعليه يكون
معنى الآية أن الله سبحانه يوسع الرزق أو يضيقه تبعًا لأسبابه السائغة شرعًا
وعقلاً، أما المال الحرام فما هو من رزق الله في شيء، بل هو غضب ونهب وسموم ويحموم.
(63): ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾: الماء هو السبب الأول
والأساس للرزق، وقد أنزله الله من السماء باعتراف المحتكرين والمستأثرين والله
للجميع لا لفئة دون فئة أو لفرد دون فرد، فالرزق كذلك لا يسوغ لأحد أن يحتكره
ويتحكم به.
(64): ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ﴾: المراد
بالدنيا هنا القصور والفجور والصهباء والليالي الحمراء، والبذخ على حساب الفقراء
وإلا فإن المال الحلال أحد السبل لمرضاة الله وطاعته، ونقلوا عن الإمام الشافعي أنه
كان لا يحسن التفكير في مسألة إذا شعر أن بيته خلا من الدقيق. وقال الرسول الأعظم
(ص): (كاد الفقر يكون كفرًا) ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾:
الحياة الطيبة الدائمة وهذه الحياة وقف على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومعنى هذا
أن الإسلام يربط بين دنيا الخير والآخرة بحيث تدور هذه مع تلك وجودًا وعدمًا.
(65): ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ... ﴾:ُ تقدم في
الآية 22 من يونس.
(66): ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾:
هذا تهديد ووعيد للطغاة من أرباب الجاه والمال، وأن مآلهم شر مآل.
(67): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنً﴾: واو الجماعة في يروا
لعتاة قريش الذين نصبوا العداء للنبي (ص) ووصلوا في حربه وإيذاءه حدًا بعيدًا،
ويقول سبحانه لهؤلاءَ: تتمردون على طاعة الله وقد أحلكم في حرمه دار الأمن والأمان؟
﴿ويُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾: أي وأعراب الجاهلية حول مكة يقتل بعضهم
بعضًا، وينهبون ويسلبون ولا أحد منهم يمس أهلها بسوء، أفبنعمة الله يجحدون وللأصنام
يعبدون؟.
(68): ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبً﴾: حيث جعلوا له
أضدادًا وأندادًا ﴿أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ﴾: القرآن ونبوة محمد (ص).
(69): ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَ﴾: ومنهم من تعلم
العلم النافع وعمل به وعلمه الناس، وأيضًا منهم من أتى بجديد مفيد لأخيه الإنسان،
ومن جاهد الضلال والفساد، وكافح في سبيل العيش الحلال ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ﴾: ولا يختص الإحسان بأداء الفرائض فقط ولا بالصدقات، بل يعم ويشمل
الشعور باحترام الإنسان وكرامته وكف الأذى عنه.
* التفسير المبين / العلامة الشيخ محمد جواد مغنية.
2015-12-10