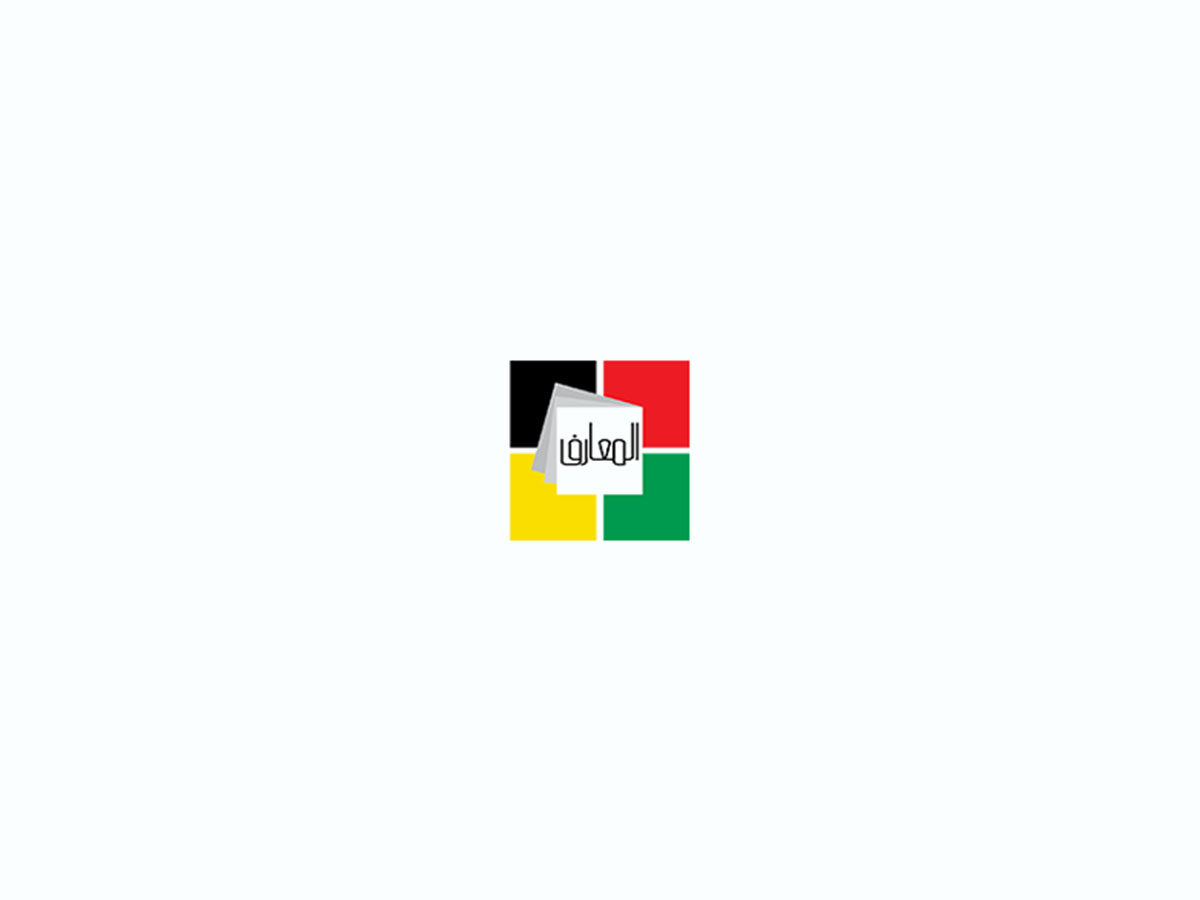ما هي حقيقة العصمة؟
عرف المتكلمون العصمة على الإطلاق بأنّها قوة تمنع الإنسان عن اقتراف المعصية والوقوع في الخطأ. (1)وعرّفها الفاضل المقداد بقوله: العصمة عبارة عن لطف يفعله الله في المكلف بحيث لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة ولا إلى فعل المعصية
عدد الزوار: 1117
عرف المتكلمون العصمة على الإطلاق بأنّها قوة تمنع الإنسان عن اقتراف المعصية
والوقوع في الخطأ. (1)وعرّفها الفاضل المقداد بقوله: العصمة عبارة عن لطف يفعله
الله في المكلف بحيث لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة ولا إلى فعل المعصية مع
قدرته على ذلك ويحصل انتظام ذلك اللطف بأن يحصل له ملكة مانعة من الفجور والإقدام
على المعاصي مضافًا إلى العلم بما في الطاعة من الثواب، والعصمة من العقاب، مع خوف
المؤاخذة على ترك الا ََولى، وفعل المنسي. أقول: إذا كانت حقيقة العصمة عبارة
عن القوة المانعة عن اقتراف المعصية والوقوع في الخطاء، كما عرّفه المتكلمون فيقع
الكلام في موردين:
الأوّل: العصمة عن المعصية.
الثاني: العصمة عن الخطأ.
ولتوضيح حال المقامين من حيث الاستدلال والبرهنة يجب أن يبحث قبل كل شيء عن حقيقة
العصمة.
إنّ حقيقة العصمة عن اقتراف المعاصي ترجع إلى أحد أُمور ثلاثة على وجه منع الخلو،
وان كانت غير مانعة عن الجمع:
أفبعد هذا هل يصح أن تعد العصمة كرامة وترك الذنب فضيلة؟ وليس معنى التوحيد في
الخالقية سلب التأثير عن سائر العلل، وقد أوضحنا الحال في الجزء الأوّل من هذه
السلسلة عند البحث عن هذا القسم من التوحيد، فلاحظ.
1. العصمة الدرجة القصوى من التقوى
العصمة ترجع إلى التقوى بل هي درجة عليا منها، فما توصف به التقوى وتعرف به تعرف
وتوصف به العصمة.
لا شك أنّ التقوى حالة نفسانية تعصم الإنسان عن اقتراف كثير من القبائح والمعاصي،
فإذا بلغت تلك الحالة إلى نهايتها تعصم الإنسان عن اقتراف جميع قبائح الأعمال،
وذميم الفعال على وجه الإطلاق، بل تعصم الإنسان حتى عن التفكير في المعصية،
فالمعصوم ليس خصوص من لا يرتكب المعاصي ويقترفها بل هو من لا يحوم حولها بفكره.
إنّ العصمة ملكة نفسانية راسخة في النفس لها آثار خاصة كسائر الملكات النفسانية من
الشجاعة والعفة والسخاء، فإذا كان الإنسان شجاعًا وجسورًا، سخيًا وباذلاً، وعفيفًا
ونزيهًا، يطلب في حياته معالى الأمور، ويتجنب عن سفاسفها فيطرد ما يخالفه من
الآثار، كالخوف والجبن والبخل والإمساك، والقبح والسوء، ولا يرى في حياته أثرًا
منها.
ومثله العصمة، فإذا بلغ الإنسان درجة قصوى من التقوى، وصارت تلك الحالة راسخة في
نفسه يصل الإنسان إلى حد لا يرى في حياته أثر من العصيان والطغيان، والتمرّد
والتجرّي، وتصير ساحته نقية عن المعصية.
وأمّا أنّ الإنسان كيف يصل إلى هذا المقام؟ وما هو العامل الذي يمكنه من هذه
الحالة؟ فهو بحث آخر سنرجع إليه في مستقبل الأبحاث.
فإذا كانت العصمة من سنخ التقوى والدرجة العليا منها، يسهل لك تقسيمها إلى العصمة
المطلقة والعصمة النسبية.
فإنّ العصمة المطلقة وإن كانت تختص بطبقة خاصة من الناس لكن العصمة النسبية تعم
كثيرًا من الناس من غير فرق بين أولياء الله وغيرهم، لأنّ الإنسان الشريف الذي لا
يقل وجوده في أوساطنا، وإن كان يقترف بعض المعاصي لكنه يجتنب عن بعضها اجتنابًا
تامًا بحيث يتجنب عن التفكير بها فضلاً عن الإتيان بها.
مثلاً الإنسان الشريف لا يتجوّل عاريًا في الشوارع والطرقات مهما بلغ تحريض الآخرين
له على ذلك الفعل، كما أنّ كثيرًا من اللصوص لا يقومون بالسرقة في منتصف الليل
متسلحين لانتهاب شىء رخيص، كما أنّ كثيرًا من الناس لا يقومون بقتل الأبرياء ولا
بقتل أنفسهم وان عرضت عليهم مكافآت مادية كبيرة، فإنّ الحوافز الداعية إلى هذه
الأفاعيل المنكرة غير موجودة في نفوسهم، أو أنّها محكومة ومردودة بالتقوى التي
تحلّوا بها، ولأجل ذلك صاروا بمعزل عن تلك الأفعال القبيحة حتى أنّهم لا يفكّرون
فيها ولا يحدّثون بها أنفسهم أبدًا.
والعصمة النسبية التي تعرفت عليها تقرب حقيقة العصمة المطلقة في أذهاننا، فلو بلغت
تلك الحالة النفسانية الرادعة في الإنسان مبلغًا كبيرًا ومرحلة شديدة بحيث تمنعه من
اقتراف جميع القبائح، يصير معصومًا مطلقًا، كما أنّ الإنسان في القسم الأوّل صار
معصومًا نسبيًا.
وعلى الجملة: إذا كانت حوافز الطغيان والعصيان والبواعث على المخالفة محكومة عند
الإنسان، منفورة لديه لأجل الحالة الراسخة، يصير الإنسان معصومًا تامًا منزهًا عن
كل عيب وشين.
2. العصمة: نتيجة العلم القطعي بعواقب المعاصي
قد تعرفت على النظريّة الأولى في حقيقة العصمة وانّها عبارة عن:
الدرجة العليا من التقوى، غير انّ هناك نظرية أُخرى في حقيقتها، لا تنافي النظرية
الأولى، بل ربّما تعد من علل تحقق الدرجة العليا من التقوى التي عرفنا العصمة بها
وموجب تكونها في النفس، وحقيقة هذه النظرية عبارة عن " وجود العلم القطعي اليقيني
بعواقب المعاصي والآثام" علمًا قطعيًا لا يغلب ولا يدخله شك، ولا يعتريه ريب، وهو
أن يبلغ علم الإنسان درجة يلمس في هذه النشأة لوازم الأعمال وآثارها في النشأة الا
َُخرى وتبعاتها فيها، ويصير على حد يدرك بل يرى درجات أهل الجنة ودركات أهل النار،
وهذا العلم القطعي هو الذي يزيل الحجب بين الإنسان وتوابع الأعمال، ويصير الإنسان
مصداقًا لقوله سبحانه:
﴿كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينِ* لَتَرَوُنَّ
الْجَحِيم﴾
وصاحب هذا العلم هو الذي يصفه الإمام علي (عليه السلام) بقوله: "فهم
والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون". فإذا بلغ العلم إلى هذه الدرجة من الكشف يصد الإنسان عن اجتراء المعاصي واقتراف
المآثم بل لا يجول حولها فكره.
ولتوضيح تأثير هذا العلم في صيرورة الإنسان معصومًا من اقتراف الذنب نأتي بمثال:
إنّ الإنسان إذا وقف على أنّ في الأسلاك الكهربائية طاقة من شأنها قتل الإنسان إذا
مسها من دون حاجز أو عائق بحيث يكون المس والموت مقترنين، أحجمت نفسه عن مس تلك
الأسلاك والاقتراب منها دون عائق.
هذا نظير الطبيب العارف بعواقب الأمراض وآثار الجراثيم، فإنّه إذا وقف على ماء
اغتسل فيه مصاب بالجذام أو البرص أو السل، لم يقدم على شربه والاغتسال منه ومباشرته
مهما اشتدت حاجته إلى ذلك لعلمه بما يجر عليه الشرب والاغتسال بذلك الماء الموبوء،
فإذا وقف الإنسان الكامل على ما وراء هذه النشأة من نتائج الأعمال وعواقب الفعال
ورأي بالعيون البرزخية تبدل الكنوز المكتنزة من الذهب والفضة إلى النار المحماة
التي تكوى بها جباه الكانزين وجنوبهم وظهورهم، امتنع عن حبس الأموال والإحجام عن
إنفاقها في سبيل الله.
قال سبحانه:
﴿ؤالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ ؤالْفِضَّةَ ؤلا يُنْفِقُونَها فِي
سَبيلِ اللهِ فَبَشّرْهُمْ بِعَذابٍ ألِيمٍ* يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها في نارِ
جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ ؤجُنُوبُهُمْ ؤظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ
لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾. إنّ ظاهر قوله سبحانه: (هذا
ما كنزتم لأنفسكم) هو انّ النار التي تكوى بها جباه الكانزين وجنوبهم وظهورهم، ليست
إلاّ نفس الذهب والفضة، لكن بوجودهما الأخرويّين، وأنّ للذهب والفضة وجودين أو
ظهورين في النشأتين فهذه الأجسام الفلزية، تتجلّى في النشأة الدنيوية في صورة الذهب
والفضة، وفي النشأة الأخروية في صورة النيران المحماة.
فالإنسان العادي اللامس لهذه الفلزات المكنوزة وان كان لا يحس فيها الحرارة ولا يرى
فيها النار ولا لهيبها، إلاّ أنّ ذلك لأجل أنّه يفقد حين المس، الحس المناسب لدرك
نيران النشأة الآخرة وحرارتها، فلو فرض إنسان كامل يمتلك هذا الحس إلى جانب بقية
حواسه العادية المتعارفة ويدرك بنحو خاص الوجه الآخر لهذه الفلزات، وهو نيرانها
وحرارتها، يجتنبها، كاجتنابه النيران الدنيوية، ولا يقدم على كنزها، وتكديسها.
وهذا البيان يفيد انّ للعلم مرحلة قويّة راسخة تصد الإنسان عن الوقوع في المعاصي
والآثام ولا يكون مغلوبًا للشهوات والغرائز.
قال جمال الدين مقداد بن عبد الله الأسدي السيوري الحلي في كتابه القيم "اللوامع
الإلهية": "ولبعضهم كلام حسن جامع هنا قالوا: العصمة ملكة نفسانية يمنع المتصف بها
من الفجور مع قدرته عليه، وتتوقف هذه الملكة على العلم بمثالب المعاصي ومناقب
الطاعات، لأنّ العفّة متى حصلت في جوهر النفس وانضاف إليها العلم التام بما في
المعصية من الشقاء، والطاعة من السعادة، صار ذلك العلم موجبًا لرسوخها في النفس
فتصير ملكة". يقول العلاّمة الطباطبائي في هذا الصدد: إنّ القوة المسمّاة بقوة
العصمة سبب شعوري علمي غير مغلوب البتة، ولو كانت من قبيل ما نتعارفه من أقسام
الشعور والإدراك، لتسرب إليها التخلّف، ولتخبط الإنسان على أثره أحيانًا، فهذا
العلم من غير سنخ سائر العلوم والإدراكات المتعارفة، التي تقبل الاكتساب والتعلم،
وقد أشار الله في خطابه الذي خص به نبيه بقوله: (ؤأنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الكِتابَ
ؤالْحِكْمَةَ ؤعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ وهو خطاب خاص لا نفقهه حقيقة
الفقه، إذ لا تذوق لنا في هذا المجال. وهو قدّس سره يشير إلى كيفية خاصة من
العلم والشعور الذي أوضحناه بما ورد حول الكنز وآثاره.
3. الاستشعار بعظمة الرب وكماله وجماله
إنّ هاهنا نظرية ثالثة في تبيين حقيقة العصمة يرجع لبها إلى أنّ استشعار العبد
بعظمة الخالق وحبه وتفانيه في معرفته وعشقه له، يصده عن سلوك ما يخالف رضاه سبحانه.
وتلك النظرية مثل النظرية الثانية لا تخالف النظرية الأولى التي فسرناها من أنّ
العصمة هي الدرجة العليا من التقوى، بل يكون الاستشعار والتفاني دون الحق، والعشق
لجماله وكماله، أحد العوامل لحصول تلك المرتبة من التقوى، وهذا النحو من الاستشعار
لا يحصل إلاّ للكاملين في المعرفة الإلهية البالغين أعلى قممها.
إذا عرف الإنسان خالقه كمال المعرفة الميسورة، وتعرف على معدن الكمال المطلق وجماله
وجلاله، وجد في نفسه انجذابًا نحو الحق، وتعلّقًا خاصًا به بحيث لا يستبدل برضاه
شيئًا، فهذا الكمال المطلق هو الذي إذا تعرف عليه الإنسان العارف، يؤجج في نفسه
نيران الشوق والمحبة، ويدفعه إلى أن لا يبتغى سواه، ولا يطلب سوى إطاعة أمره
وامتثال نهيه، ويصبح كل ما يخالف أمره ورضاه منفورًا لديه، مقبوحًا في نظره، أشد
القبح. وعندئذ يصبح الإنسان مصونًا عن المخالفة، بعيدًا عن المعصية بحيث لا يؤثر
على رضاه شيئًا، وإلى ذلك يشير الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) بقوله: "ما
عبدتك خوفًا من نارك ولا طمعًا في جنتك إنّما وجدتك أهلاً للعبادة". هذه
النظريات الثلاث أو النظرية الواحدة المختلفة في البيان والتقرير تعرب عن أنّ
العصمة قوة في النفس تعصم الإنسان عن الوقوع في مخالفة الرب سبحانه وتعالى، وليست
العصمة أمرًا خارجًا عن ذات الإنسان الكامل وهويته الخارجية.
نعم هذه التحاليل الثلاثة لحقيقة العصمة، كلّها راجعة إلى العصمة عن المعصية
والمصونية عن التمرد كما هو واضح لمن أعطى التأمل لها، وأمّا العصمة في مقام تلقى
الوحى والتحفظ عليه وإبلاغه إلى الناس، أو العصمة عن الخطأ في الحياة والأمور
الفردية أو الاجتماعية فلا بد أن توجه بوجوه غير هذه الثلاثة كما سيوافيك بيانها
عند البحث عن المقام الثاني، أعنى: العصمة عن الخطأ والاشتباه، والمهم هو البحث عن
المقام الأوّل، ولذلك قدّمنا الكلام فيه.
*عصمة
الانبياء في القران / اية الله جعفر السبحاني.