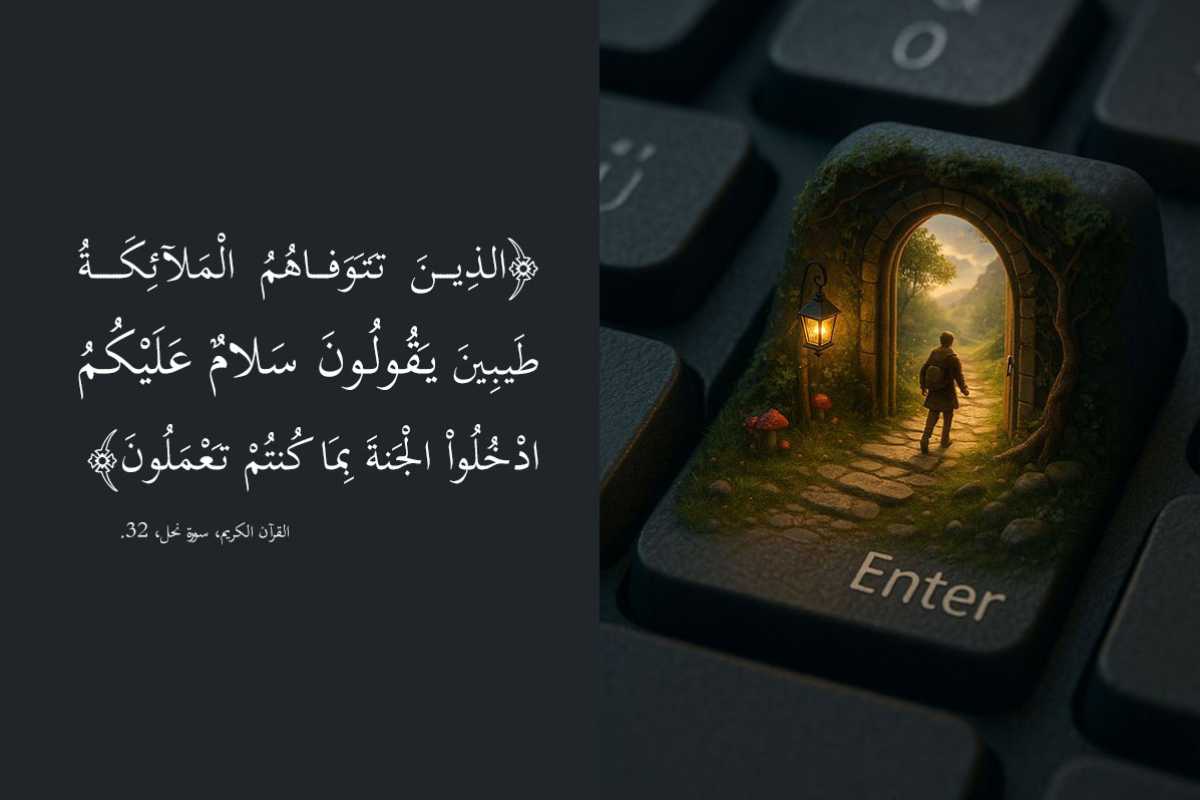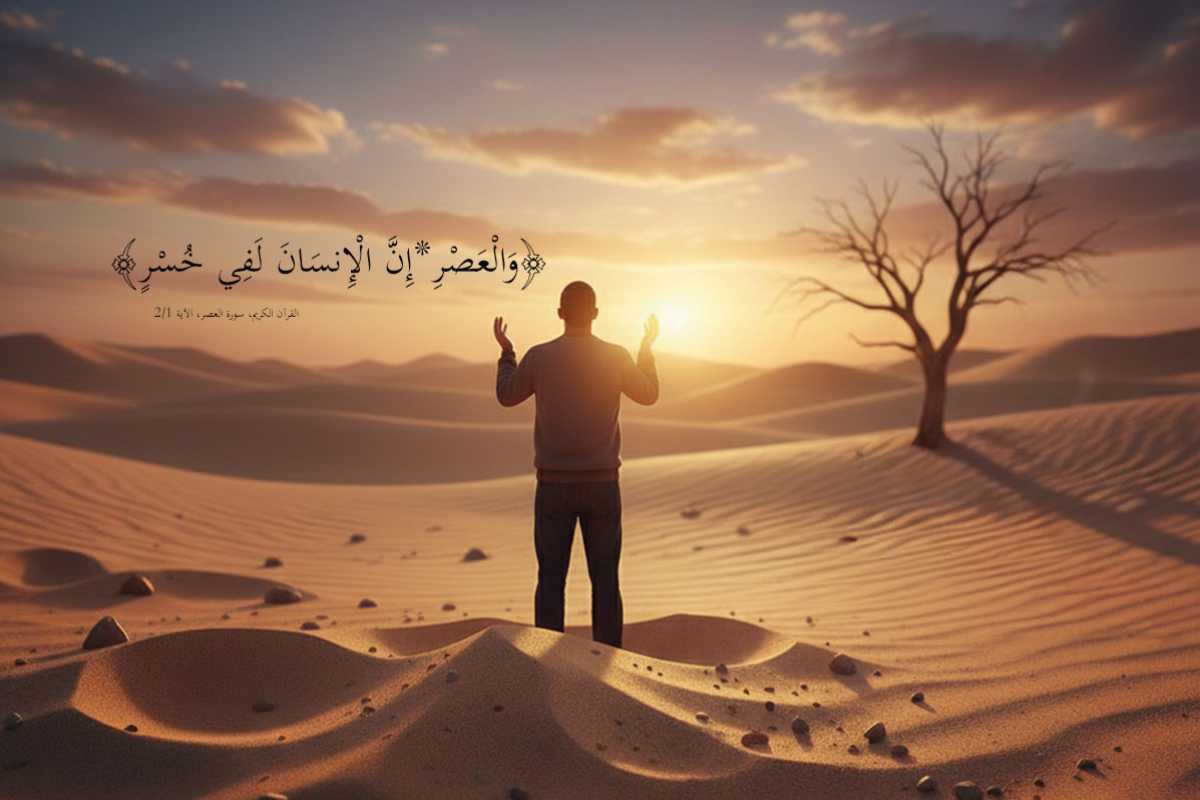نظرية الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
لا يوجد قراءة واحدة للدِّيمقراطيَّة، بل يوجد عدة رؤى إلى مقولتها. وما ورد، في شأن عدم الانسجام الذاتيّ بين الإسلام وبينها، يستند إلى نظرة خاصّة لها، أي "الديمقراطيَّة التعدُّديَّة". وبالتأكيد، فإنّ مثل هذا التفسير لها لا ينسجم مع الإسلام،
عدد الزوار: 378لا يوجد قراءة واحدة للدِّيمقراطيَّة، بل يوجد عدة رؤى إلى مقولتها. وما ورد، في شأن عدم الانسجام الذاتيّ بين الإسلام وبينها، يستند إلى نظرة خاصّة لها، أي "الديمقراطيَّة التعدُّديَّة". وبالتأكيد، فإنّ مثل هذا التفسير لها لا ينسجم مع الإسلام، ولا مع أيّ مذهب يرى الأُمور حقّاً وصواباً، ويبتعد عن التَّشكيك والنسبيَّة. فللدِّيمقراطيَّة عدّة تفاسير، ولا يستند بعضها إلى المبنيين المذكورين في الاستدلال السابق. على سبيل المثال: الاتّجاه الّذي يرى الدِّيمقراطيَّة مجرّد أُسلوب لتداول السلطة السِّياسيَّة، ومنهجاً ناجحاً في إدارة شؤون المجتمع، لا يرى أنّها تقوم على أساس الانتخاب المطلق وتعدُّديَّة المعرفة.
فالدِّيمقراطيَّة، بوصفها أسلوباً، يمكن حصرها في نطاق معيّن مفاده أنّها أقرَّت بعض المباني والمبادئ الخاصّة بوصفها حقّاً وصواباً، ومن ثمَّ تصدّت إلى العمل في إطار حفظ هذه المبادئ والمباني. وفي ظلّ هذا التصوّر للدِّيمقراطيَّة تحقَّق ما يأتي:
أوَّلاً: أُقصيت النِّسبيَّة والتَّعدُّديَّة المعرفيَّة بصورة تامّة، لأنّنا اعتقدنا بصحّة ذلك الإطار.
ثانياً: انتخاب الأفراد ليس مطلقاً، بل مقيَّدٌ، لأنّ الأفراد، في ظلّ هذه النَّظرة للديمقراطيَّة، لا يستطيعون انتخاب ما يتناقض مع ذلك الإطار من المبادئ والأُصول المقرّرة ويخالفه. وبناءً على ذلك، فهذا التصوّر للدِّيمقراطيَّة ليس له أيّ توقُّف واعتماد على المبنيين (الانتخاب المطلق والتعدُّديَّة المعرفيَّة) المذكورين.
ومن المصادفات التَّاريخيَّة، طبعاً، أن تتبلور الدِّيمقراطيَّات اللِّيبراليَّة في ضوء هذا التصوّر. فلم تكن اللِّيبراليات الأُولى، إبّان بداية طرح الدِّيمقراطيَّة واعتبار انتخاب الأكثريَّة، تستسيغ ذلك، لأنّها كانت تخشى أن يؤول رأي الأكثريَّة إلى القضاء على الأُصول والمبادئ اللِّيبراليَّة. فاللِّيبراليون شديدو التمسّك والإيمان بمبادئ اللِّيبراليَّة، من قبيل: احترام الملكيَّة الفرديَّة، وحريَّة التجارة، والسوق الاقتصاديَّة الحرّة، والتساهل والتسامح، والحرِّيات الدِّينيَّة، وحريَّة الفكر والبيان. ومن هنا، أرادوا حشر الدِّيمقراطيَّة ضمن إطار هذه الأُصول والمبادئ، بالشكل الّذي لا يستطيع رأي الأكثريَّة إقصاء بعضٍ منها. وبناءً على ذلك، ليس من تعارض بين الاعتقاد بأحقِّيَّة اللِّيبراليَّة وتقاطع أُصولها ومبادئها مع الدِّيمقراطيَّة، ويمكن تقييد الدِّيمقراطيَّة، بوصفها منهجاً، في إطار الأُصول والأُسس اللِّيبراليَّة، والتَّحدّث، من ثمَّ، عن اللِّيبراليَّة الدِّيمقراطيَّة.
فإن يكن الأمر كذلك، فما الضَّير في أن نحصر الديمقراطيَّة المنهجيَّة في إطار الأُصول والمبادئ الإسلاميَّة، ونقول بالرجوع إلى آراء الشَّعب في تعيين الزَّعامات السِّياسيَّة، ليقوم الشعب بانتخاب ممثِّليه إلى مجلس النوَّاب. أمّا منتخبو الشعب، فلا يحقّ لهم سنّ القوانين واتّخاذ القرارات الّتي تتعارض مع التعاليم الإسلاميَّة. ورأي الأكثريَّة وانتخاب الشعب يحظيان بالاحترام ما داما لا يمسَّان حدود الأُطر العقديَّة.
وبناءً على ذلك، فكما تحدِّد اللِّيبراليَّة الدِّيمقراطيَّةَ ضمن أُصولها ومبادئها، فإنّ الإسلام هو الآخر يؤطِّرها بأُسسه ومبادئه، ما يعني أنَّه يمكن تكييف الدِّيمقراطيَّة والجمهوريَّة مع الإسلام.
والنِّظام السِّياسيّ للجمهوريَّة الإسلاميَّة أُنموذج عمليّ لهذا التَّكييف. فدستور الجمهوريَّة الإسلاميَّة صرّح بحاكميَّة الشعب، وجمهوريَّة النِّظام، ولزوم اعتماد آراء الشعب في تداول السلطة السِّياسيَّة، إلى جانب كون هذه الحاكميَّة مقترنة بالحاكميَّة الشَّرعيَّة ومرجعيَّة التعاليم الإسلاميَّة، وتالياً حاكميَّة الشعب في إطار الحاكميَّة الدِّينيَّة.
ولاية الفقيه والدِّيمقراطيَّة
أشرنا، في الدَّرس السَّابق، إلى النَّظريَّة الّتي تقول بعدم انسجام أُطروحة ولاية الفقيه مع الجمهوريَّة. وتقوم هذه النَّظريَّة على تحليل خاصّ لولاية الفقيه، وهو التحليل الّذي يعدُّ ولاية الفقيه من باب القيمومة والولاية على القاصرين والمحجور عليهم. فهذه النَّظريَّة ترى أنّ الجمع بين نظام ولاية الفقيه والدِّيمقراطيَّة هو جمع بين النقيضين، والدستور الإيرانيّ الّذي جمع بين الجمهوريَّة وولاية الفقيه عانى من مشكلة منطقيَّة عويصة، ذلك لأنّه جمع بين متناقضين ومتعارضين تماماً:
يُنتخب مجلس خبراء القيادة في الجمهوريَّة الإسلاميَّة من قبل الشَّعب، ومعنى الرُّجوع لرأي الأكثريَّة يتمثَّل في أنّ الشعب، في خاتمة المطاف، هو الّذي يعيِّن القائد ووليّ الأمر، وهو الشعب نفسه الّذي يمثِّل في نظام ولاية الفقيه الصِّغار والمجانين الّذين فُرض، حسب المصطلح الفقهيّ والحقوقيّ والقضائيّ، أنّه "مولّى عليه". فإن كان المولّى عليه شرعاً أو قانوناً يستطيع تعيين وليّ أمره، فهو إذاً بالغ وعاقل ولم يعد مولّى عليه، ولا يحتاج لوليّ الأمر، ما يثير سؤالاً هو: كيف يتَّجه إلى صناديق الاقتراع وينتخب وليَّ أمره؟
وهكذا نرى أنّ أصل هذا الاستدلال بُني على التَّناقض بخصوص شأن الشَّعب ومنزلته في دستور الجمهوريَّة الإسلاميَّة، لأنّ الفرضيَّة المسبقة للجمهوريَّة والدِّيمقراطيَّة هي أنّ أبناء الشعب بالغون وأصحاب اختيار وانتخاب، ويمكنهم المشاركة في تعيين مصيرهم السِّياسيّ، فضلاً عن أنّ آراءهم الانتخابيَّة معتبرة. من جانب آخر، نجد الفرض المسبق لولاية الفقيه، هو أنّ الشعب مولّى عليه وغير رشيد، ويحتاج إلى قيّم وولي في إدارته لأُموره، ما يعني أنَّه يتعذَّر الجمع بين هذين الفرضين المسبقين، حيث يستحيل أن يكون الشعب رشيداً ومختاراً، وفي الوقت نفسه غير رشيد ومولّى عليه. وعلى أساس هذا التحليل، فإنّ الجمع بين الجمهوريَّة والديمقراطيَّة مع ولاية الفقيه في الدستور جمع لمتناقضين.
الرَّدّ على شبهة التَّناقض
مصدر شبهة التَّناقض بين ولاية الفقيه والجمهوريَّة والدِّيمقراطيَّة، ناشئ من سوء فهم تفسير ولاية الفقيه. فقد تبيّن، في الدَّرسين الخامس عشر والسَّادس عشر، أنّ ولاية الفقيه ليست من نوع الولاية على المحجور عليهم والقاصرين، بل من نوع ولاية النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام. وعلى أساس هذا التفسير الواقعيّ لولاية الفقيه، يتّضح أنّ الفرض المسبق لولاية الفقيه ليس أنّ الأُمّة محجور عليها وغير رشيدة. وبناءً على ذلك، لا توجد مشكلة بين الجمهوريَّة ورأي الشعب من هذه الناحية. ويبدو من المناسب ـ ونحن نصل إلى اختتام بحث الحكومة الدِّينيَّة والدِّيمقراطيَّة ـ أن نشير إلى أنّ الدِّيمقراطيَّة، وإن كانت مقبولة في ميدان الحياة السِّياسيَّة والاجتماعيَّة، فإنَّه لا ينبغي الاستغراق في إيجابياتها، ذلك لأنّ هذه الظاهرة، وبخاصَّة المنهج حديث الظهور منها، تواجه العديد من المخاطر وتعرف الكثير من الآفات، نشير هنا إلى بعضها.
آفات الدِّيمقراطيَّة
يتمثَّل أساس الدِّيمقراطيَّة وجوهرها في مشاركة الشَّعب والاستفادة من آرائه واقتراحاته في إدارة المجتمع ومختلف شؤونه وميادينه. غير أنّ العديد من الحكومات المعاصرة الّتي تعدُّ نفسها ديمقراطيَّة ابتعدت ـ ولأسباب كثيرة ـ عن هذا الهدف. وما يجري اليوم، في هذه الحكومات، هو في الحقيقة صورة باهتة للدِّيمقراطيَّة، ولا يعبّر عن ديمقراطيَّة واقعيَّة. فالديمقراطيَّة أصبحت تعني، فقط، أنّ بإمكان النَّاس الموافقة على الأشخاص الّذين سيحكمونهم أو رفضهم، وأنّ الّذين يمارسون السُّلطة في الحقيقة والواقع هم السِّياسيون.
إحدى الآفات والمعضلات المهمّة للدِّيمقراطيَّة، في جميع أشكالها وصورها، تعود إلى دور الشعب. فأبناء الشعب يتعاطون عادةً مع القضايا السِّياسيَّة والاجتماعيَّة بشكل غير مسؤول. فالنَّاس يمارسون في أُمورهم الشخصيَّة، من قبيل: الزواج وشراء البيت وأثاث المنزل والسيارة، منتهى الدِّقَّة، ويبذلون قصارى جهدهم لاختيار الأفضل، بينما يعتمدون روح التساهل والتَّسامح في القضايا الاجتماعيَّة والسياسيَّة، فالمنتخبون عموماً ضعاف عادة، ولا يبذلون قدراً كافياً من الدقَّة في انتخابهم. ومن هنا، فلديهم الوضع المساعد على تلقّي الضربات والهزّات العاطفيَّة والدعاويَّة والاستعداد لتقبّل تأثير القوى الداخليَّة والخارجيَّة.
الآفّة الأُخرى تتمثَّل في استغلال الأحزاب والسَّاسة المتزايد لوسائل الإعلام والدعاية، ما جعل أصالة تأثير الشعب في توزيع السُّلطة السِّياسيَّة والإشراف الجماهيريّ على النظام تتعرّض لأخطار جديَّة. فإنّنا لا نواجه، في عالم السِّياسة (إرادة عامّة وشعبيَّة أصيلة)، بقدر ما نصطدم بـ "إرادة مصطنعة ومزيَّفة". فالإرادة العامَّة، في الدِّيمقراطيات المعروفة، أصبحت مجيّرة، وتحوَّلت إلى نتيجة لأنشطة دعايات وسياسات فئات معيّنة، بدلاً من أن تكون عنصراً أساساً وعاملاً يحرّك عجلة السِّياسة. ويقول هربرت ماركوز: "إنّ الإعلام والدعاية يخلقان، لدى الشعب، نوعاً من الشُّعور الكاذب، بمعنى إيجاد وضع لا يتسنَّى للشعب فيه إدراك مصالحه الواقعيَّة"( ).
ولعلّ أبرز مشكلة وآفّة للدِّيمقراطيات المعاصرة هي أنّ طبقة كبار التجَّار وأصحاب المصالح الاقتصاديَّة الكبيرة، بوصفها تمثِّل النُّخب الاجتماعيَّة، تهيمن على القرار السِّياسيّ، بالإضافة إلى سيطرتها الخفيَّة على اقتصاد المجتمعات. إنّ جميع الأحزاب والفئات السِّياسيَّة المنظمة تتأثَّر نوعيَّاً بهذه الاستقطابات الاقتصاديَّة العملاقة، وتتبنَّى، في أغلب الموارد، متطلّبات أصحاب النفوذ الاقتصاديّ. وفي اللِّيبراليات الديمقراطيَّة الحاليَّة، فإنّ مشاركة الشعب في أنشطة الدَّولة وقراراتها يتمُّ، بقدر كبير، نيابياً، ومن طريق الممثّلين. ويتم اختيار هؤلاء النوابّ من دون دقّة كافية من قبل الشعب، وتحت طائلة تأثير أساليب الدعاية والتوجيهات غير المنظورة للزَّعامات الاقتصاديَّة، وتالياً ستكون مهمَّة هؤلاء النُّوابّ، بصورة طبيعيَّة، وبالدَّرجة الأساس، حماية مصالح الفئات الاقتصاديَّة المتواطئة معها ودعمها.
* الحكومة الإسلامية (دروس في الفكر السياسي الإسلامي)، جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
2025-03-31