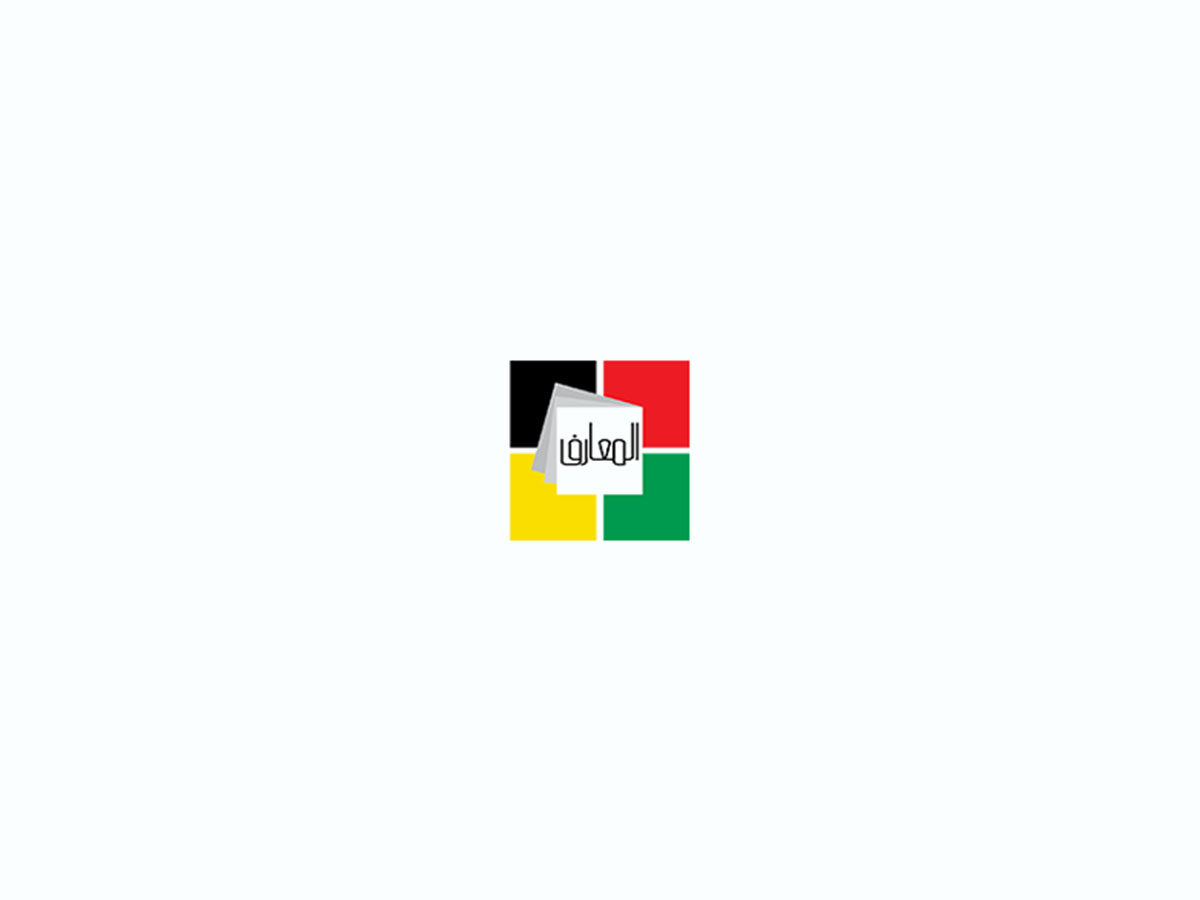القرآن وعصمة النبي عن الخطأ والسهو
قد عرفت منطق العقل في لزوم عصمة النبي من الخطأ في مجال تطبيق الشريعة ، ومجال الأُمور العادية المعدّة للحياة ، وهذا الحكم لا يختص بمنطقه ، بل الذكر الحكيم يدعمه بأحسن وجه ، وإليك ما يدل على ذلك :
عدد الزوار: 1050
قد عرفت منطق العقل في لزوم عصمة النبي من الخطأ في مجال تطبيق الشريعة ، ومجال
الأُمور العادية المعدّة للحياة ، وهذا الحكم لا يختص بمنطقه ، بل الذكر الحكيم
يدعمه بأحسن وجه ، وإليك ما يدل على ذلك :
1. قال سبحانه : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾[
النساء : 105] ، وقال أيضاً : ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ
لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ
وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِكْمَةَ
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾[
النساء : 113].
وقد نقل المفسرون حول نزول الآيات وما بينهما من الآيات روايات رووها بطرق مختلفة
نذكر ما ذكره ابن جرير الطبري عن ابن زيد قال : كان رجل سرق درعاً من حديد في زمان
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وطرحه على يهودي ، فقال اليهودي : والله ما سرقتها
يا أبا القاسم ، ولكن طرحت عليّ وكان للرجل الذي سرق جيران يبرؤونه ويطرحونه على
اليهودي ، ويقولون : يا رسولَ الله إنّ هذا اليهودي الخبيث يكفر بالله وبما جئت به
، قال : حتى مال عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ببعض القول فعاتبه الله عزّ
وجلّ في ذلك فقال : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ (1).
أقول : سواء أصحت هذه الرواية أم لا ، فمجموع ما ورد حول الآيات من أسباب النزول
متفق على أنّ الآيات نزلت حول شكوى رفعت إلى النبي ، وكان كل من المتخاصمين يسعى
ليبرئ نفسه ويتهم الآخر ، وكان في جانب واحد منهما رجل طليق اللسان يريد أن يخدع
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ببعض تسويلاته ويثير عواطفه على المتهم البريء حتى
يقضي على خلاف الحق ، وعند ذلك نزلت الآية ورفعت النقاب عن وجه الحقيقة فعرف المحق
من المبطل.
والدقة في فقرات الآية الثانية يوقفنا على سعة عصمة النبي من الخطأ وصيانته من
السهو ، لأنّها مؤلفة من فقرات أربع ، كل يشير إلى أمر خاص :
1. ﴿وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ
أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ
﴾.
2. ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِكْمَةَ ﴾.
3. ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾.
4. ﴿ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾.
فالأُولى منها : تدل على أنّ نفس النبيّ بمجردها لا تصونه من الضلال ( أي من القضاء
على خلاف الحق ) وإنّما يصونه سبحانه عنه ، ولولا فضل الله ورحمته لهمّت طائفة أن
يرضوه بالدفاع عن الخائن والجدال عنه ، غير أنّ فضله العظيم على النبي هو الذي صدّه
عن مثل هذا الضلال وأبطل أمرهم المؤدي إلى إضلاله ، وبما أنّ رعاية الله سبحانه
وفضله الجسيم على النبي ليست مقصورة على حال دون حال ، أو بوقت دون وقت آخر ، بل هو
واقع تحت رعايته وصيانته منذ أن بعث إلى أن يلاقي ربَّه ، فلا يتعدى إضلال هؤلاء
أنفسهم ولا يتجاوز إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهم الضالون بما هموا به
كما قال : ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾.
والفقرة الثانية : تشير إلى مصادر حكمه ومنابع قضائه ، وأنّه لا يصدر في ذلك المجال
إلاّ عن الوحي والتعليم الإلهي ، كما قال سبحانه : ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ وَالحِكْمَةَ ﴾ والمراد المعارف الكلية العامة من الكتاب والسنة.
ولما كان هذا النوع من العلم الكلي أحد ركني القضاء وهو بوحده لا يفي بتشخيص
الموضوعات وتمييز الصغريات ، فلابد من الركن الآخر وهو تشخيص المحق من المبطل ،
والخائن من الأمين ، والزاني من العفيف ، أتى بالفقرة الثالثة وقال : ﴿ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ ومقتضى العطف ، مغائرة المعطوف ، مع المعطوف عليه ، فلو
كان المعطوف عليه ناظراً إلى تعرّفه على الركن الأوّل وهو العلم بالأُصول والقواعد
الكلية الواردة في الكتاب والسنّة ، يكون المعطوف ناظراً إلى
تعرّفه على الموضوعات والجزئيات التي تعد ركناً ثانياً للقضاء الصحيح ، فالعلم
بالحكم الكلي الشرعي وتشخيص الصغريات وتمييز الموضوعات جناحان للقاضي يحلّق بهما في
سماء القضاء بالحق من دون أن يجنح إلى جانب الباطل ، أو يسقط في هوّة الضلال.
قال العلاّمة الطباطبائي : إنّ المراد من قوله سبحانه : ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ
تَكُن تَعْلَمُ ﴾ ليس علمه بالكتاب والحكمة ، فإنّ مورد الآية ، قضاء النبي في
الحوادث الواقعة ، والدعاوى المرفوعة إليه ، برأيه الخاص ، وليس ذلك من الكتاب
والحكمة بشيء ، وإن كان متوقفاً عليهما ، بل المراد رأيه ونظره الخاص (2). ولما كان
هنا موضع توهم وهو أنّ رعاية الله لنبيّه تختص بمورد دون مورد ، دفع ذلك التوهم
بالفقرة الرابعة فقال سبحانه : ﴿ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ حتى لا
يتوهم اختصاص فضله عليه بواقعة دون أُخرى ، بل مقتضى عظمة الفضل ، سعة شموله لكل
الوقائع والحوادث ، سواء أكانت من باب المرافعات والمخاصمات ، أم الأُمور العادية ،
فتدل الفقرة الأخيرة على تعرّفه على الموضوعات ومصونيته عن السهو والخطاء في مورد
تطبيق الشريعة ، أو غيره ، ولا كلام أعلى وأغزر من قوله سبحانه في حق حبيبه : ﴿
وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾.
2. قال سبحانه : ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة :
143] إنّ الشهادة المذكورة في الآية حقيقة من الحقائق القرآنية تكرر ذكرها في كلامه
سبحانه ، قال تعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلاءِ شَهِيدًا ﴾[ النساء : 41] ، وقال تعالى : ﴿
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾[ النحل : 84] ، وقال تعالى : ﴿ وَوُضِعَ
الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ ﴾[ الزمر : 69] ، والشهادة فيها
مطلقة ، وظاهر الجميع هو الشهادة على أعمال الأُمم وعلى تبليغ الرسل كما يومي إليه
قوله تعالى : ﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ
المُرْسَلِينَ ﴾ [ الأعراف : 6] ، وهذه الشهادة وإن كانت في الآخرة ويوم القيامة
لكن يتحملها الشهود في الدنيا على ما يدل عليه قوله سبحانه حكاية عن عيسى : ﴿
وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ
أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المائدة :
117] ، وقال سبحانه : ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾[
النساء : 159] ، ومن الواضح أنّ الشهادة فرع العلم ، وعدم الخطأ في تشخيص المشهود
به ، فلو كان النبي من الشهداء يجب ألاّ يكون خاطئاً في شهادته ، فالآية تدلّ على
صيانته وعصمته من الخطأ في مجال الشهادة كما تدلّ على سعة علمه ، لأنّ الحواس لا
ترشدنا إلاّ إلى صور الأعمال والأفعال ، والشهادة عليها غير كافية عند القضاء ،
وإنّما تكون مفيدة إذا شهد على حقائقها من الكفر والإيمان ، والرياء والإخلاص ،
وبالجملة على كل خفي عن الحس ومستبطن عند الإنسان ، أعني ما تكسبه القلوب وعليه
يدور حساب رب العالمين ، قال تعالى : ﴿ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ
قُلُوبُكُمْ ﴾ [ البقرة : 225] ، ولا شك أنّ الشهادة على حقائق أعمال الأُمّة خارج
عن وسع الإنسان العادي إلاّ إذا تمسّك بحبل العصمة وولي أمر الله بإذنه ، ولنا في
الأجزاء الآتية من هذه الموسوعة بحث حول الشهداء في القرآن ، فنكتفي بهذا القدر في
المقام.
ثم إنّ العلاّمة الحجّة السيد عبد الله شبر أقام دلائل عقلية ونقلية على صيانة
النبي عن الخطأ ولكن أكثرها كما صرّح به نفسه ـ قدس الله سره ـ مدخولة غير واضحة ،
ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى كتابه (3).
أدلّة المخطّئة
إنّ بعض المخطّئة استدلّ على تطرّق الخطأ والنسيان إلى النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) ببعض الآيات غافلة عن أهدافها ، وإليك تحليلها :
1. قال سبحانه : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ
الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾
[الأنعام : 68].
زعمت المخطّئة أنّ الخطاب للنبي وهو المقصود منه ، غير انّها غفلت عن أنّ وزان
الآية وزان سائر الآيات التي تقدّمت في الأبحاث السابقة وقلنا بأنّ الخطاب للنبي
ولكن المقصود منه هو الأُمّة ، ويدل على ذلك ، الآية التالية لها قال : ﴿ وَمَا
عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام : 69] ، فإنّ المراد انّه ليس على المؤمنين
الذين اتقوا معاصي الله سبحانه من حساب الكفرة شيء بحضورهم مجلس الخوض ، وهذا يدل
على أنّ النهي عن الخوض تكليف عام يشترك فيه النبي وغيره ، وإنّ الخطاب للنبي لا
ينافي كون المقصود هو الأُمّة.
والأوضح منها دلالة على أنّ المقصود هو الأُمّة قوله سبحانه : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ
غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ المُنَافِقِينَ
وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء : 140].
والآية الأخيرة مدنية ، والآية المتقدمة مكية ، وهي تدل على أنّ الحكم النازل
سابقاً متوجه إلى المؤمنين وإنّ الخطاب وإن كان للنبي لكن المقصود منه غيره.
2. ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلاَّ أَن يَشَاءَ
اللهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي
لأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴾ [الكهف : 23 ـ 24] ، والمراد من النسيان نسيان
الاستثناء ( إلاّ أن يشاء الله ) ووزان هذه الآية ، وزان الآية السابقة في أنّ
الخطاب للنبي والمقصود هو الأُمّة.
3. ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَىٰ * إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ
الجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴾ [الأعلى : 6 ـ 7] ، ومعنى الآية سنجعلك قارئاً بإلهام
القراءة فلا تنسى ما تقرأه ، لكن المخطّئة استدلّت بالاستثناء الوارد بعده ، على
إمكان النسيان ، لكنّها غفلت عن نكتة الاستثناء ، فإنّ الاستثناء في الآية نظير
الاستثناء في قوله سبحانه ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجَنَّةِ
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ
عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ [هود : 108] ، ومن المعلوم أنّ الوارد إلى الجنّة لا
يخرج منها ، ولكن الاستثناء لأجل بيان انّ قدرة الله سبحانه بعد باقية ، فهو قادر
على الإخراج مع كونهم مؤبدين في الجنّة ، وأمّا الآية فالاستثناء فيها يفيد بقاء
القدرة الإلهية على إطلاقها ، وإنّ عطية الله أعني « الإقراء بحيث لا تنسى » لا
ينقطع عنه سبحانه بالإعطاء ، بحيث لا يقدر بعد على إنسائك ، بل هو باق على إطلاق
قدرته ، فلو شاء أنساك متى شاء ، وإن كان لا يشاء ذلك.
المؤلف : آية الله جعفر السبحاني، الكتاب أو المصدر: مفاهيم القرآن، الجزء والصفحة
: ج5 ، ص 321 - 328.
(1) تفسير الطبري : 4 / 172.
(2) الميزان : 5 / 81.
(3) مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار : 2 / 128 ـ 140.