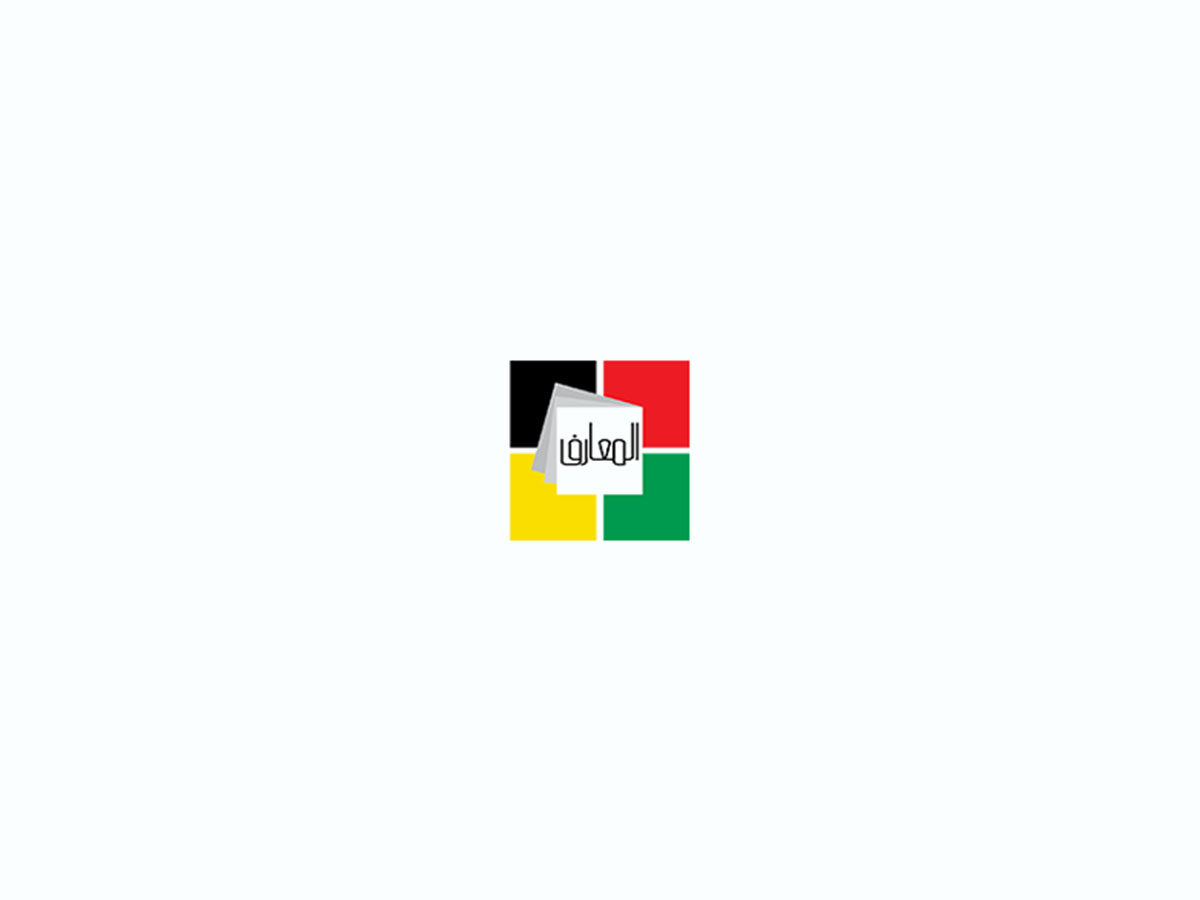الأدلّة العقليّة على مسألة العدل الإلهي
اعتقد أغلب علماء المسلمين بأنّ هذه المسألة من ناحية البعد العقلي هي فرعٌ من مسألة (الحُسن والقُبح)، لذا يتوجب علينا هنا متابعة هذه المسألة، وذكرنا عصارة منها هنا:
عدد الزوار: 1330
اعتقد أغلب علماء المسلمين بأنّ هذه المسألة من ناحية البعد العقلي هي فرعٌ من
مسألة (الحُسن والقُبح)، لذا يتوجب علينا هنا متابعة هذه المسألة، وذكرنا عصارة
منها هنا:
كان الأشاعرة (جماعة أبو الحسن الأشعري المدعو علي بن اسماعيل والذي كان من متكلمي
أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري) يُنكرون (الحسن والقبح) العقليين
بالمرّة، ويقولون: إنّ عقلنا ليس بقادر لوحده على إدراك الصالح والطالح، والحسن
والقبيح من الأشياء، ومعيار معرفتهما هو الشرع.
فما يستحسنه الشرع فهو حَسنٌ، وما يستقبحه فهو قبيح، حتى الأمور التي نعتقد اليوم
بحُسْنها وقُبحها، فإذا قال الشرع خلاف ما نعتقد لقلنا مثل قوله، حتى وإن سُئِلوا:
هل يُدرك العقل حُسْن العدالة والإحسان، وقبح الظلم والبخل، وقتل الأبرياء؟ لقالوا:
لا! فيجب الإستعانة فقط بتوجيهات الأنبياء وأولياءِ اللَّه.
وفي مقابل هؤلاء يقف (المعتزلة) و (الشيعة) الذين يعتقدون باستقلال العقل في إدراك
الحسن والقبح، فمثلًا يعتبرون حُسن الإحسان، وقبح الظلم من بديهيات حكم العقل.
طبعاً إنّهم لا يقولون: إنّ العقل قادرٌ على إدراك جميع المحاسن والمساوي، لأنّ
إدراكه محدود على أيّة حال، بل يقولون: إنّ العقل يدرك القسم الواضح جدّاً منها،
ويُعدّونها من المستَقلات العقليّة.
ذكر (فاضل القوشچي) ثلاثة معانٍ للحسن والقبح:
1- (صفة الكمال والنقص)، كقولنا: الِعلمُ حسنٌ، والجهل قبيحٌ، لأنّ العلم يمنح
صاحبه الكمال، والجهل يخلّف النقصان.
2- الحسن بمعنى (التنسيق مع المقصود)، والقبح بمعنى (عدم التنسيق مع المقصود).
هذا هو ما يُعبَّر عنه أحياناً ب (المصلحة) أو (المفسدة) فنقول: العمل الفلاني حسن
ومن ورائه مصلحة، أي يُقربنا أو يقرب المجتمع الإنساني من أهدافه، أو الأمر الفلاني
فيه مفسدة وقبيح، لأنّه يُبعدنا عن الأهداف الأساسيّة، سواءٌ كانت هذه الأهداف
ماديّة أو معنويّة.
3- الحسن بمعنى (الأمور المستحقّة للثناء والثواب الإلهي)، والقبح بمعنى (الأمور
المستحقة للتوبيخ والعقاب). ثم أضاف قائلًا: وموضع الشجار والنزاع بين الأشاعرة
والمعتزلة هو هذا المعنى الثالث (1) (2).
ولكن الحق هو أنّ هذه المعاني الثلاثة غير منفصلة عن بعضها، لأنّ الثواب والثناء
يعود إلى الأفعال والأعمال التي فيها مصلحة معينة، وتقرّب الإنسان إلى مراحل الكمال
طبعاً، كما هو حال الصفات الكمالية كالعلم الذي يُقرّب الإنسان من هذه الأهداف.
وعليه فإنّ هذه المعاني الثلاثة لازمة وملزومة ببعضها، وإن فرّق «فاضل القوشچي»
بينها فإنّما هو لتعبيد الطريق للإجابة على استدلالات جماعة (الحسن والقبح العقليين)،
فمثلًا يَرُدُ على استدلالهم هذا عندما يقولون: (نحن ندرك حسن الإحسان وقبح الظلم
بحكم ضرورة الوجدان). فيقول: إنّ هذا الكلام صحيحٌ بالمعنى الأول والثاني، وغير
صحيح بالمعنى الثالث.
لذا يُمكن القول في تعريف (الحسن والقبح) بأنّ الأفعال الحسنة هي الأفعال التي
تقرّب الفرد أو المجتمع البشري من الكمال المطلوب، أو تربّي فيه الصفات الكماليّة،
وتقرّبه من الأهداف التكاملية، ومثل هذه الأعمال فيها مصلحة طبعاً ومحببة من قبل
اللَّه سبحانه وتعالى وتستحق الثواب، وعكسها الأفعال القبيحة.
الآن وبعد أن عرفنا معنى (الحسن والقبح) والأراء المختلفة حول عقلانيتهما وعدم
عقلانيتهما، لننظر أيّاً منهما أحق من صاحبه.
لا ريب في أنّ الذهن الفارغ من تأثيرات هذا وذاك يعتقد إجمالًا بعقلانية الحسن
والقبح، ويبدو أنّ المنكرين كانوا قد خضعوا لتأثيرات مسائل اخرى أدّت بهم إلى
الوصول إلى هذه النتيجة (كالطريق المسدود الذي وصل إليه دعاة مسألة الجبر والتفويض
التي أشرنا إليها سابقاً)، والدليل على إثبات هذا الموضوع إجمالًا أمران:
أ) عندما نُراجع وجداننا نلاحظ أَنَّهُ حتى على فرض عدم ارسال اللَّه أيّ رسولٍ أو
نبي، تبقى مسائل الظلم والجور وإراقة دماء الأبرياء وسلب الأموال، وحرق بيوت
الأبرياء ونقض العهود وإثابة المسيء، من القبائح، وبالعكس، فالإحسان، التضحية،
الفداء، السخاء، مساعدة الضعفاء، الدفاع عن المضلومين، حسن وذو قيمة.
فنحن نعتقد بأنّ هذه الأعمال- التي ذكرناها أخيراً- ناشئة من صفات الكمال، وباتّجاه
أهداف المجتمع البشري وتستحق الثناء والثواب، في حين أنّنا نعتبر أعمال المجموعة
الأولى ناشئة من النقص، وتؤدّي إلى الدمار والفساد الفردي والاجتماعي وتستحق
التوبيخ والعقاب.
لذا فإنّ جميع العقلاء، حتى اولئك الذين لا يدينون بشريعة أو دين معين وينكرون جميع
الأديان، يعترفون بهذه الأمور، ويؤسسون نظامهم الاجتماعي (ولو في الظاهر) وفقها،
ويعتبرون أي نغمةٍ مخالفةٍ قد تظهر من زاويةٍ معينة، بأنّها حتماً ناشئة من (الأخطاء)
أو نوع من النزاع اللفظي واللعب بالألفاظ.
فأي عقلٍ يسْمح بأن نقتل جميع المحسنين والصالحين ونلقي بهم في البحر، ونفتح أبواب
السجون أمام الجناة والأشقياء ونمنحهم الحريّة ونسلّمهم مقاليد الأمور؟!
ب) إن أنكرنا مسألة الحسن والقبح لتزلزلت أسس جميع الأديان والشرائع السماويّة،
ولما أمكن إثبات أي دين، لأنّ من يُنكر الحسن والقبح عليه أن يقبل بكذب الوعود
الإلهيّة التي أعطاها اللَّه في جميع الأديان، وإن كان اللَّه قد قال: إنّ الجنّة
مأوى المحسنين، والنار مثوى المسيئين، فما المانع لو كان الأمر بعكس ذلك !؟
وكذّب اللَّه (العياذ باللَّه) في جميع هذه المسائل، ولا قباحة في الكذب !!
وكذا ما المانع من أن يجعل اللَّه المعاجز في تصرّف الكذّابين؟ ليخدعوا عباده
ويحرفوهم عن الطريق الصحيح !
وعليه فلا تبقى هنالك ثقة بالمعاجز، ولا بما يأتي به وحي السماء، إلّا أن نقبل
بقباحة هذه الأمور، ونزاهة اللَّه عن فعل القبيح، فتقوى الأسس الشرعيّة وتصير
المعجزة دليلًا على النبوة، ويصير الوحي دليلًا على بيان الحقائق.
(1) شرح تجريد القوشچي، ص 441.
(2) هنالك معنى رابعٌ للحسن والقبح والذي هو خارج عن بحثنا، وهو الحسن بمعنى موافقة
الطبع (الوجه الجميل) والقبيح بمعنى منافرة الطبع.
المؤلف: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الكتاب أو المصدر: نفحات القرآن، الجزء والصفحة: ج4، ص325- 328.
2016-02-02