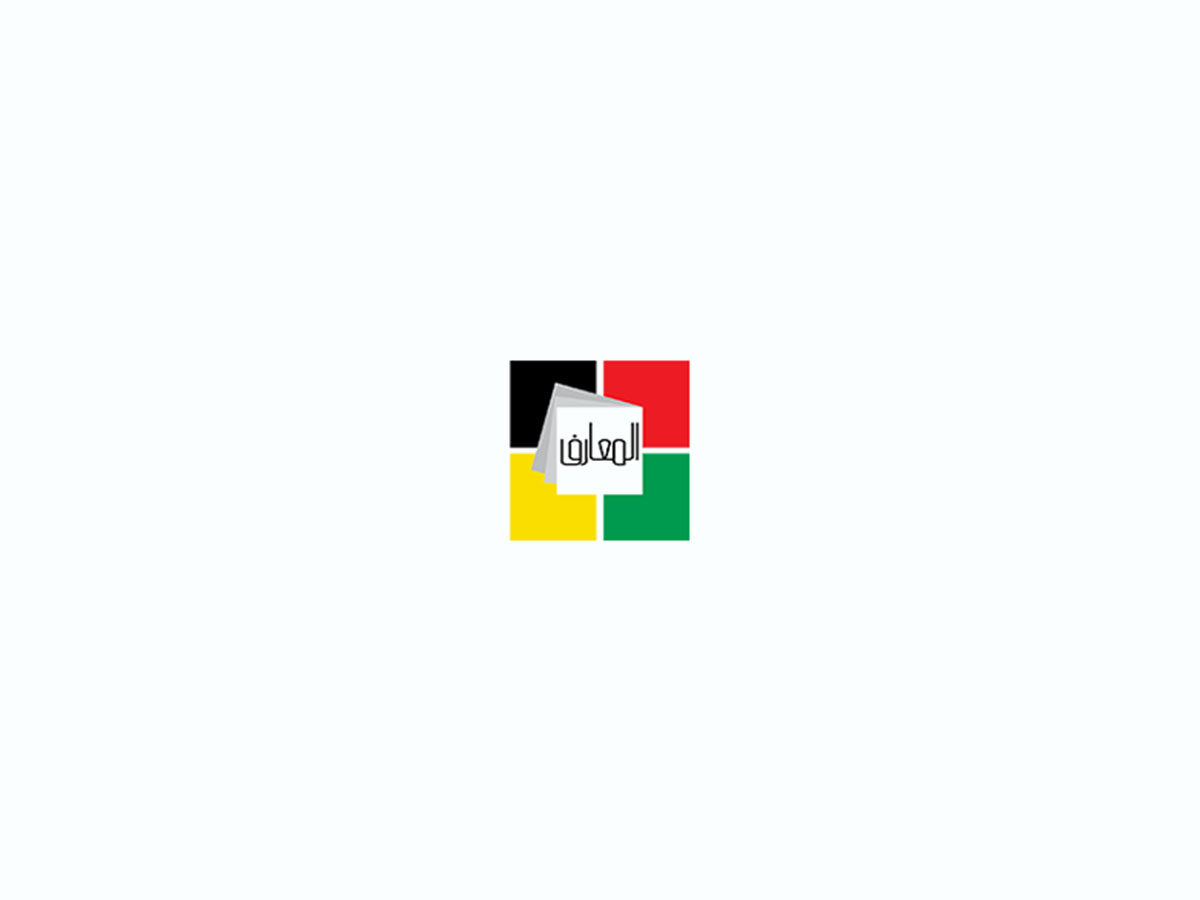إلقاء الرعب
إن من مظاهر تصرف الحق في القلوب، هو ما ألقاه من الرعب في نفوس المشركين بعد انتصارهم في غزوة أحد، فلم يكن بينهم وبين القضاء على الإسلام
عدد الزوار: 760
إن من مظاهر تصرف الحق في القلوب، هو ما ألقاه من الرعب في نفوس المشركين بعد
انتصارهم في غزوة أحد، فلم يكن بينهم وبين القضاء على الإسلام إلا قتل النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) ودخولهم المدينة واستباحة أهلها وإعادة الأمر جاهلية
أخرى..ولكن الحق قذف في قلوبهم ( الرعب ) وحال دون قيامهم بذلك كله، فقفلوا راجعين
- مع هزيمتهم للمسلمين - إلى مكة، وهم يقولون وكأنهم استيقظوا بعد سبات: "لا محمداً
قتلنا، ولا الكواعب أردفنا"..وهذا هو سبيل الحق في ( نصرة ) المؤمنين طوال التأريخ،
سواءً في حياتهم الخاصة، أو في معركتهم مع أعداء الدين.
التدّرج في دخول الحرم
إن الوضوء والأذان والإقامة بمثابة البرزخ بين ( النشاط ) اليومي، وبين (
الإقبال ) على الحيّ القيوم..فإن الذي يتدرج في دخول حرم كبرياء الحق، من مقدمات
وضوئه إلى أدعية ما قبل تكبيرة إحرامه، لهو أقرب إلى أدب الورود على العظيم من
غيره..وأما الذي يدخل الصلاة من دون الإتيان بهذه المراحل، فكأنه دخل على السلطان
مباشرة غير ( متهيبٍ ) من الدخول عليه، ولا شك أن هذه الكيفية من الدخول، من موجبات
الحرمان أو عدم الإقبال.
آية المراقبة
إن من الآيات التي لو التفت إليها العبد لاشتدت ( مراقبته ) لنفسه، بل أشفق على
نفسه ولو كان في حال عبادة، هي قوله تعالى: "وما تكون في شأنٍ وما تتلو منه من قرآنٍ
ولا تعملون من عملٍ إلا كنّا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال
ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتابٍ مبين"..وكان
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا قرأ هذه الآية بكى بكاءً شديداً، لأنه يعلم
عمق هذا الشهود الذي لا يدع مجالاً للغفلة عن الحق..والملفت في هذه الآية أنها تؤكد
على حقيقة ( استيعاب ) مجال الرقابة الإلهية، لأيّ عملٍ من الأعمال، ولأيّ شأن يكون
فيه العبد.
مغالبة المكروه
إن تثاقل القيام بالعمل الصالح، وإن كانت كاشفة عن حالة ( سلبية ) في النفس
الميالة إلى اللعب واللهو، إلا أن مغالبة النفس لما تكره، مما يعزز من قصد القربة
إلى الحق..إذ أن العبد إنما يخشى عدم تحقق الإخلاص في مواطن ( الميل ) النفسي
كإقدامه على مقتضيات الغريزة بأقسامها، وأما ما فيه ( المنافرة ) للطبع فإنه أبعد
ما يكون عن الشوائب، وبالتالي يكون أرجى للقبول من جانب الحق المتعال..إن هذا
الاعتقاد بأن ما تكرهه النفس من الطاعة أقرب للإخلاص، يجعل العبد يبحث عن خصوص مثل
هذه الأعمال، ويتعمد الإتيان بها ليكون ذخراً له في يوم فقره وفاقته..ومن الملفت في
هذا المجال أن النفس لا تبقى تستشعر ذلك ( الثقل ) المعهود قبل القيام بالعمل، وذلك
عند شروعه في العمل أو تكراره له، وهذا هو السر في أن أهل القرب من الحق يستسيغون
الأعمال الشاقّة، التي كانت ثقيلة - حتى عليهم - في بدء سيرهم إلى الحق المتعال.
قبح الرّبا
إن من الذنوب الكبيرة التي فقد الخلق الإحساس بقبحها هو الرّبـا، فهم في
التعامل معه كمثل من فَـقَد عقله، وما أمكنه تمييز الحسن والقبيح، وهو ما يقتضيه
التعبير بـ ( يتخبطّه ) كما ورد في القرآن الكريم، فهو يسير بغير استواء وكأنه
ممسوس اختلت قوى تمييزه..ومن الملفت في هذا المجال أن الحق يهدد فاعله بإيذان الحرب
منه، ثم يتبع الحق نهيه عن الربا بقوله: "فاتقوا النار التي أعدت للكافرين"..فقد
هدد آكلي الرّبـا بالنار التي أعدت للكافرين، ومنه يعلم شدة عذاب آكل الربا الذي
يشترك - ولو في درجة منه - مع الكافر..وقد سئل الصادق (عليه السلام) عن قوله تعالى
( يمحق الله الربا )، وكيف أن ماله يربو، فقال (عليه السلام): "فأي محقٍ أمحق من
درهم الربا، يمحق الدين، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر"الميزان-ج2ص451.
قلب المفاهيم الخاطئة
إن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يتعمدون قلب المفاهيم الخاطئة في أذهان العباد،
ولو استلزم ذلك شيئاً من الشدة والقسوة في القول..فقد مرّ أمير المؤمنين (عليه
السلام) على قومٍ جلسوا في زاوية المسجد، فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون..فقال
(عليه السلام) بل أنتم المتأكلة، فإن كنتم متوكلين فما بلغ بكم توكلكم، قالوا إذا
وجدنا أكلنا وإذا نفدنا صبرنا..فقال (عليه السلام): "هكذا تفعل الكلاب عندنا، قالوا
كيف نفعل؟ فقال (عليه السلام) إذا وجدنا بذلنا، وإذا فقدنا شكرنا"المستدرك-ج2ص289.
شعب الخير والشر
إن طريق الخير طريقٌ ذو ( شعب ) يدل بعضه على بعض، فمن دخل في مجال الإحسان
انفتح له السبيل بعد السبيل، وكذلك في مجال العلم وفتح البلاد وإرشاد العباد وغير
ذلك..والأمر كذلك في الشر، فإن الشر بعضه دليل بعض، وكأنه سلسلة يشد بعضها
بعضاً..والشيطان إنما يطلب الزلل من العبد فيوقعه في شراكه، إذا رأى فيه ( قابلية )
الانسياق وراء الشر خطوة بعد خطوة..وقد رتّب القرآن الكريم عمل الشيطان من طلبه
لزلل العبد، على كسب العبد نفسه، فقال: "إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا"..ومن
ذلك يعلم أن الضلالة يكون مردّها إلى العبد نفسه، وإن استثمر الشيطان كسب العبد في
تحقيق الضلالة.
تواصل الغيث
إن ساعات الإقبال التي تتفق للعبد الغافل بين فترة وأخرى، كالمطر في الأرض (
القاحلة ) سرعان ما يجف بما لا يستنبت شيئاً من الحياة، خلافاً للخصبة من الأرض،
فإن كل قطرة غيث لها دورها في سرعة نمو ما فيها من البذور، ووفرة ما ينبت عليها من
الزروع..نعم إن من الممكن أن ( ينـقّي ) الغيث المتواصل الأرض من سبَخِها، وبالتالي
( يُعـدّها ) للزرع لو شاء ذلك صاحبها..وهكذا الأمر في النفوس التي تتعرض للنفحات
المتلاحقة، فإنها قد تكتسب قابلية الخصب بعد طول الجدب.
انكشاف حقيقة النفس
إن من أفضل منح الحق للعبد، أن يكشف له الحق عن حقيقة النفس البشريّـة، فيراها
- كما يرى بدنه - بكل عوارضها وما فيه صلاح أمرها وفسادها..ومن المعلوم أن من عرف
نفسه فقد عرف ربه، لأن شأن النفس التي ( أزيلت ) عنها الحجب أن تتعرف على خالقها،
ضرورة استعداد الشيء لمعرفة من به قوامه حدوثاً وبقاءً..ومما ينبغي معرفته في هذا
المجال، أن الحق ( يواجه ) النفس كمواجهته لكل عناصر الوجود، فكان من المفروض أن (
تنعكس ) هذه المواجهة المقدسة على كيان العبد، انعكاس النور في الماء الزلال، ولكن
وجود الموانع من الأكدار الداخلية والخارجية، هو الذي يمنع ذلك الانعكاس، رغم
استعداد القابل وفاعلية الفاعل..فإذا انكشفت حقيقة النفس - بفضل الحق - عرف العبد
داء نفسه ودواءها، إذ أن لكل نفس عوارضها الخاصة بها ودواءها المناسب لها، رغم
العلم بكليات العوارض وعلاجها.
خداع المادحين
إن من أعظم سلبيات المدح هو ( التفات ) الممدوح إلى نفسه وانشغاله بها فيما لو
كان واجداً لصفة المدح، وإصابته ( بالعجب ) والغرور الكاذب فيما إذا كان فاقداً
لها..ومن هنا ورد الذم بالنسبة للمدّاحين لأنهم يصورون ما لا واقع له، أو يبالغون
فيما له واقع..فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "احثوا التراب
في وجوه المداحين"البحار-ج73ص294..وإن النفس بطبيعتها تركن إلى تقييم الآخرين
ومديحهم، فقد يصدّق الممدوح - بعد طول تكرار - ما لم يكن ليصدق به..ولهذا يرى
السلطان نفسه واجداً لكثيرٍ من الكمالات الموهومة، وذلك لكثرة من حوله من (
المتزلّفين ) الذين يصورون له السراب ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.
التأثر فرع المسانخة
إن تأثر العبد تأثراً يحجبه عن الحق عند تعامله مع النساء بما لا يرضى منه الحق
المتعال، إنما هو فرع ( مسانخـته ) لتلك العوالم التي طالما شغلت قلوب الخلق، وإلا
فما هو السر في إعراضه عن جمال البنت الصغيرة، رغم أنها تجمع بين الأنوثة والجمال
؟!..والأمر في ذلك واضح يعود إلى ما قلناه من انتفاء السنخية والتجانس بينه وبين من
لا ينفعه جمالها، ولا يتسانخ مع أنوثتها..وعليه فلو أن العبد ( قيّـد ) نفسه بعدم
التفاعل المنهي عنه مع غير المحارم، لتحققت فيه عدم السنخية الواعية - وإن بقيت
الدوافع الغريزية بحالها - مما يرفع المقتضيات لكثيرٍ من الزلات، بدلاً من إيجاد (
الموانع ) التي لا دوام لها، أمام أمواج الشهوات العاتية.
معاشرة الصلحاء
قد يوفق العبد لمعاشرة صالحٍ من العباد، إلا أنه ينشغل بذات ذلك الصالح بما
يجعله ( حجاباً ) بينه وبين ربه، إذ يستغرق في حبه، ويسعى لجلب رضاه وإن لم يكن بحق،
كما يستوحش من إعراضه وغضبه ولو كان لانحراف مزاج، ويرى الابتعاد عنه كأنه ابتعاد
عن مصدر كل خير..وعندئذٍ يكون شأنه كشأن من ينظر إلى المرآة فيستحسنها ويستغرق في
التأمل فيها، لا شأن من ينظر بها ليستكشف من نفسه عيوبها وما فسد من أمرها..ولطالما
تسول له نفسه، فيرى ارتياحاً لمعاشرته وكأنه اتحد به وجوداً بملكاته الصالحة، فيكون
مَثَله كمَثَل من يسير في بستانٍ متنـزهاً فيظن أنه قد ملكها بما فيها، والحال أنه
سيفارقها بعد قليل ليعود إلى خلوته الموحشة، وعليه فإن مجرد ( مصاحبة ) الصلحاء لا
يكفي بنفسه لرقيّ درجات الصالحين، والشاهد على ذلك عدم استفادة الكثيرين من صحبة
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - بما أوتي من أعظم درجات التأثير- كالمنافقين
والغافلين من الأعراب وأشباههم.
عدم الأنس بالقرآن
طالما يحاول العبد إلزام نفسه بتلاوة آيات من كتاب ربه العزيز، إلا أنه يرى في
ذلك ( ثقلاً ) مرهقاً، يدعوه: إما للانصراف أو للتلاوة الساهية..ومن الملفت في هذا
المجال أنه لا يستشعر مثل هذا الثقل في قراءة أضعاف ذلك من كل غث وسمين، والحال أنه
يبذل الجهد ( المتعارف ) للقراءة في الحالتين، والذي يستلزم النظر بالعين، والقراءة
باللسان، والاستيعاب بالقلب..والسر في ذلك واضح وهو عدم وجود ( الأنس ) بين القارئ
والمقروء، للحجب الكثيفة التي أفقدته ذلك الأنس، ومن المعلوم أن هذا الأنس شرطٌ
لميل العبد إلى كل فعل ومنه القراءة والتأمل.. يضاف إلى ذلك عدم إحساسه ( بالانتفاع
) الفعلي عند تلاوة القرآن الكريم خلافاً لقراءاته الأخرى، والشاهد على ذلك أنه لا
يزداد إيماناً عند تلاوته..وعليه فكما أن ظاهر القرآن لا يمسه إلا المطهرون
بظواهرهم، فإن باطنه محجوب لا يمسه أيضا إلا المطهرون ببواطنهم، التي ارتفعت عنها
الأكـنّة، التي يجعلها الحق على قلوب الذين لا يؤمنون.
اختلاف المعاملتين
إن من الواضح في علاقة الأب مع ( أبنائه )، قبوله منهم القليل، وتجاوزه عنهم
الكثير، ولطالما يتحمل الأذى رادّا عليهم بالجميل..وهذا كله خلافاً لتعامله مع (
خادمه )، فإنه قد لا يغفر له زلّـة، ولا يرضى منه إلا بإتيان كل ما تحتمله
طاقته..وموجب التفريق بين المعاملتين لا يكاد يخفى على أحد، إذ أنه يربطه بالأول
رابط الحب و( العلقة ) الضاربة بجذورها في النفس والبدن، والثاني لا يربطه به إلا (
العقد ) الذي ينفسخ بعد أمدٍ، طال أم قصر..فلنرجع ونقول: إن علاقة الأولياء بالحق
المتعال أشبه ما تكون بالعلقة الأولى، في أنه يقبل منهم اليسير، بمقتضى محبته
الموجبة لسرعة الرضا، إذ انهم من حزبه المنتسبين إليه، خلافاً لغيرهم الذين لا
تربطهم به، إلا نسبة الخالقية والمخلوقية وما يرتبط بها.
الفرق بين الكف والانصراف
إن هناك فرقاً واضحاً بين (كفّ ) الصائم نفسه عن الطعام مع ميله الشديد إليه،
وبين ( انصراف ) نفس المفطر عن الطعام وعدم ميله إليه..فإن الأول يعطى ثواب
الصائمين دون الآخر، إلا أن الثاني مقدمٌ على الأول في عالم الترويض والمجاهدة..فلا
يبعد أن يكون الأثر التكاملي لانصراف نفس المفطر عن الطعام المباح، أشدّ من كف
الصائم نفسه عن الطعام على مضَضَ وإكراه..ولعل هذا هو السر في خروج خلق كثير من
الشهر الكريم، من دون كثير ( تغييرٍ ) في ذواتهم، فهم يُقبِلون على الطعام ليلاً
بأضعاف ما حرموا منه في النهار، وينتظرون خروج الشهر مع ما فيه من البركات، للتخلص
من قيد إمساك النفوس عن لذاتها.
الخطايا العابرة
إن صدور ( الخطايا ) من الجوارح، وتوارد ( الخواطر ) على القلوب لا يوجب اليأس
أبداً..فإن مَثَل هذه الخطايا والخواطر الطارئة، كمَثَل عابر السبيل في الطريق الذي
لا يكتسب عنوان عابره بمجرد عبوره فيه، إلا إذا استقر فيه واستوطنه..فإن الطريق
ينتسب إلى من اتخذه مقراً ومنـزلاً، وعليه فإن مجرد صدور المعصية عن جارحته أو
جانحته، لا يكفي لأن ( يتعنون ) العبد بعنوان يوجب له اليأس..إذ أنه كما أن نفسه
طريق لعابر الشر، كذلك فإنها طريق لعابر الخير، فلا يتعنون بعنوان غالب إلا عند
طغيان أحدهما على الآخر.
همّ خدمة الدين
إن المهتم بأمر الشريعة يحب أن يخدم الدين وأهله من أوسع أبوابه، فينتابه شيء
من ( التحيّر ) في اختيار السبيل الأصلح لذلك..والحال أن على خَـدَمة الدين - بشتى
صنوفهم - أن يتسلحوا بما يعينهم على فتح الميادين المختلفة التي أمر الحق بفتحها،
فمَثَله كمَثَل المقاتل الذي يتعلم فنون القتال، من دون أن يشترط على نفسه وعلى
غيره ( جبهة ) قتال بعينها، فهو يسلّم نفسه إلى وليّ أمره يوجهه أينما شاء..ومن
المعلوم أن القائد العادل ينظر إلى الجميع بنظرة واحدة - وإن اختلفت سعة فتوحاتهم،
ومقدار غنائمهم - ما داموا جميعاً في حالة واحدة من ( الاستعداد ) والإستنفار
لامتثال الأوامر..ولكنه مع ذلك كله، فإن المرء يتمنى - بمقتضى محبته للحق - أن يرى
الهدى الإلهي في أشدّ تألقه، متجلياً لنفسه ولنفوس الخلق، ولهذا يدعو ربه قائلاً: "اللهم
وفقني إذا اشتكلت علىّ الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها، وإذا تناقضت
الملل لأرضاها"دعاء مكارم الأخلاق.
تكريم وسيلة الخير
يأمر الأمام السجاد (عليه السلام) ابنه الإمام الباقر (عليه السلام)، بدفن
ناقته لئلا تأكلها السباع، إذ أنه حج عليها الإمام (عليه السلام) عشرين حجة لم
يضربها بسوط..وفي ذلك درس بليغ في أنه ما كان ( وسيلة ) لتحقق الخير، فإنه ( مستحقٌ
) للتكريم ولو كان حيواناً لا يعقل معنى التكريم وخاصة بعد الهلاك!..فكيف الأمر
بالعباد الصالحين الذين كانوا ولا زالوا سبباً لتحقق الخيرات عن قصدٍ والتفات ؟!..ومنه
يعلم عظمة الجرم فيمن أساء إلى أئمة الهدى (عليهم السلام) في عدم تكريمهم، بل
لإيذائهم وإدخال الوهن عليهم، كما وقع للإمام السجاد (عليه السلام) نفسه..فهو يكرم
ناقةً حج عليها، والقوم لم يكرموا ( أعـزّ ) الخلق على الله تعالى، وهم الذين بهم
قوام الحج وغيره من شرائع الإسلام.
زوال الأنس والشهوة
إن المرأة تطلب - عند معظم الخلق - إما للأنس بها، أو لقضاء وطر الشهوات
منها..ولكن مع تقادم الأيام، يخف الميل بداعي ( الشهوة ) نظراً لتكرر النظر إليها
في كل يوم بما يسلبها بهاءها في نفس الرجل، فإن البهجة إنما هي لكل جديد..فيبقى
جانب ( الأنس )، وهو أمر لا ثبات ولا ضمان له في حياة الزوجين، وذلك إما لوجود من
يأنس به الزوج من الرجال أو النساء، أو لإحساس الزوج بعلوه عن مستوى زوجته بما لا
يراها أهلاً لأن يؤنس بها، أو للرتابة في التعامل معها بما لا يرى الزوج معها وجوداً
لزوجته في نفسه وهي بجانبه، مما ييسّر السبيل لظلمها حقها بل للإعتداء
عليها..والحال أن الطريق إلى التخلص من ذلك كله، هو النظر إلى الزوجة على أنها من (
رعـيّة ) الإنسان، وأمانة مستودعة من جانب الرحمن، وهو مسؤول غداً عن رعيته وأمانته
يوم العرض الأكبر، إذ ينادى المنادي: "وقفوهم إنهم مسؤولون"..وقد ورد عن النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "ملعون ملعون، من ضيّع من يعول"البحار-ج103ص13.
وسيلة الوصول
إن العبد عندما يتخذ الدابة ( وسيلة ) للوصول إلى مقصدٍ من مقاصده، فإنه ( يذهل
) عن الاهتمام بذاتها وخاصة إذ انشغل بحديثٍ هادف مع من يردفه عليها..وهذا خلافاً
للساعة التي يعيش فيها شيئاً من الفراغ والبطالة، فتراه يقبل على دابته مهتماً
بأمرها، مراعياً لجزئيات شؤونها، ناظراً إليها كهدف، لا من خلالها كوسيلة..وهكذا
الأمر في المشتغل ( بالهموم ) الكبرى، فانه ينظر إلى متاع الدنيا - برمّـته - بما
أنه يحقق له تلك الهموم، لا بما انه أداة للاسترخاء المذهل عن تحقيق تلك الهموم.
مخزون القلق في النفس
يحاول المرء أن يتحاشى موجبات القلق في حياته، فيتجنب من أجل ذلك البيئة أو
الشخص أو المكان الذي يمكن أن يجلب له فساداً، أو يوجب له تشويشاً، ويظن أنه (
بتحاشيه ) هذا، يجلب لنفسه الراحة والاطمئنان..والحال أن في مخزون ذاكرته كمّـاً
كبيراً من الحوادث المقلقة والمثيرة لأحزانه، وهذه الخواطر المحزّنـة كافية لأن (
تنغّـص ) عليه عيشه، بمجرد تذكرها والتفاعل معها، ولو كان صاحبها في سياحة ممتعة أو
في روضة من الرياض..وعليه فإن من موجبات السعادة في الحياة الدنيا، أن يكون (
استحضاره ) للمعاني المختزنة في اللاشعور تحت رقابته الأكيدة، فلا يستحضر شيئا من
تلك الصور الذهنية ولا يتفاعل معها، إلا إذا رأي في ذلك خيراً ونفعاً..ومَثَل من
يعمل خلاف ذلك كمَثَل من يذهب للمحاكم، مسترجعاً ملفات خصومه التي انتهت أحكامها،
بل ومات أصحابها.
لزوم الإحساس بالغيرة
إن على المرء أن يعيش شيئاً من الغيرة والحمية على ( مكتسباته ) في عالم القرب
من الحق المتعال..وعليه فإذا رأي إقبالاً في نفسه على ما يوجب له الهبوط من عالمه
العلوي، أحسّ بما يشبه الغيرة المـنقدحة في نفس المرأة تجاه ضرتها..فهو لا يرضى من
نفسه التنقل بين من مثَلَهما كمثل الضرتين، فإن الالتفات إلى إحداهما لمن موجبات
سخط الأخرى كما هو واضح..فلو عاش العبد هذه الحقيقة بوضوح، وآثر عالم الهدى على
عالم الهوى، لانتباه شعورٌ ( بالكراهة ) الشديدة تجاه النفس وما تشتهيها، عند (
الاسترسال ) في الشهوات، كالكراهية الـمنقدحه في نفس المرأة عند الاهتمام
بضرّتها..وهذا من أفضل الروادع التي توجب استقامة العبد في الحياة.
جعل المودة ورفعها
كما أن الحق المتعال هو ( جاعل ) المودة في نفوس الأزواج فكذلك هو ( الرافع )
لها، فالجاعل المختار في جَـعْله هو المبطل لما جَـعَله أيضاً كما هو معلوم..وهذا
هو السر في انتكاس علاقات الأزواج بعد طول مودة وصحبة..فإن كثرة الذنوب منهما وظلم
أحدهما للآخر، بما يؤول إلى ظلم من تحت أيديهم من النفوس البريئة المولودة على
الفطرة، لمن أعظم موجبات سلب هذه المودة المجعولة، فيحل محلها البغض والنفور لأتفه
الأسباب بما يؤدي إلى الطلاق أو العيش المنغّـص..وواقع الأمر أن عنصر الألفة
والمودة مفتقدٌ في كثيرٍ من العلاقات الزوجية، وخاصة بعد مضي السنوات الأولى من
الزواج..وأما ما هو المتعارف مما يعتبره الخلق ( ألفةً ) ومودة، إنما هو حبٌ (
للتلذذ ) والاستمتاع، المستلزم لحب من يتلذذ بها، والشاهد على ذلك، إنقطاع تلك
الألفة بانتفاء التلذذ منها، أو العثور على من يتلذذ بها أكثر منها.
المسخ الباطني
إن من المعلوم ارتفاع عقوبة المسخ والخسف في أمة النبي الخاتم (صلى الله عليه
وآله وسلم) إكراماً لمن بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، فكان مثَلَه في هذه الأمة
كمثل البسملة للبراءة في أنهما لا يجتمعان..فلم نعهد انقلاب العباد إلى قردة
وخنازير كما في القرون السالفة، كما لم نعهد إمطار الأرض بالحجارة، وقلب الأرض
عاليها سافلها كما في قوم لوط..إلا أن هناك عقوبة أخرى شبيهة بتلك العقوبات وهي
المسخ في ( الأنفس )، والخسف في الأفئدة و( العقول )..وهو ما يتجلى لنا في حياة بعض
المنتسبين إلى الشريعة الخاتمة، فنرى (مسخاً ) واضحاً في النفوس يجعلها لا ترى
الصواب في العقيدة والعمل، ولا ترى المنكر منكراً، ولا المعروف معروفاً، بل ترى
المنكر معروفاً والمعروف منكراً..كما نرى ( خسفاً ) بيّناً في القلوب، لافتقاد
سلامتها في ترتيب طبقات القلب، منشؤه الخطايا العظام..ومن المعلوم أن أثر هذا الخسف
في القلوب، هو جهلها ما فيه رداها، وبغضها ما فيه حياتها.
الشرك في التعامل
إن من دواعي شرك العبد في التعامل الاجتماعي، هو الالتفات إلى ( الأغيار )،
توقعاً للفوائد أو دفعاً للأضرار..فتراه ينشط في الملأ ليفتر في الخلوة، وتراه يهتز
عند المدح الذي يقطع ببطلانه، ويضيق صدره بما يقطع بكذبه..فعلى العبد أن ينظر إلى
الأغيار الذين لم يتلبسوا بأيّ معنىً من معاني الإيمان والكمال، ثم يعلم أنه كما لا
قيمة للفرد منهم، فكذلك لا قيمة ( للجماعة ) منهم وإن كثرت، إذ أن الوجود الناقص لا
يكتسب الكمال بتعدده، كما أن الأصفار لا تنقلب إلى عدد صحيح بتكرّره..وهذا المعنى
تناولته النصوص الشريفة، فمنها ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:
"يا أبا ذر! لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس أمثال الأباعر، فلا يحفل بوجودهم
ولا يغيره ذلك، كما لا يغيّره وجود بعير عنده، ثم يرجع هو إلى نفسه فيكون أعظم حاقر
لها"البحار -ج72ص304.
الفساد المستحدث
يكثر الشكوى من كثرة مثيرات الشهوات في هذا العصر، الذي لم تعهد البشرية زماناً
قريناً له في ظهور أنواع الفساد، الذي ظهر في البر والبحر بل الفضاء..فلم يترك
مبتكرو الفساد طريقة إلا وقد استحدثوها في ( مسخ ) الإنسان إلى موجود لا يعلم في
الوجود غير التلذذ والاستمتاع، بما لا يقاس به استمتاع البهيمة التي يضرب بها المثل
في الشهوات..ولكن ما ذُكر لا يُـعدّ عذراً يعتذر به العبد يوم القيامة، بعدما منح
قوة ( التمييز ) بين الحسن والقبيح من جهة، وحرية ( الاختيار ) والإرادة من جهة
أخرى، وعظمة الجزاء الذي بُشّر به الثابتون في آخر الزمان من جهة ثالثة..وليُعلم أن
وجود الثلّـة الثابتة في قلب دائرة الفساد والإفساد، من أقوى ( الحجج ) على باقي
العباد يوم القيامة، إذ لا يمكنهم التذرّع بجبر البيئة والزمان، بعد وجود تلك
النماذج المشتركة معها في الزمان والمكان.
العجب من سلامة البدن
إن من موجبات العَجَب - وما أكثرها في هذا الوجود العجيب - هو بقاء الإنسان على
سلامة في أداء أعضائه لوظائفها المعقدة، ما يقارب القرن أو أكثر من الزمان، وما هو
إلا لحمٌ وعظم، ولو كان حديداً لتآكل..ومن المعلوم أن هذه السلامة في البدن - فضلاً
عن الروح - تتوقف على ( سلامة ) ملايين المعادلات في هذا الكيان، بأنسجته وعصبه
وإفرازاته المعقدة، كما تتوقف على ( انتفاء ) العوامل الخارجية الموجبة للعطب،
كالجراثيم القاتلة المبثوثة في الفضاء، والتي طالما عبرت الأبدان بسلام..فكيف لا
يستشعر العبد بعد هذا كله دقة الصنع المذهلة، التي تجعله ( يخشع ) بإكبار أولاً، ثم
( يخضع ) باختيار ثانياً، بما يوجب له الإحساس العميق بالعبودية المستوعبة لكل
أركان الوجود ؟!.
الـحُمقاء في الدين
إن ما يثير التحيّـر والتحسّر، هو هذا السعي الحثيث للعباد في شؤون دنياهم، إذ
أن ( ثلث ) حياتهم في اليوم والليلة، وقف على النشاط اليومي لكسب المال، لـيَمضي (
الثلثان ) الباقيان في صرف ذلك المال المكتسب في الاستمتاع والاسترخاء، وفيما لا
يُـعدّ زاداً للحياة الأبدية..أما السعي في ما يورث له سعادة الأبد، فلا موقع له في
نشاطهم، أو له موقع لا ( يعبأ ) به متمثل في صلاة لا يُـقبلون فيها بقلوبهم، ولا
تُغيـّر شيئاً من واقعهم..وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "يا
أبا ذر! لا تصيب حقيقة الإيمان، حتى ترى الناس كلهم حُـمقاء في دينهم، عقلاء في
دنياهم"البحار-ج77ص85.
الميل إلى طاعة خاصة
إن الميل إلى العبادة يشبه الميل إلى الطعام، فقد ( يميل ) طبع العبد إلى صنفٍ
من الطعام، بحيث لو قُـدّم له صنف آخر لما مالت نفسه إليه..فالأمر في العبادة كذلك،
إذ قد يميل العبد بمقتضى حالته - التي قد لا يعلم منشأ لها - إلى صنف خاص من الطاعة:
كالصلاة، أو القرآن، أو الدعاء، أو السعي في قضاء حوائج الخلق، أو كسب العلم النافع،
أو الخلوة مع نفسه..ولا ضير حينئذ في ( مراعاة ) ميله لصنف من صنوف الطاعة، لئلا
يقوم بالعمل على مضَضٍ وإكراه فلا يؤتي ثماره..بل أن من القبح بمكان، إتيان العبد
بالطاعة وهو ( كاره ) لها، لما فيها من الاستثقال غير المقصود لمن يطيع.
الدقة في تعامل المعصوم
إن أصحاب النبي والأئمة (عليهم السلام) كانوا يعيشون درجاتٍ متفاوتة من حيث (
استيعاب ) المعاني التي كانت تصدر منهم، وذلك نظراً إلى اختلاف ( القابليات )
الذاتية لهم، إضافة إلى اختلاف إيصال تلك القابليات إلى مرحلة الفعلية بالمجاهدة
العلمية والعملية..ومن هنا أيضاً اختلفت طبيعة تعاملهم (عليهم السلام) مع أصحابهم
بلحاظ اختلاف تلك الدرجات، فما كانوا يتوقعونه من أصحاب الطبقة العليا، لم يكونوا
يتوقعونه من أصحاب الطبقة السفلى..وهذا النص يعكس ( دقّـة ) تعامل المعصوم (عليه
السلام) مع مواليه، في ما يصدر منهم من قول ولو كان حقاً، وذلك عندما قال يونس بن
يعقوب للإمام الصادق (عليه السلام): لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم، أحب إليّ
من الدنيا بحذافيرها.. فقال (عليه السلام) بعدما تبـيّن الغضب في وجهه (عليه السلام):
"يا يونس قستنا بغير قياس، ما الدنيا وما فيها ؟!..هل هي إلا سدّ فورة أو ستر عورة،
وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة"تحف العقول-ص281.
زيارة الموتى
إن من موجبات الإنابة وحيازة الأجر كذلك، هي زيارة الموتى زيارة واعية، يراد
بها تذكير النفس ( بالمصير ) المحتوم الذي ينتظر جميع الخلق الذين لم يكتب لأحد
منهم الخلود، وهو ذلك اليقين الذي لم يُر مثله يقيناً، يخالطه الشك والتردد سلوكاً
وعملاً..فمن أفضل المشاعر التي تنتاب الزائر لهم، هو أن ( يفترض ) نفسه بأنه قد نزل
به الموت، ثم أذن له بالخروج من القبر بكفالة مضمونة، ليرجع أياماً إلى الدنيا
معوضاً عن تقصيره، مكتسباً شيئاً من الدرجات التي فاتته أيام حياته..فيا تُـرى كم
يبلغ ( حرص ) مثل هذا الميت المستأنف للحياة، وذلك في استغلال كل لحظة من لحظات
عودته إلى الدنيا، وخاصة إذا كانت قصيرة لا تقبل الإمهال والتمديد ؟!..ومن المعلوم
أن واقع الأمر كذلك، إذ كنا شبه أمواتٍ في أصلاب الرجال، ثم وُهِـبنا الحياة في هذه
الدنيا، لنرجع إلى ممات آخر والهاتف ينادي: "قم واغتنم الفرصة بين العدمين".
قطع العلائق
إن على طالبي الكمال الالتفات إلى أن العبد لو قطع كل تعلقاته بما سوى الحق،
وأبقى علقة واحدة، فإن تلك العلقة الواحدة كافية لأن تجعله متثاقلاً إلى الأرض، بما
يمنعه من الطيران في الأجواء العليا للعبودية..فإن مَثَله كمثل الطير المشدود إلى
الأرض، سواء كان ذلك ( الإنشداد ) بحبل واحد أو بحبال شتى، فالنتيجة في الحالتين
واحدة، وهي الارتطام بالأرض كلما حاول الصعود..ولهذا حذّرت النصوص القرآنية
والروايات المتعددة من الشرك: خفيّـه وجلـيّه، إذ أن الالتفات إلى غير الحق - ولو
في مورد واحد - لهو صورة من صور الشرك في التوجه والالتفات، وهو الذي يمثل روح
العبادة..ومن هنا يمكن القول - بقطع - أنه لا مجال ( للخلاص ) والكمال، إلا بإتباع
أسلوب ( المراقبة ) المستوعبة للجوارح والجوانح معاً، لنفي كل صور الشرك المهلكة
بجليّـها، والمانعة من التكامل بخفيّـها.
محطات الاستراحة
إن الحالات الروحية العالية التي تنتاب السائر إلى الله تعالى و( المتمثلة )
بالطمأنينة والارتياح والسكون، مما لا تتيسّر لأهل الدنيا في ملذاتهم، وهي بمثابة (
محطات ) استراحة للعبد وتشجيع له على إدامة السير.. ولكن ليس معنى ذلك، أن ( يركن )
إلى هذه الحالات، ويغتـرّ بها ويطلبها كهدف..فالأمر في ذلك كمن يمشي إلى سلطان
تنـثر له في الطريق الرياحين والزهور، فليس له الانشغال بالتقاطها، لتفوت عليه فرصة
اللقاء بالسلطان.
الهواجس والخواطر
إن مَثَل بعض الأخطاء التي قد لا ترقى إلى حد المعصية، كمَثَل النار التي
تستتبع دخاناً كثيفاً يحجب الرؤية ولو لم تحرق الدار، ومثالها الهواجس الانتقامية
أو الخواطر الشهوانية، إذ أنها قد لا تنتقل إلى الجارحة وبالتالي لا يقع العبد في
دائرة المعصية، إلا أن أثرهما واضح في ( حجب ) الرؤية الصحيحة للحقائق، والاتزان
النفسي في الأمور، فيعيش العبد بعدهما حالة من الانقلاب والغثيان الداخلي، يجعله
يفتقد التركيز في العبادة أو في ما يحسن التفكير فيه..ومن الواضح أن ترادف هذه
الحالات النفسية يجعلها تتعدى - ولو لم يشأ صاحبها - إلى الجوارح، فيغتاب مثلاً من
دون قصد، عند اشتداد ( الهواجس ) الانتقامية، وينظر إلى ما لا يحل له عند فوران (
الخواطر ) الشهوانية.
الغناء وتحريك الشهوات
إن هناك ارتباطاً واضحاً بين الغناء والشهوة، إذ أن الطرب في حكم ( الخمرة ) في
سلب التركيز وتخدير الأعضاء وخفّتها، ولهذا تعارف اجتماعهما في مجلس واحد، فترى
المشغول باستماع المطرب من الألحان، يعيش حالة من الخـفّة كالسكارى من أصحاب
الخمور..هذا السكر والطرب المتخذ من الغناء، يجعل صاحبه يعيش في عالم الأحلام
والأوهام الكاذبة، فيصور له ( متع ) الدنيا - ومنها متعة النساء - وكأنها غاية
المنى في عالم الوجود، ويصور له ( المرأة ) التي يتشبّب بها في الغناء، وكأن الوصل
بها وصل بأعظم لذة في الحياة، حتى إذ جاءه لم يجده شيئاً، ووجد الله عنده فوفاه
حسابه.
كمال الجنين والأرواح
كما أن الحق المتعال يوصل الجنين - بمشيئته وفضله - إلى كماله اللائق به،
فيصوّره في الأرحام كيف يشاء، ليخرجه من بطن أمه في أحسن تقويم، فكذلك للحق مشيئته
في إيصال ( الأرواح ) البسيطة إلى كمالها اللائق بها، لأنها نفحة من نفحاته، أرسلها
على هذا البدن الذي تولى تقويمه وتربيته..إلا أن العبد بسوء اختياره، لا يدع يد
المشيئة الإلهية لأن تعمل أثرها بما تقتضيه الحكمة البالغة، إذ: "مقتضى الحكمة
والعناية، إيصال كل ممكن لغاية"..فيعمل بسوء مخالفته على منع تلك الرعاية - التي
أخرجت منه بشراً سويا - من أن توصله إلى ( كماله ) المنشود، فيكون مَثَله كمَثَل
الجنين الذي آثر الإجهاض والسقوط من رحم أمه، ليتحول إلى مضغة نتنة، تلف كما تلف
الثوب الخَـلِق، فيرمى بها جانباً.
الارتياح بعد التفويض
إن على العبد المتوكل الذي ( فوّض ) أمره إلى بديع السماوات الأرض، أن يعيش
حالة من ( الارتياح ) والطمأنينة بعد ذلك التفويض، كالمظلوم الذي أوكل أمر خصمه إلى
محامٍ خبير، فكيف إذا أوكل أمره إلى السلطان الحاكم في الأمور كلها ؟!..ولهذا عندما
آثر أهل الكهف الاعتزال عمن يعبدون غير الله تعالى، أمروا بأن يأووا إلى الكهف، وما
الكهف إلا تجويف في جبل لا مجال للعيش فيه، إلا أن الحق المتعال يردف ذلك قائلاً: "ينشر
لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا"..وما حصل لهم من غرائب ما وقع في
التاريخ، إنما هو ( ثمرة ) لهذا التفويض والتوكل على من بيده الأسباب كلها.
حلول الغضب
إن الحق قد يغضب على عبد من العباد غضباً غير حالّ، ( تدفعه ) التوبة
والندامة..فيكون مَثَل غضبه تعالى، كسحابة عذابٍ أشرفت على قوم ثم رحلت عنهم، ولكن
( تتابع ) الذنوب واستهزاء العبد - عملاً - بغضب الحق، يوجب في بعض الحالات حلول
الغضب على العبد، كسحابة عذاب أفرغت ما في جوفها من العذاب..وحينئذ لك أن تتصور حال
هذا العبد البائس الذي يهدده الحق بقوله: "ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى"..وكيف يرجع
العبد بعد هذا ( الـهُويّ ) القاتل، إلى ما كان عليه قبل الهبوط، بعد أن حرم فرصة
التعالي بسوء اختياره ؟!.
موعد العفو العام
إن يوم الجمعة وليلتها، بمثابة موعد العفو العام الذي يصدره السلطان بين فترة
وأخرى، دفعاً ( لليأس ) من القلوب، ودعوة ( للمتمردين ) الذين لا يجرءون على مواجهة
الحق المتعال لقبح فعالهم..وعليه فلا بد للعبد من أن يُهيّـأ نفسه قبل يوم الجمعة
وليلتها، ليتعرّض لتلك النفحات الخاصة في ليلة الجمعة المتجلية عند السحر، ولنفحات
يومها المتجلية عند ساعة الغروب..ومن هنا نجد كثيراً من الأدعية التي تبدأ من غروب
شمس ليلة الجمعة، وتنتهي عند غروب شمس يوم الجمعة..وللشيطان سعيه في إلهاء العباد
بين هذين الحـدّين، والشاهد على ذلك ( تفرّغ ) الخلق للمعاصي في الفترة نفسها،
فيرتكبون فيها مالا يرتكبونه طوال أيام الأسبوع من الموبقات، مفوّتين على أنفسهم
هذه الفرصة من العفو التي لا تتاح لهم في كل وقت.
الموازنة في المستحبات
قد يتفق ارتياح العبد إلى لون من ألوان الطاعة المستحبة، ( فيستغرق ) فيها بما
يقدمه على الواجبات من الطاعات، والحال أن على العبد الملتفت لنفسه أن يزن الأمور
بموازينها، ويستقرأ مقارنات الطاعات ومقدماتها بل لواحقها، فكم من مستحب ( جـرّ )
عليه ضرراً بعنوان آخر لم يلتفت إليه، أو لم يود الالتفات إليه..ومعرفة ( مذاق )
الشارع في مجمل الشريعة، ضرورية لعدم الوقوع في مثل هذه المخالفات التي قد لا
يقصدها العبد..ومن أمثلة ذلك، نهي الأئمة (عليهم السلام) عن متعة النساء - رغم
رجحان أصله - لعناوين أخرى طارئة، كقوله (عليه السلام) لبعض مواليه: "لا تلحّ في
المتعة، إنما عليكم إقامة السنة، ولا تشتغلوا بها عن فُرُشكم وحلائلكم فيكْفُرن،
ويدعين على الأمرّين لكم بذلك، ويلعنوننا"البحار-ج103ص310..وكقوله (عليه السلام) في
مورد آخر: "هَـبُوا لي المتعة في الحرمين، وذلك أنكم تكثرون الدخول عليّ، فلا آمن
أن تؤخذوا، فيقال هؤلاء من أصحاب جعفر"البحار-ج103ص311.
حصن الصلاة
إن الالتزام بالصلوات الخمس وخاصة في ( أوقاتها )، وذلك في ( بيوت ) الله عزّ
وجل، وفي ضمن ( جماعة ) يقارنها شيء من ( الخشوع )، لمن أعظم موجبات حفظ العبد من
الزلات..فإن نفس الوقوف بين يدي الحق بشيء من التوجه والالتفات، لمن موجبات تعالي
النفس إلى رتبة لا يرى معها وقعاً للذائذ المحرمة في نفسه، فضلاً عن المعاصي
الخالية من تلك اللذائذ..أضف إلى الحماية الإلهية المتحققة لمن دخل ساحة كبريائه،
وحلّ في بيت من بيوته، واصطفّ في جماعة من الصالحين من بريته، فإن كل ذلك من موجبات
إمساك الحق بقلب العبد، لئلا يهوي في أيدي الشياطين..وقد ورد عن الإمام الصادق (عليه
السلام) أنه قال: "لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن، ما حافظ على الصلوات الخمس،
فإذا ضيعهن تجرأ عليه وأوقعه في العظائم"الوسائل-ج6ص433.
الموت أخو النوم
إن مما يستحب على العبد في حال منامه، أن يضطجع إلى جانبه الأيمن كهيئة المدفون،
مستقبلاً القبلة بمقاديم بدنه..وفي هذا تذكير نافع للعبد بافتراض نفسه ( كالميت )،
وخاصة أنه مقدم بعد قليل على ما يشبه الوفاة، بل هو أخو الموت، بل هو الموت الأصغر
بعينه، ولهذا يشكر العبد ربه على نعمة الحياة الجديدة بعد الاستيقاظ قائلاً: "الحمد
لله الذي أحياني بعد إذ أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي ردّ عليّ روحي لأحمده
وأعبده"..ومن المشاعر المؤثرة قبل النوم أن يقرأ أدعيته وكأنه ( مقبل ) على الموت
حقيقة، بل لعل الموت هو قَدَره في المنام كما قُدّر للكثيرين، فيكون هذا الشعور
أدعى للتوجه إلى الحق الذي لا تأخذه سِنَة ولا نوم، بما يجـنّبه تلاعب الشياطين به
في المنام.
الاختصاص بالبلاء والنعم
إن اختصاص البعض بشيء من ( النعم )، قد يوجب له الاختصاص بشيء من ( البلاء )..فعلى
أصحاب النعم في الفكر أو القلب أو البدن، من استغلال تلك النعم في سبيل مرضاة الرب،
لئلا تسلب من جهة، ولئلا توجب له البلاء من جهة أخرى، كضريبةٍ لكفران تلك
النعم..وهذا ما يقتضيه العدل في خلقه، إذ ما دامت الفرص وموجبات الرقيّ متفاوتة في
العباد، بحسب بلادهم وزمانهم، فإن من الطبيعي إعادة ( الموازنة ) وتقريب الفرص بين
العباد، ببث بعض البلايا المتناسبة مع الفرص المتاحة..هذا إضافة إلى التعويض بتيسير
الحساب لمن حرم بعض النعم، أو لم تُـتَح له الفرص المؤاتية.
الذكر بعد العبادة
إن القرآن الكريم يتناول الذكر ومشتقاته في أكثر من مائتي آية، مما يدل على
أهمية التذكر في استقامة سلوك العبد، إذ أن كل ( ماسوى ) الحق في حياته، لهو عنصر (
غفلة ) وإلهاء له عن الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال..ومن الملفت في هذا المجال أن
الحق يحث على الذكر في كل ( تقلبات ) العبد، فتارة يطالب العباد بذكره في موسم طاعة
كالحج، وخاصة بعد الإفاضة من عرفات فيقول: "فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند
المشعر الحرام"..وتارة في مواجهة العدو كقوله تعالى: "إذ لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا
الله كثيراً"..ويبلغ الأمر درجة من الأهمية، نرى معها موسى (عليه السلام) يطلب
شريكاً في أمره، قبل التوجه إلى فرعون وملإه، ويعلل ذلك بقوله: "كي نسبحك كثيرا
ونذكرك كثيرا"، بما يفهم منه أن التسبيح والذكر الكثير من أولـيّات اهتمام الأنبياء
في بدء رسالتهم بل في أثنائها، مع ما فيها انشغال بمواجهة طواغيت عصورهم.
ثبات المصيبة
قد يستغرب بادءوا الرأي، من استذكار المحبين لمصائب أئمة أهل البيت (عليهم
السلام)، الذين يتفاعلون معها وكأنها - بالنسبة لهم - مصائب جرت عليهم (عليه السلام)
قبل سنوات مضت..والسبب في ذلك هو عدم استيعابهم للأمر على حقيقته، فإن المواجهة بما
فيها من مصائب وآلام، إنما كانت بين ( جبهة ) الطاغوت وأولياء الحق، ولم تكن
المواجهة مواجهة شخص لشخص، لتزول آثارها بزوال أصحابها، ومن هنا يذكّر القرآن
الكريم بمصائب الأنبياء السلف (عليه السلام)، وكأنها باقية - حقيقة - على
فداحتها..وعندئذ نقول بأن مرور الأيام ومضي الدهور والأعوام، لم يغير شيئاً من
فداحة ما جرى بين أولياء الحق والباطل، فالشيء لم ينقلب عما وقع عليه بعد
وقوعه..أضف إلى أن المواجهة ( استمرت ) جيلاً بعد جيل، وكان لكل من الجبهتين
وارثهما، ووارث المآسي في هذا العصر هو بقية الماضين (عليه السلام)، الذي ينتظر
ساعة حسم هذا الصراع، الذي بدأ ولا ينتهي إلا على يديه الكريمتين.
النفس الحاكمة
إن مَثَل ( النفس ) في مملكة الوجود، ( كحاكمٍ ) أصمّ، أبكم، أعمى، بيده
المقدرات كلها، ولا يطلب إلا المزيد من الشهوات..وعليه فإن على من حوله من الوزراء
والرعية، أن يعاملوه بما يجنّبهم التبعات الفاسدة متمثلا: أولاً في تقليص قدراته،
وسلب ما بحوزته من عناصر اقتداره..وثانياً بعدم الاعتناء ما أمكن بأوامره
الباطلة..وثالثاً بالسعي إلى ترشيده وتفهيمه بخطورة موقفه..ورابعاً بتهديده من
مغبّة التمادي في ظلمه..وهكذا الأمر في النفس، فإن العقل وجنوده هم وزراء مملكة
الوجود، فطوبى لمن استبدل الحاكم الطالح، بمثل هذا الوزير الناصح ؟!.
العلماء هم أهل الخشية
إن القرآن الكريم يحصر الخشية من الله تعالى بعباده العلماء، فمن يرى نفسه في
زمرة العلماء أو يعتبره الخلق كذلك، ولا يجد في نفسه شيئا من هذه ( الخشية )، فما
عليه إلا أن يراجع حسابه بقلق واضطراب شديد، لئلا يعيش ( الوهم ) طول دهره، فيرى
أنه على شيء وليس بشيء..ومن المعلوم أن هذه الخشية لو تحققت في نفس صاحبها، لكانت
خشية مستمرة، إذ أنها من لوازم الصفة الثابتة، وإلا فإن الخشية المتقطعة قد تنتاب
غير العالم بما لا ثبات له في النفس، ومن المعلوم أن العلم الذي يحمله أهل الخشية،
هو نوع علمٍ يورث تلك الخشية مع اجتماع أسبابها الأخرى.
الطريق المغري
إن السائر في ساحة الحياة بأهوائها المبثوثة في كل جنباتها، كمثل من يسير في
طريق ( مزدحم ) بألوان المغريات في: مطعم أو مشرب أو جمال منظر، والحال أنه مأمور
بالوصول إلى مقصده في نهاية ذلك المسير..فالغافل عن الهدف قد يدخل كل ( مُدخَل ) في
ذلك الطريق، لـيُشبع فضول نظره ويسد فوران شهوته، بما يجعله متشاغلاً طول عمره في
ذلك الطريق ذهابا وإيابا، غير واصل حتى إلى مقربةٍ من هدفه..وعليه فإن على العبد في
مثل هذه الحياة المليئة بزينة المغريات، أن ( يغض ) الطرف عن كثير مما يصده عن
السبيل ولو كان حلالاً، فإن الحلال الشاغل كالحرام في الصدّ عن السبيل..فأفضل المشي
ما كان على منتصف الجادة، بعيداً عن طرفيها بما فيها من فتن وإغراء.
مَثَل الذاكر باللسان
إن مَثَل من ينشغل عن الحق في صلاته، كَمَثل من يجلس إلى جليس تثقل عليه
محادثته، فيتركه بين يدي آلة تحدثه، ويذهب هو حيث الخلوة بمن يهوى ويحب..فإن بدنه
الذاكر في الصلاة، بمثابة تلك ( الآلة ) المتحدثة، التي لا تلتفت إلى مضامين ما
تتحدث عنها، وإن روحه المشتغلة بالخواطر المذهلة، بمثابة ( المنصرف ) عن ذلك
الجليس، والمتشاغل عنه بمن يحب ممن هو أقرب إلى نفسه من ذلك الجليس..ولنتصور قبح
مثل هذا العمل لو صدر في حق ( عظيم ) من عظماء الخلق، فكيف إذ صدر مثل ذلك في حق
جبار السموات والأرض ؟!.
النشاط الصادق والكاذب
تنتاب العبد حالة من ( النشاط )، منشؤه ارتياحٌ في البدن، أو إقبالٌ لدنيا، أو
اكتفاءٌ بلذة أو بشهوة، أوجبت له مثل هذا الاستقرار والنشاط، ولكن هذا النشاط نشاط
( كاذب ) لا رصيد له، إذ أنه حصيلة ما لا قرار له، ولا يستند إلى مادة ثابتة في
نفسه، ولهذا سرعان ما ينقلب إلى كآبة وفتور، لأدنى موجبٍ من موجبات القلق والتشويش،
وهو ما نلاحظه بوضوح في أهل اللذائذ الذين تتعكر أمزجتهم بيسير من كدر الحياة..وهذا
كله بخلاف النشاط ( الصادق )، المستند إلى إحساس العبد برضا الحق المتعال، عند
مطابقة أفعاله وتروكه لأوامره ونواهيه، بما يعيش معه برد رضاه في قلبه..ولا غرابة
في ذلك، إذ كان من الطبيعي سكون النفس واستشعارها للنشاط الصادق، عند تحقيق مطلوبها
في الحياة، وأي مطلوب أعزّ وأغلى من حقيقة: "رضي الله عنهم ورضوا عنه".
* الشيخ حبيب الكاظمي
2016-01-22