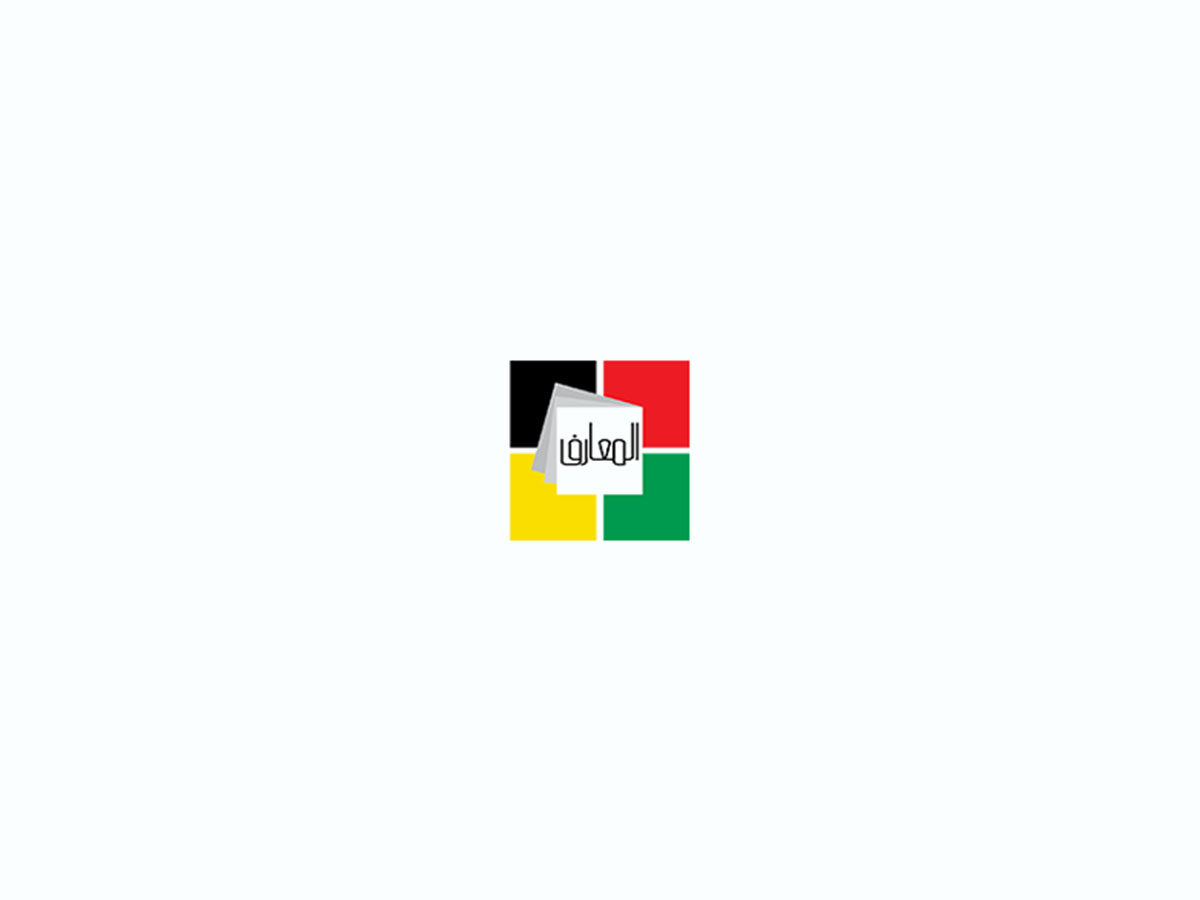النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في كلام الولي دام ظله
إنّ العمل المهمّ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الدعوة إلى الحقّ والحقيقة والجهاد في سبيل هذه الدعوة. ولم يُبتلَ النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأيّ تشويشٍ أو تردّد مقابل الدنيا الظلمانية في زمانه.
عدد الزوار: 1992
تمهيد
إنّ العمل المهمّ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الدعوة إلى الحقّ والحقيقة
والجهاد في سبيل هذه الدعوة. ولم يُبتلَ النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأيّ
تشويشٍ أو تردّد مقابل الدنيا الظلمانية في زمانه. سواءٌ في تلك الأيّام الّتي كان
فيها في مكّة وحيداً، أم في ذلك الجمع الصغير من المسلمين الّذين أحاطوا به وفي
مواجهة زعماء العرب المتكبّرين من صناديد قُريش وطواغيتهم، بجلافتهم وبكلّ اقتدارهم،
أم مقابل عامّة الناس الّذين يغطّون في سبات الجهل والجاهلية. فلم يستوحش. وقال
كلمة الحقّ وأعادها وبيّنها وأوضحها وتحمّل الإهانات واشترى كلّ تلك الصعاب والآلام
بالنفس حتّى تمكّن من أسلمة عدد كبير منهم.
أم في ذلك الوقت الّذي تشكّلت فيه الحكومة الإسلامية، وكان هو نفسه في موقع رئاسة
الحكومة، وكانت السلطة بيده. في تلك الأيّام أيضاً، كان هناك أعداءٌ ومخالفون
متنوّعون يواجهون النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، سواء تلك المجموعات العربية
المسلّحة - البدو المتفرّقون في صحاري الحجاز واليمامة1، والّتي كانت دعوة الإسلام
تريد إصلاحهم وهم يقاومون - أم ملوك العالم وسلاطينه - القوّتان العظميان في ذلك
الزمان - أي إيران والإمبراطورية الرومانية، الّذين كتب إليهم رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم وجادلهم وتوجّه إليهم وجيّش الجيوش نحوهم، وعانى الصعاب ووقع في
الحصار الاقتصاديّ، حتّى وصل الأمر إلى حد أنّه كانت تمرّ على أهل المدينة عدّة
أيّام أحياناً، لا يجدون فيها خبز يومهم. لقد كانت التهديدات الكثيرة من كلّ حدبٍ
وصوب تحيط بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم . كان بعض الناس يقلقون، وبعضهم
يتزلزلون، وبعضهم يتذمّرون، وبعضهم يلوم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ويحثّه على
التنازل، لكنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يتردّد أو يضعف في ميدان الجهاد
هذا، وتقدّم بالمجتمع الإسلاميّ بكلّ اقتدار حتّى أوصله إلى أوج العزّة والقدرة.
هذا هو النظام والمجتمع، الّذي استطاع ببركة صمود النبيّ في ميادين الجهاد والدعوة،
أن يصبح القوّة الأولى في العالم في السنوات الّتي تلت.(05/07/1370)
بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وإرساء قواعد النظام
بداية الصحوة
وكما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، في حديث مشهور ومتواتر، أنّه قال: "إنّما
بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق"2، فإنّ البعثة وُجدت في هذا العالم لأجل هذا الهدف، من
أجل تعميم المكارم الأخلاقيّة، والفضائل الروحيّة وتكميلها عند الناس.
وطالما أنّ المرء لم يتحلَّ بأفضل المكارم الأخلاقية، فإنّ الله تعالى لن يوكل إليه
هذا المهمّة العظيمة والخطيرة، ولهذا فإنّ الله سبحانه يخاطب النبيّ صلى الله عليه
وآله وسلم في أوائل البعثة قائلاً: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾3. أي أنّ
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان على درجة من الاستعداد تجعله قادراً على تلقّي
الوحي الإلهيّ، وهذا الأمر يعود إلى ما قبل البعثة. ولهذا فقد ورد أنّ النبيّ
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يشتغل بالتجارة في شبابه، وقد كسب من ذلك
أرباحاً طائلة، فما لبث أن أنفقها جميعاً على المساكين قربةً إلى الله تعالى.
وفي هذه المرحلة الّتي كانت نهاية تكامل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقبل نزول
الوحي - ولم يكن قد نبّئ بعد - كان النبيّ يعتزل في غار حراء ويجول بفكره في الآيات
الإلهية من سماء ونجوم وأرض، ويتأمّل في هذه الخلائق والموجودات الّتي تعيش على وجه
البسيطة بما لها من مشاعر مختلفة وطبائع شتّى. لقد كان يشاهد كافّة هذه الآيات
الإلهية فيزداد خضوعه يوماً بعد آخر أمام عظمة الحقّ، ويتضاعف خشوع قلبه أمام الأمر
والنهي الإلهيّين والإرادة الرّبانية، وتتفتّح في وجدانه، مع مرور الأيّام، براعم
الأخلاق النبيّلة. ولهذا فقد ورد أنّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كان أعقل
الناس وأكرمهم"4، حيث كان يزداد تكاملاً قبل البعثة بمشاهدة الآيات الإلهية حتّى
بلغ الأربعين، "فلمّا استكمل أربعين سنة ونظر الله عزّ وجل إلى قلبه فوجده أفضل
القلوب وأجلّها وأطوعها وأخشعها وأخضعها أذن لأبواب السماء ففُتحت، ومحمد ينظر
إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم"5، حتّى نزل عليه جبرائيل الأمين
وقال: ﴿اقْرَأْ﴾6 فكانت بداية البعثة.
إنّ هذا المخلوق الإلهيّ الّذي لا نظير له، وهذا الإنسان الكامل الّذي كان قد بلغ
تلك الدرجة من الكمال في هذه المرحلة قبل نزول الوحي، قد شرع منذ اللحظة الأولى من
البعثة في دخول مرحلة من الجهاد الشامل والبالغ المشقّة والمكابدة، استغرقت ثلاثاً
وعشرين سنة، وكل هذا كان نموذجاً للكفاح والمجاهدة والعمل الدؤوب. لقد كان جهاده
صلى الله عليه وآله وسلم جهاداً مع نفسه، ومع أناس لا يدركون من الحقيقة شيئاً، ومع
ذلك المحيط الّذي كان يعمّه ظلامٌ حالك ومطبق. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام في
نهج البلاغة في وصف ذلك: "في فِتَنٍ دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا، وَوَطِئَتْهُمْ
بأَظْلاَفِهَا، وَقَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا"7. لقد كانت الفتن تهاجم الناس من كلّ
جانب: حبّ الدنيا، واتّباع الشهوات، والظلم والجور، والرذائل الأخلاقية الّتي تقبع
في عمق وجود البشرية، وأيادي الطغاة الجائرة الّتي كانت تمتدّ على الضعفاء بلا أدنى
مانعٍ أو رادع. ولم يكن هذا التعسّف مقتصراً على مكّة أو الجزيرة العربية، بل كان
يسود أعظم الحضارات في العالم آنذاك، أي الإمبراطورية الرومانية العظيمة،
والإمبراطورية الشاهنشاهية في إيران. فإذا ما تأمّلتم في التاريخ لوجدتّم صفحة
تاريخية مظلمة كانت تضرب بأطنابها على كافّة نواحي الحياة الإنسانية.
لقد بدأ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جهاده منذ الوهلة الأولى للبعثة متسلّحاً
بقوّة خارقة، وسعيٍ متواصل يستعصي على التصوّر، فتحمّل الوحي، ذلك الوحي الإلهيّ
الّذي كان ينزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما ينزل الغيث العذب ويهطل
على الأرض الخصبة، فيمنحه الطاقة ويمدّه بالقوّة، فانبرى موظّفاً كلّ طاقته ليأخذ
بِيَد العالَم إلى زمن من التحّول العظيم، ولقد حالفه التوفيق.
إنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنى الخلايا الأولى لجسد الأمّة الإسلامية
بِيَده المقتدرة في تلك الأيّام العصيبة من تاريخ مكّة، فبنى قواعد الأمّة
الإسلامية ورفع عمادها، فكان المؤمنون الأوائل، وأوّل من اعتنق الإسلام، وأوّل من
كانت لديهم تلك المعرفة والشجاعة والنورانية الّتي مكنّتهم من الوقوف على حقيقة
الرسالة النبويّة والإيمان بها،﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ﴾8. لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الّذي لامس
بأنامله الرقيقة شعاع تلك القلوب الوالهة، وفتح بيده القويّة أبواب الأفئدة على
عالَمٍ رحبٍ من المعارف والأحكام الإلهية، فتفتّحت الأذهان والقرائح، وازدادت
الإرادات صلابة، ودخلت تلك الثلةّ المؤمنة - الّتي كان يزداد عددها يوماً بعد يوم -
في صراعٍ مريرٍ لا يمكن تصوّره بالنسبة لنا في المرحلة المكية. لقد تفتّحت هذه
البراعم في بيئة لم تكن تعرف سوى القيم الجاهلية، فكان يسودها العصبية الخاطئة،
ويعمّها الحقد العميق، وتتصارع بين جنباتها قوى القسوة والشرّ والظلم والشهوة الّتي
تضغط بشدّة على حياة البشر وتحيط بها من كلّ جانب، فنبتت تلك الغرسات وأينعت من بين
كلّ هذه الأحجار والأشواك الجامدة والملتفّة، وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين عليه
السلام : "وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أصلبُ عوداً، وأَقْوَى وَقُوداً"9.
ولذلك فإنّ كافّة العواصف والأنواء لم تستطع النيل من هذه النباتات والبراعم
والأشجار الّتي نمت وترعرعت وانبثقت أعوادها من بين الصخور الصمّاء، وانقضى ثلاثة
عشر عاماً، ثم ما لبث صرح المجتمع الإسلاميّ - المجتمع المدنيّ والنبويّ - أن قام
على أساس هذه القواعد القويّة.
العمل السياسي
لم تكن السياسة هي العنصر الوحيد في بناء هذه الأمّة، بل كانت تمثّل قسماً من هذه
العمليّة. والقسم الأساس الآخر فيها كان يتركّز على بناء الأفراد ﴿هُوَ الَّذِي
بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾10،
ومعنى﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل على تربية
وتزكية القلوب قلباً قلباً, كما كان يغذّي العقول عقلاً عقلاً، وذهناً ذهناً،
بالحكمة والعلم والمعرفة، ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، والحكمة
أعلى درجة ومكانة. فلم يكن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يعلّمهم القوانين
والأحكام فحسب، بل كان يعلّمهم الحكمة أيضاً، وكان يفتح عيونهم على حقائق الوجود.
وهكذا سار النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيهم لمدّة عشر سنوات. فمن ناحية كان
اهتمامه منصبّاً على السياسة وإدارة الحكومة والدفاع عن كيان المجتمع الإسلاميّ
ونشر الإسلام وفتح المجال أمام تلك الجماعات الّتي كانت تعيش خارج المدينة، أن
يدخلوا الساحة النورانيّة للإسلام وللمعارف الإسلامية، ومن ناحية أخرى كان يعمل على
تربية أفراد المجتمع. وهذان الأمران لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.
لقد اعتبر بعض الناس أنّ الإسلام مسألة فرديّة، وفصلوه عن السياسة. في حين أنّ نبيّ
الإسلام المكرّم صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الهجرة، ومن اللحظة الأولى الّتي
تمكّن فيها من النجاة بنفسه من مصاعب مكّة، فإنّ أوّل ما قام به هو السياسة. إنّ
إقامة المجتمع الإسلاميّ وتشكيل الحكومة والنظام والجيش الإسلاميّ، وإرسال الرسائل
إلى حكّام العالم الكبار، والدخول في معترك السياسة العظيم آنذاك، تُعدّ كلها من
شؤون السياسة. فكيف يمكن فصل الدين عن السياسة؟! وكيف يمكن إعطاء السياسة معنىً
ومضموناً وشكلاً بِيَد غير يد الهداية الإسلامية؟! ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ
عِضِينَ﴾11، ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾12. إنهم
يؤمنون بالقرآن، لكنهم لا يؤمنون بسياسته!﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا
بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾13. فما معنى القسط؟ إنّ القسط يعني إقرار العدالة الاجتماعية
في المجتمع. فمن الّذي يستطيع تحمّل هذا العبء؟ إنّ إقامة مجتمع يعمّه العدل والقسط
هو عملٌ سياسيّ يقوم به مدراء البلاد، وهذا هو هدف الأنبياء جميعاً. فليس الأمر
مقتصراً على نبيّنا فقط، بل إنّ عيسى وموسى وإبراهيم وجميع الأنبياء الإلهيين عليهم
السلام قد بُعثوا من أجل العمل السياسيّ وإقامة النظام الإسلاميّ.(31/05/1385)
النظام النموذجي للحكم
إنّ سيرة النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة السنوات العشر لحاكميّة
الإسلام في المدينة، تُعدّ من ألمع عهود الحكم طيلة التاريخ البشريّ، ولا نقول ذلك
جزافاً، وإنّما يجب التعرّف إلى هذا العهد القصير والمليء بالنشاط والّذي له تأثيرٌ
خارقٌ على تاريخ البشرية. إنّ المرحلة المدنيّة هي الفصل الثاني من عصر رسالة
النبيّ، الّذي امتدّ لـ 23 سنة. الفصل الأوّل، الّذي كان مقدّمةً للفصل الثاني، كان
عبارة عن 13 سنة في مكّة. أمّا السنوات العشر الّتي قضاها النبيّ صلى الله عليه
وآله وسلم في المدينة فهي تمثّل سنيّ إرساء قواعد النظام الإسلاميّ وبناء أنموذج
الحكم الإسلاميّ لجميع أبناء البشرية على مرّ التاريخ الإنسانيّ في مختلف الأعصار
والأمصار. وهذا الأنموذج الكامل، لا نجد له نظيراً في أيّ حقبة أخرى. وبمقدورنا من
خلال إلقاء نظرة على هذا الأنموذج الكامل تحديد المعالم الّتي بها ينبغي للبشر
وللمسلمين الحكم على الأنظمة وعلى الناس.
لقد كانت غاية النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من هجرته إلى المدينة هي مقارعة
الواقع السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ بظلمه وطاغوتيّته وفساده الّذي كان
مهيمناً على الدنيا آنذاك، ولم يكن الهدف مكافحة كفّار مكّة فحسب، بل كانت القضية
ذات بعد عالميّ أيضاً. كان النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يتعقّب هذا
الهدف، فكان يغرس بذور الفكر والعقيدة أينما وَجد الأرضية المساعدة لذلك، على أمل
أن تنبت تلك البذور في الوقت المناسب. وكانت غايته من ذلك إيصال رسالة الحريّة
والنهوض وسعادة الإنسان إلى كافّة القلوب. وذلك يتعذّر إلاّ عن طريق إقامة النظام
النموذجيّ القدوة. لذلك فقد جاء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لإقامة
مثل هذا النظام النموذجيّ. لكن إلى أي مدى تسعى الأجيال اللاحقة لمواصلة ذلك
والاقتراب من هذا النموذج، فذلك منوط بهممها ومساعيها.
فالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يبني النموذج ويقدّمه للبشرية والتاريخ. والنظام
الّذي شيّده النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان له الكثير من المعالم، أبرزها
وأهمّها سبعة:
المعْلَم الأوّل: الإيمان، فالدافع الحقيقي بالنظام النبويّ إلى الأمام هو الإيمان
المنبثق من قلوب الناس وعقولهم ويأخذ بأيديهم وكلّ كيانهم نحو طريق الصواب. إذاً
المعلم الأوّل يتمثّل في نفخ روح الإيمان وتقويته وترسيخه وتغذية أبناء الأمّة
بالمعتقد والفكر السليمين، وهذا ما باشره النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في مكّة
ورفع رايته في المدينة بكلّ اقتدار.
المعْلَم الثاني: العدل والقسط، فمنطلق العمل كان يقوم على أساس العدل والقسط
وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه دون أدنى مداهنة.
المعْلَم الثالث: العلم والمعرفة، فأساس كلّ شيء في النظام النبويّ هو العلم
والمعرفة والوعي واليقظة، فهو لا يحرّك أحداً في اتّجاهٍ معيّن حركةً عمياء، بل
يحوّل الأمّة عن طريق الوعي والمعرفة والقدرة على التشخيص، إلى قوّة فعّالة لا
منفعلة.
المعْلَم الرابع: فالصفاء والأخوّة، فالنظام النبويّ ينبذ الصراعات الّتي تغذّيها
الدوافع الخُرافية والشخصية والمصلحية والنفعية ويحاربها. فالأجواء هي أجواء تتّسم
بالصدق والأخوّة والتآلف والحميميّة.
المعْلَم الخامس: الصلاح الأخلاقيّ والسلوكيّ، فهو يزكّي الناس ويطهّرهم من رذائل
الأخلاق وأدرانها، ويصنع إنساناً خلوقاً ومزكّىً ﴿وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾14، فالتزكية هي أحد المرتكزات الأساس الّتي كان يستند
إليها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في عمله التربويّ مع أبناء الأمّة فرداً
فرداً لبناء الإنسان.
المعْلَم السادس: الاقتدار والعزّة: فالمجتمع والنظام النبويّ لا يتميّز بالتبعيّة
والتسوّل من الآخرين، بل يتميّز بعزّته واقتداره وإصراره على اتّخاذ القرار؛ فهو
متى ما شخَّص موطن صلاحه سعى إليه وشقّ طريقه إلى الأمام.
المعْلَم السابع: العمل والنشاط والتقدّم المطّرد: فلا مجال للتوقّف في النظام
النبويّ، بل الحركة الدؤوبة والتقدّم الدائم. ولا معنى لدى أبنائه للقول إنّ كلّ
شيء قد انتهى فلنركن إلى الدّعة! وهذا العمل - بطبيعة الحال - مبعث لذّة وسرور وليس
مدعاة للكسل والملل والإرهاق، بل هو عمل يمنح الإنسان النشاط والطاقة والاندفاع.
دعائم النظام النموذجي
قدِم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ليقيم هذا النظام ويعمل على
تكامله ويجعله أنموذجاً إلى أبد الدهر، ليقتدي به اللاحقون على امتداد التاريخ،
ممّن تتوفّر لديهم القدرة على إقامة نظام مماثل له، من أجل أن يزرعوا الاندفاع في
القلوب كي يحثّ بنو البشر الخطى نحو إيجاد مثل هذا المجتمع. وبديهيّ أن تحتاج إقامة
مثل هذا النظام إلى دعائم عقائدية وإنسانية، فلا بدّ:
أوّلاً: من وجود معتقدات وأفكار سليمة كي يقام هذا النظام على أساسها. وقد بيّن
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأفكار والرؤى في إطار كلمة التوحيد والعزّة
الإنسانية وسائر المعارف الإسلامية خلال فترة السنوات الثلاث عشرة الّتي أمضاها في
مكّة، ثم علّمها وفهّمها الآخرين بشكل متواصل وعلى مدى لحظات حياته حتّى وافاه
الأجل في المدينة، وكان على الدوام بصدد تعليم وتفهيم الجميع مثل هذه الأفكار
والمعارف الساميّة الّتي شكّلت أسس هذا النظام.
وثانياً: من الضروريّ وجود القواعد والدعائم الإنسانية كي يستقيم هذا البناء عليها،
وذلك يعود إلى عدم ارتكاز النظام الإسلاميّ على فرد واحد. وقد باشر النبيّ صلى الله
عليه وآله وسلم إعداد هذه الركائز في مكّة وحقّقها، فكان منهم مجموعة من كبار
الصحابة ــ على اختلاف مراتبهم ــ هم ثمرة الجهود المضنية والجهاد المرير خلال فترة
السنوات الثلاث عشرة في مكّة، فيما كانت هنالك مجموعة من الّذين تمّ بناؤهم في يثرب
بواسطة رسالة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وذلك قبل هجرته صلى الله عليه وآله
وسلم من قبيل سعد بن معاذ وأبي أيوب وغيرهما. وعندما حلّ النبيّ صلى الله عليه وآله
وسلم في المدينة، باشر، من لحظة دخوله إليها، عملية بناء الإنسان. ومع مرور الأيّام
أخذت ترد إلى المدينة شخصيّات تتّسم بجدارتها الإدارية وجلالة القدر والشجاعة
والتضحية والإيمان والاقتدار والمعرفة حتّى أصبحت أعمدةً صلبة لهذا الصرح الشامخ
الرفيع.
لقد كانت هجرة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة - الّتي كانت تسمّى قبل
حلوله فيها بـ "يثرب" ثم سُمّيت "مدينة النبيّ" بعد دخوله إليها - بمثابة نسائم
ربيع عمّت أجواء المدينة فشعر أهلها كأنّ انفراجاً حلّ فيهم جذب القلوب وأيقظها.
وحينما سمع أهل المدينة بوصول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبا- وهي على
مقربة من المدينة ومكث فيها خمسة عشر يوماً - كان الشوق لرؤيته يغلي في قلوبهم
يوماً بعد يوم، وكان بعضهم يتوجّه إلى قبا لرؤية النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ،
فيما بقي الآخرون ينتظرونه في المدينة. وعندما دخل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم
المدينة تبدّل ذلك الشوق وذلك النسيم إلى عاصفة ألهبت قلوب الناس فغيّرتها. وسرعان
ما نما لديهم الشعور بأنّ جميع ما لديهم من مبتنيات وعواطف وارتباطات وعصبيات
قبليّة قد ذابت بطلوع محيّا هذا الرجل وسلوكه ومنطقه، وأشرفوا على نافذة جديدة تطلّ
بهم على حقائق عالم الخلق والمعارف الأخلاقية. فكان أن أحدثت هذه العاصفة ثورةً في
القلوب بادئ الأمر، ثم امتدّت إلى تخوم المدينة، لتخرج فيما بعد إلى قلاع مكّة
وتسيطر عليها، وتنطلق في خاتمة المطاف لتشقّ طريقها إلى ما هو أبعد، فتتقدّم إلى
أعماق امبراطوريتي ذلك الزمان العظميين، وحيثما توجّهت كانت تهزّ القلوب وتحدث
ثورةً في باطن البشر. ففي صدر الإسلام فتح المسلمون بقوّة إيمانهم بلاد إيران
والروم، وأيّما قوم طالهم هجوم المسلمين كان الإيمان يداعب قلوبهم بمجرّد رؤيتهم
للمسلمين. كانت الغاية من السيف إزالة العراقيل عن الطريق، والقضاء على المتسلّطين
والمترفين. أمّا السواد الأعظم من الناس فقد استقبل هذه العاصفة في جميع الأمكنة،
فكان أن نفذ النظام والدولة الإسلامية إلى أعماق امبراطوريتي ذلك الزمان - أي إيران
والروم - فأصبحتا جزءاً من النظام والدولة الإسلامية. وكلّ ذلك حصل في ظرف أربعين
سنة، عشر منها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وثلاثون منها بعد رحيله.
لقد باشر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عمله بمجرّد أن حلّ في المدينة. ومن
العجائب الّتي حفلت بها حياته صلى الله عليه وآله وسلم هي أنّه، وطوال تلك السنوات
العشر، لم يهدر لحظةً واحدة، فلم يُرَ صلى الله عليه وآله وسلم ، غافلاً عن إنارة
مشعل الهداية والإيمان والتعليم والتربية ولو للحظةٍ واحدة؛ فلقد كانت يقظته ونومه،
ومسجده وداره، ودخوله ساحة الحرب، ومسيره في الطرقات والأسواق، ومعاشرته لأسرته،
وكلّ وجوده أينما حلّ، دروساً.
يا لها من بركة زخر بها هذا العمر! فالشخص الّذي شغل التاريخ برمّته وترك بصماته
عليه - ولقد قلت مراراً إنّ الكثير من المفاهيم الّتي اكتست وشاح القدسية على مدى
القرون التالية، من قبيل المساواة والأخوّة والعدالة والسيادة الشعبيّة، كلّها كانت
تحت تأثير تعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم . وفي تعاليم سائر الأديان، لم يكن من
وجود لمثل هذه الأمور، أو لنقل إنّها لم تبلغ منصّة الظهور مع أنّ نشاطه الحكوميّ
والسياسيّ والاجتماعيّ قد دام عشراً من السنين لا غير! فيا لها من حياة ميمونة! لقد
حدّد صلى الله عليه وآله وسلم موقفه منذ الوهلة الأولى لدخوله المدينة.
السلوك الاجتماعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
فلمّا دخلت ناقته يثرب أحاط بها الناس. وكانت يثرب يومها مقسّمة إلى أحياء تضمّ
بيوتاً وأزقّة ومتاجر، يعود كلّ منها إلى واحدة من القبائل التابعة إمّا للأوس أو
للخزرج... كانت الناقة تمرّ من أمام قلاع هذه القبائل فيخرج كبارها ويأخذون بركاب
الناقة منادين: إلينا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : "دعوا الناقة
فإنّها مأمورة"15. لكنّ كبار القوم وأشرافهم، شيوخهم وشبابهم اعترضوا ناقة النبيّ
صلى الله عليه وآله وسلم قائلين: انزل هنا يا رسول الله، فالدّار دارك، وكلّ ما
لدينا في خدمتك، لكنّه صلى الله عليه وآله وسلم ، كان يقول لهم: "دعوا الناقة
فإنّها مأمورة". وهكذا طوت الناقة الطريق حيّاً بعد حيّ، حتّى وصلت إلى حيّ بني
النجّار الّذين تنتمي إليهم أمّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وباعتبارهم أخوال
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جاؤوه وقالوا: يا رسول الله! إنّ لنا بك لقرابة
فانزل عندنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : "دعوا الناقة فإنّها مأمورة"، فانطلقت
الناقة حتّى حطّت رحالها في أكثر أحياء المدينة فقراً، فمدّ الناس أعناقهم ليعرفوا
مَنْ صاحب الدار الّتي حطّت عندها الناقة، فإذا به أبو أيّوب الأنصاريّ أفقر أهل
المدينة أو أحد أفقرهم. عمد أبو أيّوب الأنصاريّ وعياله الفقراء المعوزون إلى أثاث
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فنقلوه إلى دارهم وحلّ النبيّ صلى الله عليه وآله
وسلم ضيفاً عليهم16، فيما رُدّ الأعيان والأشراف وأصحاب النفوذ وذوو الأنساب
وأمثالهم، أي أنّه حدّد موقعه الاجتماعيّ، فاتّضح من خلال ذلك عدم تعلّق هذا الرجل
بالثروة والنسب القبليّ والزعامات القبلية والانتماء الأسريّ والعائليّ وعدم
ارتباطه بالمتحايلين الوقحين ولن يكون كذلك. فهو صلى الله عليه وآله وسلم حدّد منذ
الوهلة الأولى طبيعة سلوكه الاجتماعيّ، وأيّاً من الفئات يساند، ولأيّ من الطبقات
ينحاز، ومَنْ هم الّذين سينالون القسط الأوفر من فائدة وجوده... فالجميع كانوا
ينتفعون من وجود النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليمه، بيد أن الأكثر حرماناً
كان أكثر انتفاعاً منه، دافعهم في ذلك هو التعويض عن حرمانهم.
كانت قبال دارة أبي أيوب الأنصاريّ قطعة أرض متروكة فسأل صلى الله عليه وآله وسلم
عن صاحبها، فقيل إنّها ليتيمين، فدفع لهما ثمنها واشتراها ثمّ أمر ببناء
مسجد عليها، كان بمثابة مركز سياسيّ عباديّ اجتماعيّ وحكوميّ ومركز يتجمّع فيه
الناس؛ حيث اقتضت الضرورة بناء مركز يمثّل المحورية، ومن هنا تمّت المباشرة ببناء
المسجد. ولم يطلب صلى الله عليه وآله وسلم قطعة أرض من أحد أو يستوهبها، بل اشتراها
بأمواله، وبالرغم من عدم وجود محام عن هذين اليتيمين فإنّ النبيّ صلى الله عليه
وآله وسلم راعى الدقّة في أداء حقوقهما كاملة تامّةً كالأب والمدافع عنهما. وعندما
باشروا بناء المسجد، كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من أوائل المسلمين، أو
أوّلهم، الّذين أمسكوا بالمعول وباشروا حفر أرض المسجد. ولم يكن عمله هذا رمزياً،
بل كان عملاً حقيقياً بحيث كان العرق يتصبّب منه صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان
عمله بالمستوى الّذي أثار بعض الّذين تنحّوا جانباً، فقالوا: أنجلس والرسول يعمل؟!
فلنذهب ونعمل، فجاؤوا وانهمكوا في العمل حتّى شيّدوا المسجد خلال برهة وجيزة. وبذلك
أثبت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم -ذلك القائد العظيم والمقتدر- أنّه لا يرى أيّ
حقّ لشخصه، فإذا ما كان هنالك عمل فلا بدّ أن تكون له مساهمة فيه.
ثمّ إنّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وضع الأطر الإدارية والسياسية لذلك النظام. ولو
أنّ المرء ألقى نظرة على التطوّر الّذي خطاه بذكاء وفطنة، لأدرك أيّ عقل وفكر ودقّة
وحنكة تقف وراء تلك العزيمة القاطعة والإرادة الصلبة الّتي لا يمكن تحقّقها ظاهراً
إلاّ برفد من الوحي الإلهيّ. وحتّى يومنا هذا، إنّ الّذين يحاولون تتبّع وقائع تلك
السنوات العشر خطوةً خطوة يعجزون عن استيعاب أيّ شيء. وإذا ما حاول المرء دراسة كلّ
واقعة على حدة فإنّه لا يدرك منها شيئاً، بل عليه أن يدقّق النظر ويلحظ تسلسل
الأعمال وكيفية إنجاز كلّ تلك المهامّ بتدبير ووعي وحسابات دقيقة.
تمثّلت الخطوة الأولى في إرساء الوحدة، فلم يدخل أهل المدينة بأجمعهم الإسلام. إلا
أنّ أكثرهم اعتنق الإسلام، فيما بقيت قلّة منهم خارج إطار الإسلام. كما أنّ ثلاثة
من قبائل اليهود المهمّة كانت تقطن المدينة، أي في القلاع الخاصّة بهم المحاذية
للمدينة، وهي قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. هذه القبائل كانت قد جاءت
إلى المدينة قبل قرن أو قرنين من ذلك التاريخ، وقصّة مجيئهم إلى المدينة هي قصّة
طويلة لها تفاصيلها، وعند دخول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كانت
لهؤلاء اليهود ثلاث مزايا:
أوّلها: سيطرتهم على الثروات الأساس في المدينة، وعلى أهمّ مزارعها وتجارتها
ومنافعها، وعلى أهمّ صناعاتها الّتي تدرّ الأرباح وهي صناعة الذهب وغيرها. وكان
الغالبية من أهل المدينة يرجعون إليهم لسدّ حوائجهم والاستقراض منهم وتسديد الربا
إليهم، أي أنّهم كانوا يقبضون على كلّ شيء من الناحية المالية.
والثانية: تفوّقهم على أهل المدينة من الناحية الثقافية، فهم كانوا أصحاب كتاب وعلى
اطّلاع على مختلف المعارف والعلوم الدينية والمسائل الّتي تجهلها عقول أهل المدينة
ذات الطبيعة شبه البدائية. من هنا كانت لهم الهيمنة الفكرية. وإذا ما أردنا وصفهم
وفقاً للمصطلحات المعاصرة فبإمكاننا القول إنّهم كانوا يشكّلون طبقة مثقفة، لذلك
كانوا يستهينون بأهل المدينة ويسخرون منهم، وربّما كانوا يتصاغرون حينما يتعرّضون
للأخطار أو عند الضرورة، غير أن التفوّق كان لهم في الحالات الطبيعية.
الثالثة: اتّصالهم بالمناطق النائية عن المدينة، فلم يتقوقعوا داخل حدود المدينة.
لقد كانوا يمثّلون واقعاً قائماً في المدينة، لذا كان على النبيّ صلى الله عليه
وآله وسلم وضعهم في الحسبان، فكان أن أوجد صلى الله عليه وآله وسلم ، ميثاقاً
جماعياً عامّاً. ولدى حلول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة اتّضح أنّ
قيادة مجتمعها إنّما هي منحصرة به صلى الله عليه وآله وسلم من دون أن يبرم عقداً أو
يطلب شيئاً من الناس أو يدخل في مباحثات مع أحد، أي أنّ الشخصية والعظمة النبويّة
أخضعت الجميع لها بشكل طبيعيّ. لقد تجلّت قيادته وجعلت الجميع يتحرّكون ويبادرون
حول محوريتها. لقد كتب النبيّ ميثاقاً، وصار موضع قبول من قبل الجميع، فكان شاملاً
للسلوك الاجتماعيّ: المعاملات، والنزاعات، والديات، وعلاقة النبيّ صلى الله عليه
وآله وسلم مع معارضيه وموقفه من اليهود ومن غير المسلمين، وكلّ ذلك كان مدوّناً
ومفصّلاً ولعلّه يحتل صفحتين أو ثلاث صفحات كبيرة من كتب التاريخ القديمة الكبرى.
الخطوة الثانية كانت في غاية الأهمية وهي إشاعة روح الأخوّة. فلقد كانت
الأرستقراطيّة والعصبيات الخرافية والأبّهة القبلية وحالة الانفصال بين مختلف
الطبقات، أبرز الأمراض الّتي كانت تعاني منها المجتمعات الجاهلية العربيّة
المتعصّبة يومذاك. والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بإشاعته للأخوّة سحق هذه
النعرات تحت قدميه. فقد آخى بين رئيس القبيلة وبين من هو في مستوى دانٍ أو متوسّط.
وهؤلاء بدورهم ارتضوا هذه الأخوّة طائعين. ووضع السادة والأشراف إلى جانب العبيد من
المسلمين والعتقاء، وبذلك فقد قضى على العوائق في طريق الوحدة الاجتماعية.
وعندما أراد صلى الله عليه وآله وسلم اتّخاذ مؤذّن لمسجده، كان ذوو الحناجر
الجهوريّة والهندام الجميل والشخصيات المشهورة من الكثرة بمكان، لكنّه اختار من
دونهم بلالاً الحبشيّ الّذي كان يفتقد إلى الجمال والصوت الحسن والشرف العائلي
والنَّسبي. فالمناط كان الإسلام والإيمان والجهاد والتضحية في سبيل الله لا غير.
لاحظوا كيف أنّه صلى الله عليه وآله وسلم حدّد القيم على صعيد العمل، فقبل أن يترك
كلامه بصماته على القلوب، كانت أعماله وسيرته وهديه هي الّتي تؤثّر.
حماية النظام الإسلاميّ
وبغية إنجاز هذه المهمّة كانت هنالك ثلاث مراحل هي:
المرحلة الأولى: إرساء قواعد النظام.
المرحلة الثانية: صيانة هذا النظام؛ فمن الطبيعيّ أن يكون هناك من يعادي هذا الكيان
المتنامي والمتعاظم الّذي لو أحسَّ به أصحاب السلطة لشعروا بالخطر إزاءه. ولو لم
تكن لدى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم القدرة على الدفاع عن هذا الوليد الطبيعيّ
الميمون بحنكة في مقابل الأعداء، فسيزول هذا النظام وتذهب جهوده سدى، فلا بدّ له من
صيانته.
المرحلة الثالثة: إكمال البناء وإعماره؛ إذ لا تكفي عملية الإرساء وإنّما هي الخطوة
الأولى.
وهذه المراحل الثلاث تسير إلى جانب بعضها بعضاً عرضياً. إنّ عمليّة إرساء القواعد
تأتي بالدرجة الأولى، بيد أنّه يتعيّن الحذر من العدوّ أثناءها، وهكذا تأتي مرحلة
الصيانة، حيث يتم خلالها الاهتمام ببناء الأشخاص والكيانات الاجتماعية ومن ثمّ
تتواصل في المراحل اللاحقة.
أعداء النظام الإسلامي
كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يرى خمسة أصناف من الأعداء يتربّصون بهذا
المجتمع الفتيّ:
العدوّ الأول: وهو عدوٌّ ضئيل الأهميّة ومحدود، ولكن ينبغي عدم التغافل عنه في نفس
الوقت، فلربّما يتسبّب في بروز خطر داهم. من هو هذا العدوّ؟ إنّه القبائل شبه
الهمجيّة الّتي تحيط بالمدينة؛ فعلى بعد عشرة أو خمسة عشر أو عشرين فرسخاً من
المدينة تعيش قبائل شبه بدائيّة، جلّ حياتها عبارة عن الاقتتال وإراقة الدماء
والإغارة والنهب والسلب. وإذا كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يصبو إلى إقامة
مجتمع سليم آمنٍ ووادع في المدينة، فما عليه إلا أن يحسب لهؤلاء حسابهم، وهكذا فعل
صلى الله عليه وآله وسلم ، حيث تعاهد مع مَنْ تتوفّر فيه أمارات الصلاح والهداية،
ولم يبادرهم بالدعوة للإسلام بادئ الرأي، بل عاهدهم مع بقائهم على كفرهم وشركهم
بغية تجنّب انتهاكاتهم. لقد كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ملتزماً أشدّ
الالتزام بتعهّداته ومواثيقه، وهذا ما سأتطرّق إليه أيضاً، لكنّه لاحق الأشرار ومَن
لا عهد لهم وعالج مشكلتهم. وما يُذكر من بَعْثِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم
للسرايا، حيث كان يرسل الخمسين أو العشرين من المسلمين في سرايا، لملاحقة هؤلاء
الّذين تأبى طبيعتهم الوئام والهداية والصلاح ولا يستقرّ لهم حال إلا بإراقة الدماء
والتوسّل بالقوّة، فكان أن لاحقهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقمعهم وأخمد
نارهم.
العدوّ الثاني: هو مكّة الّتي كان لها مركزيّة. وبالرغم من عدم وجود حكومة بالمعنى
المتعارف عليه فيها، بيد أن ثمّة مجموعة من الأشراف المتكبّرين العتاة أصحاب النفوذ
كانت تحكم مكّة، وهم على اختلافهم كانوا متّحدين بوجه هذا المولود اليافع الجديد.
وكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على علم بأنّ الخطر الجسيم إنّما ينطلق منهم،
وقد حصل ذلك عملياً. وكان الشعور يراود النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه لو
انتظر حتّى يداهموه فإنّهم باليقين لن يتوانوا عن ذلك، لذلك فقد تتبّعهم لكنّه لم
يقصد مكّة، بل اعترض قافلتهم الّتي كانت تمرّ على مقربة من المدينة. وكانت معركة
بدر أهم عمليات التعرّض وتمثّل باكورة عمله. لقد تعرّض لهم النبيّ صلى الله عليه
وآله وسلم فجاؤوا لحربه تدفعهم العصبيّة والعناد والإصرار على محاربته.
(28/02/1380)
بحسب الوعد الإلهيّ أُخبر المسلمون أنّهم سينتصرون على مجموعة من الكافرين. وقد كان
ذلك في السنة الثانية للهجرة. كانت القافلة محمّلة بمتاع وبضائع قريش آتيةً من
الشام إلى المدينة، لتعبر أطراف المدينة نحو مكّة. وبمجرّد أن اتّضح لكفّار قريش
تهديد أبطال ومجاهدي العرب والمسلمين، حتّى أرسلت قوّاتٍ مسلّحة لأجل الدفاع عن
متاعها وبضائعها إلى المدينة. كان المسلمون يميلون أكثر إلى إيقاف هذه القافلة
المحمّلة بالثروة والمتاع والّتي لم يكن لديها أيّ دفاع يُذكر. لكنّ الله قضى أن
تكون المواجهة المسلّحة بين المسلمين وكفّار قريش، ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ
إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ
الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾17. فقد كان المسلمون يعلمون أنّهم سينتصرون في هذه
المواجهة ولكنّهم لم يكونوا يعلمون بأنّ ذلك سيكون على قوّات قريش المسلّحة، بل
كانوا يظنّون أنّ انتصارهم سيكون على هذه القافلة التجارية الآتية من الشام. ولكنّ
النبيّ بدّل طريقهم وأخذهم نحو المواجهة العسكرية، فعبرت القافلة، لكنّ المسلمين
التقوا بالكفّار في محلّةٍ تُدعى بدراً. فماذا كانت العلّة وراء تبديل الله تعالى
طريق المسلمين من مواجهة القافلة إلى معركة مع المقاتلين المسلّحين؟ السبب هو أنّ
المسلمين كانوا يرون ما هو قريب وكانت إرادة الله ومشيئته تريد هدفاً بعيداً،
﴿وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾18. فإنّ الله تعالى أراد أن
يعمّ الحقّ هذا العالم ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُجْرِمُونَ﴾19 وأراد أن يزهق الباطل، الّذي هو بطبيعته زاهق. ألم يكن المقرّر
هو أن يقوم الإسلام بالقضاء على جميع القوى والسلطنات الشيطانية والطاغوتية؟
ألم يكن المقرّر أن تصبح الأمّة الإسلامية ﴿لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى
النَّاسِ﴾20 ألم يكن المقرّر أن ترتفع راية الإسلام خفّاقةً على قمم الإنسانية
والبشرية؟ فمتى يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن أيّ طريقٍ؟
لقد كان المسلمون في ذلك الوقت يفكّرون في أنفسهم أنّهم لو صادروا هذه القافلة
الثرية، وحصلوا على بعض المال فإنّ الإسلام الفتيّ سوف يقوى. كانوا يفكّرون بشكلٍ
صحيح، لكن كان الفكر الأعلى والأكثر قيمةً في محلٍّ آخر. الفكر الأعلى أنّنا نحن
المسلمون الّذين نحيط بالنبيّ اليوم، قد وصلنا إلى حدّ يمكننا أن نرسّخ فكرنا
وطريقنا في المجتمعات المستضعفة المحرومة وفي وسط عوالم الظلام والظلمانية، ذاك
الحوض كان فيه من الماء بحيث إنّه يمكن أن يجري ويروي كلّ هذه الغرسات والأشجار
والأراضي الميّتة واليابسة، هذه هي الفكرة الأهمّ. فإذا كان المقرّر أن يصل الإسلام
إلى النصر الواقعيّ، وإذا كان المقرّر أن تتحرّك هذه النواة الجليلة للإسلام نحو
المناطق المستضعفة، وإذا كان المقرّر أن تتساقط قصور الظلم والجور واحداً بعد
الآخر، فينبغي أن يبدأ ذلك من مكانٍ ما. لم يكن المسلم المخلص المحبّ في صدر
الإسلام يعلم من أين يبدأ، وقد علّمه الله تعالى ذلك، وهيّأ له فأخرجه الله تعالى
من أجل مصادرة أموال قريش ليجرّه إلى معركةٍ لم يردها، لكي يتحقّق من خلال ذلك، مع
قلةّ العتاد ولكن مع الإيمان الراسخ، إرجاع العدوّ إلى الوراء وفتح الطريق أمام
سيلان وجريان وتقدّم ونفوذ قوّة الحقّ وثبات طريقه، لكي يفهم العدوّ أنّ الإسلام
موجودٌ فيجب أن يأخذه على محمل الجدّ ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ
الْبَاطِلَ﴾21. لقد جعلناكم أيّها المسلمون مقابل الجيش الجرّار للعدوّ من دون أن
تريدوا ذلك، وذلك من أجل أن توجّهوا قبضتكم نحوهم، فتظهر قدرة الله أمام ناظريهم.
(11/07/1359)
بعد أن كان النّصر الإلهيّ في معركة بدر، بفضل الله ورحمته وبهمّة المسلمين، من
نصيب مجاهدي الإسلام، فإنّه لم يكن المتوقّع من العدوّ أن يقلع عن عداوته بهذه
السرعة، ولذلك بدأ بالتخطيط لمعركة أُحد. وفي معركة أُحد كان الأمر في البداية
لصالح المسلمين بسبب اتّحادهم وتوافقهم، واستطاعوا في البداية أن يهزموا المشركين،
ولكن بعد أن حصلوا على النصر بسرعة، فإنّ أولئك الـ 50 رجلاً الّذين أُمروا أن
يحافظوا على موقعيّتهم على أكتاف الجبل مقابل العدوّ، ومن أجل أن لا يتخلّفوا عن
جمع الغنائم، تركوا مهمّتهم ولحقوا بالمسلمين الّذين كانوا بدورهم مشغولين بجمع
الغنائم. بقي عشرة أشخاص فقط من المسلمين عند ذلك الجبل، وأدّوا ما عليهم، لكنّ
العدوّ اغتنم هذه الفرصة والتفّ عليهم، واخترق صفوفهم من مكان نقطة ضعفهم وعدم وجود
العدد الكافي، وهجموا على بقيّة المسلمين. وقد دفع المسلمون ثمناً باهظاً بسبب هذا
الهجوم؛ لم يُهزم الإسلام، ولكنّ انتصاره تأخّر بالإضافة إلى خسارة أبطالٍ جشعان
وأعزّاء في هذا الطريق، كحمزة سيّد الشهداء. والله تعالى يدعو المسلمين إلى
الاعتبار والتأمّل ويقول لهم إنّنا صدقنا وعدنا وقلنا إنّكم ستنتصرون على العدوّ
وقد انتصرتم، ولكن بعد أن ظهرت فيكم تلك الحالات وتلك الخصال الثلاث، تلقّيتم
الضربة، وتلك الخصال الثلاث هي عبارة عن:
أوّلاً: ﴿وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ﴾، فشققتم وحدة الكلمة والصفّ.
ثانياً:﴿فَشِلْتُمْ﴾، أي ضعفتم وفقدتم حماسكم وجهوزيّتكم وثباتكم، وإقدامكم.
ثالثاً: ﴿وَعَصَيْتُم﴾22، فتخلّفتم عن أوامر الرسول والقائد وأولئك الّذين كانوا
مسؤولين عن إدارة أموركم.
فهذه الصفات الثلاث الّتي ظهرت فيكم أعطت العدّو الفرصة ليلتفّ عليكم ويوجّه لكم
ضربة وليسقط أعزّ أبناء الإسلام مضرّجين بدمائهم، بالغين بذلك مقام الشهادة
والمفاخر، وليخسر العالم الإسلاميّ بسبب هذا الأمر أمثال هذه الشخصية. (19/02/1359)
كانت معركة الخندق آخر المعارك الّتي شنّت ضدّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم -
وهي واحدة من أهمّها - حيث استجمع كفّار مكّة كلّ قواهم واستعانوا بالآخرين أيضاً
وقالوا فلنذهب ونقتل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وبضع مئات من أنصاره
المقرّبين، وننهب المدينة، ونرجع مطمئنّين، ولن يبقى بعدها عينٌ ولا أثر للنبيّ ومن
معه. وقبل أن يصلوا إلى المدينة كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد علم بالأمر
فبادر إلى حفر خندق عرضه أربعون متراً تقريباً من الجّهة الّتي يسهل اختراقها. كان
ذلك في شهر رمضان والمناخ قارس البرودة كما تنقل الروايات، ولم يهطل المطر ذاك
العام، من هنا فقد عمّ الجدب وعانى الناس من المصاعب. كان النبيّ صلى الله عليه
وآله وسلم أكثر الناس عملاً في حفر الخندق؛ فحيث وقعت عيناه على من أعياه العمل
وأصابه الإرهاق أو عجز عن المواصلة، كان صلى الله عليه وآله وسلم يتناول معوله
ويمارس العمل والبناء بدلاً عنه. فلم يسجّل حضوره بإصدار الإيعازات فقط، بل كان
يشارك المسلمين بكيانه ووجوده أيضاً. ولمّا رأى الكفّار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا
بالإحباط والهزيمة وافتُضح أمرهم، وأخيراً اضطرّوا للانسحاب. عندها نادى النبيّ صلى
الله عليه وآله وسلم بأنّ الأمر قد انتهى، وهذه كانت آخر المعارك الّتي يشنّها
كفّار مكّة ضدّ المسلمين، وقد جاء دور المسلمين للتوجّه نحو مكّة وملاحقة الكفّار.
بعد عام من تلك الواقعة أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم التوجّه إلى مكّة
لأداء العمرة - وأثناء ذلك وقع صلح الحديبية الغنيّ بالمعاني والأهداف - وكان مسير
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكّة في شهر محرّم الحرام - حيث كانوا يحرّمون
فيه القتال -
فأصبحوا في حيرة من أمرهم ما عساهم صانعين، أيسمحون له بالتقدّم في مسيره؟ وماذا
سيفعلون إزاء نجاحه هذا؟ وكيف يواجهونه؟ أيقاتلونه وهم في شهر محرّم؟ وكيف
يقاتلونه؟ وأخيراً قرّروا عدم السماح له بالمجيء إلى مكّة وإبادته هو وأصحابه إن
وجدوا لذلك مبرّراً. تميّز تصرّف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بأسمى درجات
التدبير، حيث قام بما دفعهم لأن يُبرِموا معه صلحاً يقضي بأن يعود إلى المدينة على
أن يأتي في العام القادم لأداء العمرة. وتوفّرت الظروف جميعها أمام النبيّ صلى الله
عليه وآله وسلم من أجل التبليغ في كلّ أرجاء المنطقة وفُتحت أمامه الأبواب. كــان
ذلك صلحاً، بيد أنّ الباري تعالــى يصرّح فــي كتابه بالقول: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا
لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾23. ومن يراجع مصادر التاريخ الصحيحة والموثّقة يدهشه
كثيراً ما جرى في واقعة صلح الحديبية. وفي العام التالي توجّه النبيّ صلى الله عليه
وآله وسلم لأداء العمرة ورُغم أنوفهم أخذت شوكته تزداد قوّة يوماً بعد يوم. ولمّا
نقض الكفّار العهد في العام اللاحق - أي العام الثامن للهجرة - تقدّم نحوهم النبيّ
صلى الله عليه وآله وسلم وفتح مكّة، فكان فتحاً عظيماً ينبئ عن اقتدار النبيّ صلى
الله عليه وآله وسلم وتمكّنه. وتأسيساً على ذلك فقد اتّسم تعامل النبيّ صلى الله
عليه وآله وسلم مع هذا العدوّ بالتدبير والاقتدار والتأنّي والصبر بعيداً عن
الارتباك، ولم يتراجع أمامه ولو خطوة واحدة، بل كان يتقدّم نحوه يوماً بعد يوم
وآناً بعد آن.
العدوّ الثالث: وهم اليهود، أي الدخلاء الّذين لا يوثق بهم والّذين أسرعوا بالتعبير
عن استعدادهم لمعايشة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، لكنّهم لم يقلعوا
عن أعمال الإيذاء والتخريب والخيانة. بالتدقيق جيّداً في سورة البقرة وبعض السور
الأخرى من القرآن الكريم، نجد أنّها تختصّ بطريقة تعامل النبيّ صلى الله عليه وآله
وسلم وصراعه الثقافي مع اليهود. فقد تقدّم القول إنّ هؤلاء كانوا على قدر من العلم
والوعي والثقافة، وذوي تأثير كبير على أفكار ضعاف الإيمان من الناس، ويحوكون الدسائس ويزرعون اليأس في قلوبهم ويثيرون الفتن بينهم، فكانوا يمثّلون
عدوّاً منظّماً. وكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يسلك معهم سبيل المداراة ما
أمكنه، لكنّه لمّا لمس منهم عدم استجابتهم لهذه المداراة بادر إلى معاقبتهم. ولم
تأتِ مباغتة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لهم دون سبب أو مقدّمات، بل إنّ كلاًّ
من هذه القبائل الثلاث ارتكبت أفعالاً فعاقبهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بما
يوازي فعلتهم.
الفئة الأولى: بنو قينقاع الذين خانوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فتوجّه نحوهم
وأمرهم بالجلاء وأخرجهم من ديارهم تاركين ثرواتهم للمسلمين.
والفئة الثانية: هم بنو النضير الّذين خانوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً
- وقصّة خيانتهم مهمّة - فأمرهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بحمل بعض أمتعتهم
والرحيل، فاضطرّوا لذلك وارتحلوا.
الفئة الثالثة: وهم بنو قريظة، فقد منحهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الأمان
وسمح لهم
2013-04-01