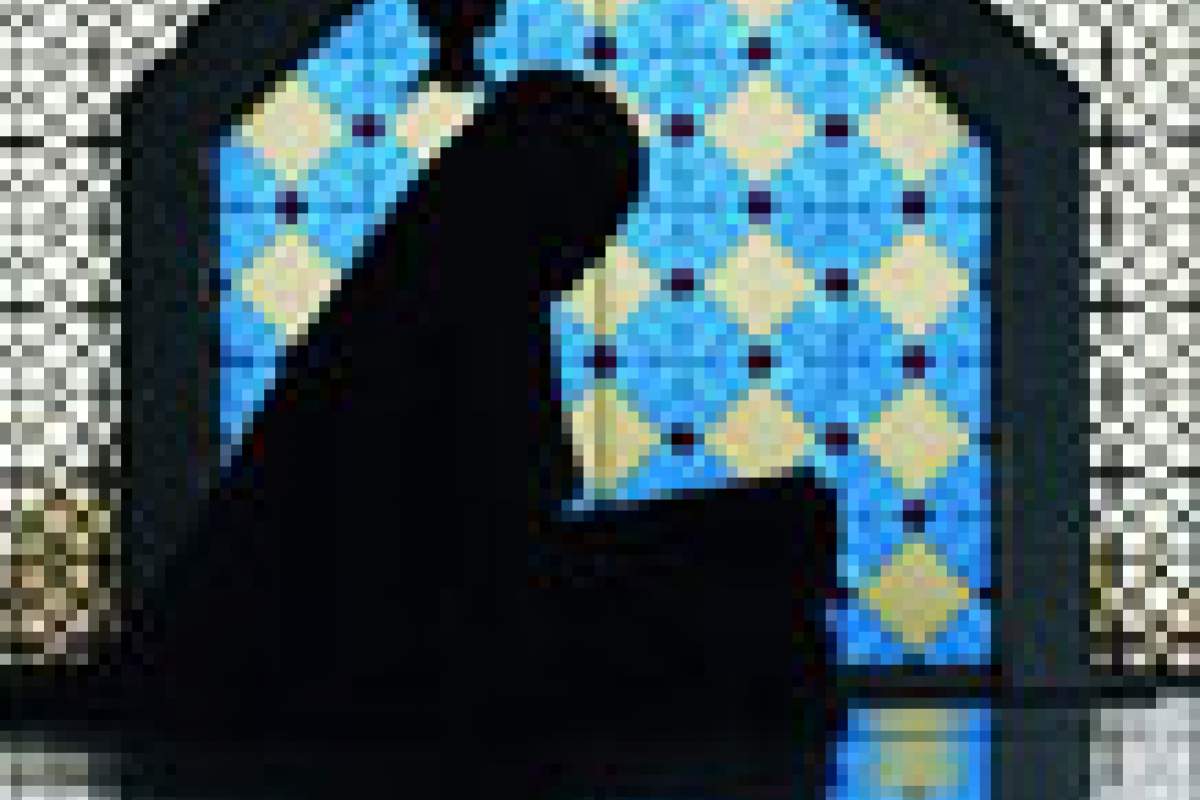مناهج الإختيار : الإختيار المعتزلي
العدل
أكثر المعتزلة إلاَّ من شذّ كالنجار وأبي الحسين البصري. يقولون بأنَّ أفعال العبد واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الإستقلال بلا إيجاب بل باختيارولبُ مذهبهم ومن حذا حذوهم أنَّ الله تعالى أوجد العباد وأقدرهم على أفعالهم وفوّض إليهم الإِختيار. فهم مستقلون بإيجاد أفعالهم على وِفْقِ مشيئتهم...
عدد الزوار: 103
أكثر المعتزلة إلاَّ من شذّ كالنجار وأبي الحسين البصري1. يقولون بأنَّ أفعال العبد واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الإستقلال بلا إيجاب بل باختيار2.
ولبُ مذهبهم ومن حذا حذوهم أنَّ الله تعالى أوجد العباد وأقدرهم على أفعالهم وفوّض إليهم الإِختيار. فهم مستقلون بإيجاد أفعالهم على وِفْقِ مشيئتهم، وطبق قدرتهم. وأنَّ اللّه أراد منهم الإيمان والطاعة وكره منهم الكفر والمعصية. قالوا: وعلى هذا يترتب أمور:
1- فائدة التكليف بالأوامر والنواهي، وفائدة الوعد والوعيد.
2- إستحقاق الثواب والعِقاب.
3- تنزيه اللّه سبحانه عن إيجاد القبائح والشرور من أنواع الكفر والمعاصي والمساوئ.
قال السيد الشريف في "شرح المواقف": "إن المعتزلة استدلوا بوجوه كثيرة مرجعها إلى أمر واحد وهوأنه لولا استقلال العبد بالفعل على سبيل الإختيار لبطل التكليف، وبطل التأديب الذي ورد به الشرع، وارتفع المدح والذم، إذ ليس للفعل استناد إلى العبد أصلاً، ولم يبق للبعثة فائدة، لأن العباد ليسوا موجدين لأفعالهم، فمن أين لهم استحقاق الثواب والعِقاب"3.
هذه هي النتائج المترتبة على أصلهم: استقلال العبد في أفعاله، وعدم وجود الصلة بينه وبين اللّه سبحانه.
ولأجل أن نقف على نصوص المعتزلة في هذا الباب نقتطف من شرح الأصول الخمسة لقاضي القُضاة عبد الجبار بن أحمد شيخ المعتزلة في عصره المتوفى عام 415، عدة مقاطع:
يقول: قد عُلم عقلاً وسمعاً فساد ما تقوله المجبرة الذين ينسبون أفعال العباد إلى اللّه تعالى وجملة القول في ذلك أن تصرفاتنا محتاجة إلينا ومتعلقة بنا لحدوثها.
وعند جَهْم بن صفوان أنها لا تتعلق بنا ويقول إنما نحن كالظروف لها حتى إن خُلق فينا كان، وإن لم يخلق لم يكن.
وعند ضرار بن عمروأنها متعلقة بنا ومحتاجة إلينا، لكن جهة الحاجة إنما هوالكسب وقد شارك جهماً في المذهب وزاد عليه في الإحالة "الكسب". وما ذكره جهم على فساده معقول وما ذكره هوغير معقول اصلاً.
فأمَّا المتخلفون من المجبرة فقد قسموا التصرفات قسمين، فجعلوا أحد القسمين متعلقاً بنا وهوالمباشر، والقسم الآخر غير متعلق بنا وهوالمتولد (كالإِحراق المتولد من إلقاء القرطاس في النار).
ثم استدل القاضي على مذهبه بوجوه نشير إلى بعضها:
قال: والذي يدل على ذلك:
الأول: أن نفصل بين المحسن والمسيء، وبين حسن الوجه وقبيحه، فنحمد المحسن على إحسانه ونذم المسيء على إساءته. ولا تجوز هذه الطريقة في حسن الوجه وقبيحه، ولا في طول القامة وقصرها، حتى لا يحسن منا أن نقول للطويل لم طالت قامتك ولا للقصير لم قصرت. كما يحسن أن نقول للظالم لم ظلمت وللكاذب لِمَ كَذِبْت، فلولا أنَّ أحدهما متعلق بنا وموجود من جهتنا بخلاف الآخر، وإلاَّ لما وجب هذا الفصل، ولكان الحال في طول القامة وقصرها كالحال في الظلم والكذب وقد عُرف فساده.
الثاني: إنَّه يلزم قبح مجاهدة أهل الروم وغيرهم من الكفار لأنَّ للكفرة أن يقولوا: إن كان الجهاد على ما خلق فينا وجعلنا بحيث لا يمكننا مفارقته والإِنفكاك عنه فذلك جهاد لا معنى له.
الثالث: ما ثبت من أنَّ العاقل لا يشوّه نفسه كأن يعلق العظام في رقبته. وإذا وجب ذلك في الواحد منَّا فلأَنْ يجب في حق القديم تعالى وهوأحكم الحاكمين أولى وأحرى. وعلى مذهبهم "المجبرة" إنَّه تعالى شوّه نفسه وسوّأ الثناء عليه وأراد منهم كل ذلك تعالى عمَّا يقولون.
الرابع: إنَّ في أفعال العباد ما هوظلم وجور، فلوكان تعالى خالقاً لها لوجب أن يكون ظالماً وجائراً تعالى اللّه عن ذلك.
الخامس: الإِستدلال بِعِدَّة من الآيات منها قوله: ﴿ما تَرى في خَلْقِ الرَّحمنِ مِنْ تَفَاوُت﴾(الملك:3). فقد نفى سبحانه التفاوت عن خلقه، وليس المراد التفاوت في الخلق لوجوده فيه، بل المراد التفاوت من جهة الحكمة. إذا ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن تكون من جهة اللّه تعالى لا شتمالها على التفاوت وغيره.
ئم إنَّ القاضي يرد على أدلة الأشاعرة التي نقلناها عنهم4.
وأنت خبير بأنَّ هذه الدلائل على فرض تماميتها ترد القول بالجبر أي ارتباط أفعال العباد باللّه سبحانه وانقطاعها عن العبد ولا تثبت العكس، وأنَّ فعل العبد مخلوق للعبد لا صلة له بنحومن الأنحاء باللّه سبحانه كما هومدّعى المعتزلة، ولأجل ذلك هنا منهج ثالث وهوالأمر بين الأمرين.
وفي الحقيقة إنّ هذه الطائفة تنكر التوحيد الأفعالي الذي ركّز عليه النقل والعقل، وهوأنَّه لا خالق إلاَّ اللّه سبحانه.
توضيح ذلك: إنَّ دافع المعتزلة إلى القول بالتفويض هوالحفاظ على وصف من أوصافه سبحانه وهو"العدل". فلما كان العدل عندهم هوالأصل والأساس في سائر المباحث، عمدوا إلى تطبيق مسألة أفعال العباد عليه فخرجوا بهذه النتيجة: إنَّ القول بكون أفعال العباد مخلوقة للّه سبحانه ينافي عدله. ولجأوا بعدها إلى القول بأنها من صنع العبد وليس للّه فيها أي صنع. ولمَّا كان الأصل عند الأشاعرة هوالتوحيد الأفعالي وأنه لا مؤثر إستقلالا ولا تبعاً غيره سبحانه، عمدوا إلى تطبيق هذه المسألة على أساسهم. فجعلوا أفعال العباد مخلوقة للّه سبحانه وليس للعبد فيها صنع.
فالطائفتان لم تتدبرا في مسألة أفعال العباد تدبراً عميقاً، بل جعلتا النظر فيها فرعاً للنظر في الأصل الذي تبنتاه. وقد غفلتا عن أنَّ هناك طريقاً ثالثاً يجتمع فيه الأصلان: التوحيد الأفعالي ووصف العدل، مع القول بالإِختيار، كما سيتضح ذلك عند البحث عن المنهج الثالث للإِختيار. فلنعطف عنان الكلام إلى الأصل الفلسفي الذي بُني عليه القول بتفويض أفعال العباد إلى أنفسهم.
حاجة المُمْكِن إلى العِلّة تنحصر في حُدوثه
قالو: إنَّ سِرّ حاجة الممكن إلى الواجب والمعلول إلى العلّة هوحدوثه الذي يفسّر بالوجود المسبوق بالعدم وانقلاب العدم إليه. فإذا حدث الممكن ترتفع الحاجة، لأنَّ البقاء شيء والحدوث شيء آخر. إذ الحدوث لا ينطبق إلاَّ على الوجود الأول القاطع للعدم. وأمَّا الوجودات اللاحقة فلا تتصف بالحدوث بل تتصف بالبقاء، فعندئذ يكون الشيء في بقاء ذاته غير محتاج إلى العلّة.
فإذا كان هذا حال الذات، فكيف حال الأفعال، فلا يحتاج في أعماله إلى العِلّة. ولأجل ذلك يفعل العباد ويتركون بقدرة وإرادة من أنفسهم، ولا صلة في هذه الحال بين الذات والأفعال، والواجب الحكيم سبحانه.
يقول الشيخ الرئيس حاكياً عقيدة المفوضة: "وقد يقولون: إنَّه إذا أوجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل حتى أنَّه لوفُقِدَ الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجوداً كما يشاهدونه من فقدان البنّاء وقوام البناء. وحتى أنّ كثيراً منهم لا يتحاشى أن يقول: لوجاز على الباري تعالى العدم لما ضرّ عدمه وجودَ العالم لأنَّ العالم عندهم إنما احتاج إلى الباري تعالى في آن أوجده (أخرجه من العدم إلى الوجود) حتى كان بذلك فاعلاً، فإذا جعل وحصل له الوجود من العدم، فكيف يخرج بعد ذلك الوجود عن العدم حتى يحتاج إلى الفاعل"5.
تحليل هذا الأصل ونقده
إنَّ هذا الأصل الذي بنى عليه القوم نظريتهم في أفعال العباد، بل في أفعال وآثار كل الكائنات، باطل لوجوه نشير إليها:
الوجه الأول: إنَّ مناط حاجة المعلول إلى العلّة هوالإِمكان أي عدم كون وجوده نابعاً من ذاته، وكون الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته متساويان، وهذا المِلاك موجود في حالتي البدء والبقاء، وأمَّا الحدوث فليس ملاكاً للحاجة فإنه عبارة عن تحقق الشيء بعد عدمه، ومثل هذا أمر انتزاعي ينتزع بعد اتصاف الماهية بالوجود، ومِلاك الحاجة يجب أن يكون قبل الوجود لا بعده.
إنَّ الحدوث أمر منتزع من الشيء بعد تحققه، ويقع في الدرجة الخامسة من محل حاجة الممكن إلى العِلّة. وذلك لأن الشيء يحتاج أولاً ثم تقترنه العلة ثانياً، فتوجده ثالثاً، فيتحقق الوجود رابعاً، فينتزع منه وصف الحدوث خامساً. فكيف يكون الحدوث مناط الحاجة الذي يجب أن يكون في المرتبة الأولى وقد اشتهر قولهم: الشيء قُرّرَ (تُصُوِّر)، فاحتاج، فأوجد، فُوجِد، فحَدَث.
وبعبارة ثانية: ذهب الحكماء إلى أنَّ مناط الحاجة هوكون الشيء (الماهية) متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وأنَّه بذاته لا يقتضي شيئاً واحداً من الطرفين ولا يخرج عن حد الإِستواء إلاَّ بعلة قاهرة تجره إلى أحد الطرفين، وتخرجه عن حالة اللاإقتضاء إلى حالة الإِقتضاء فإِذا كان مناط الحاجة هوذاك (إن الشيء بالنظر إلى ذاته لا يقتضي شيئاً) فهوموجود في حالتي الحدوث والبقاء. والقول باستغناء الكون في بقائه، عن العلّة، دون حدوثه، تخصيص للقاعدة العقلية التي تقول: إِنَّ كل ممكن مادام ممكناً بمعنى ما دام كون الوجود غير نابع من ذاته يحتاج إلى علّة، وتخصيص القاعدة العقلية مرفوض جداً.
ويشير الحكيم المتألّه الشيخ محمد حسين الأصفهاني في منظومته إلى هذا الوجه بقوله:
والإِفتقَارُ لازمُ الإِمكَانِ منْ دُون حَاجَة إلى البُرْهَانِ
لاَ فَرْقَ ما بينَ الحُدوثِ والبَقا في لازمِ الذَّات ولَنْ يَفْتَرِقا
الوجه الثاني: إنَّ القول بأنَّ العالم المادي بحاجة إلى العلّة في الحدوث دون البقاء، يشبه القول بأنَّ بعض أبعاد الجسم بحاجة إلى العلة دون الأبعاد الأخرى. فإنَّ لكل جسم بعدين، بعداً مكانياً وبعداً زمانياً، فامتداد الجسم في أبعاده الثلاثة، يشكل بعده المكاني. كما أنَّ بقاءه في عمود الزمان يشكل بعده الزماني. فالجسم باعتبار أبعاضه، ذوأبعاد مكانية، وباعتبار استمرار وجوده مدى الساعات والأيام ذوأبعاد زمانية. فكما أنَّ حاجة الجسم إلى العلّة لا تختص ببعض أجزائه وأبعاضه بل الجسم في كل بعد من الأبعاد المكانية محتاج إلى العلّة، فكذا هومحتاج إليها في جميع أبعاده الزمانية، حدوثاً وبقاء من غير فرق بين آن الحدوث وآن البقاء والآنات المتتالية. فالتفريق بين الحدوث والبقاء يشبه القول باستغناء الجسم في بعض أبعاضه عن العلّة. فالبعد الزماني والمكاني وجهان لعملة واحدة، وبعدان لشيء واحد فلا يمكن التفكيك بينهما.
وتظهر حقيقة هذا الوجه إذا وقفنا على أنَّ العالم في ظل الحركة الجوهرية، في تبدل مستمر، وتغيير دائم نافذين في جوهر الأشياء وطبيعة العالم المادي، فذوات الأشياء في تجدد دائم واندثار متواصل. والعالم حسب هذه النظرية أشبه بنهر جار تنعكس فيه صورة القمر، فالناظر الساذج يتصور أنَّ هناك صورة منعكسة على الماء وهي باقية ثابتة والناظر الدقيق على أنَّ الصور تتبدل حسب جريان الماء وسيلانه، فهناك صور مستمرة.
وعلى ضوء هذه النظرية: العالم المادي أشبه بعين نابعة من دون توقف حتى لحظة واحدة. فإذا كان هذا حال العالم المادي، فكيف يصح لعاقل أن يقول: إنَّ العالم ومنه الإِنسان إنما يحتاج إلى العلّة في حدوثه دون بقائه، مع أنَّه ليس هنا أي بقاء وثبات بل العالم في حدوث بعد حدوث وزوال بعد زوال، على وجه الإتصال والإِستمرار بحيث يحسبه الساذج بقاءً، وهوفي حال الزوال والتبدل والسيلان: ﴿وَتَرى الجِبالَ تَحْسَبُها جَامِدَةً وهي تَمُرّ مَرَّ السَّحَابِ﴾(النمل:88)6.
الوجه الثالث: إنَّ القول بحاجة الممكن إلى العلة في حدوثه دون بقائه غفلة عن واقعية المعلول ونسبته إلى علّته فإن وزانه إليها وزان المعنى الحرفي بالنسبة إلى المعنى الإِسمي. فكما أنَّه ليس للأول الخروج عن إطار الثاني في المراحل الثلاث: التصوّر، والدّلالة، والتحقّق، فهكذا المعلول ليس له الخروج عن إطار العلّة في حال من الحالين الحدوث والبقاء7.
فإذا كان هذا حال المقاس عليه فاستوضح منه حال المقاس، فإنَّ المفاض منه سبحانه هوالوجود وهولا يخلوعن إحدى حالتين: إمَّا وجود واجب وممكن، والأول خلف لأن المفروض كونه معلولا، فثبت الثاني، وما هوكذلك لا يمكن أن يخرج عمَّا هوعليه (الإمكان) فكما هوممكن حدوثاً، ممكن بقاء، ومثل ذلك لا يستغني عن الواجب في حال من الحالات لأن الإِستغناء آية انقلابه عن الإِمكان إلى الوجوب، وعن الفقر إلى الغنى.
نعم، ما ذكرنا من النسبة إنما يجري في العلل، والمعاليل الإلهية لا الفواعل الطبيعية، فالمعلول الإلهي بالنسبة إلى علته هوما ذكرنا، والمراد من العلّة الإلهية، مفيض الوجود ومعطيه كالنفس بالنسبة إلى الصور التي تخلقها في ضميرها، والإِرادة التي توجدها في موطنها، ففي مثل هذه المعاليل، تكون نسبة المعلول إلى العلّة، كنسبة المعنى الحرفي إلى الإِسمي.
وأمَّا الفاعل الطبيعي، كالنار بالنسبة إلى الإِحراق، فخارج عن إطار بحثنا، إذ ليس هناك عليّة حقيقية، بل حديث العلية هناك لا يتجاوز عن تبديل أجزاء النار إلى الحرارة. وذلك كما هوالحال في العلل الفيزيائية والكيميائية، فالعليّة هناك تبدل المادة إلى غيرها في ظل شرائط وخصوصيات توجب التبدّل وليس هناك حديث عن الإيجاد والإِعطاء.
وعلى ذلك فالتفويض أي استقلال الفاعل في الفعل يستلزم انقلاب الممكن وصيرورته واجباً في جهتين:
الأولى: الإِستغناء في جانب الذات من حيث البقاء.
الثانية: الإِستغناء في جانب نفس الفعل مع أنَّ الفعل ممكن مثل الذات.
الوجه الرابع: إنَّ القول بالتفويض يستلزم الشرك، أي الإِعتقاد بوجود خالقين مستقلين أحدهما العلّة العليّا التي أحدثت الموجودات والكائنات والإِنسان، والأخرى الإِنسان بل كل الكائنات فإنها تستقل بعد الخلقة والحدوث في بقائها أولاً وتأثيراتها ثانياً.
فلوقالت المعتزلة بالتفصيل بين الكائنات والإِنسان ونسبت آثار الكائنات إلى الواجب بحجة أنها لا تنافي العدل دون الإِنسان، يكون التفصيل بلا دليل.
ثم إنَّ القوم استدلوا على المسألة العقلية (غناء الممكن في بقائه عن العلّة) بالأمثلة المحسوسة، منه: بقاء البناء والمصنوعات بعد موت البنّاء والصانع، ولكن التمثيل في غير محلّه لأنَّ البنّاء والصانع فاعلان للحركة أي ضم بعض الأجزاء إلى بعض والحركة تنتهي بانتهاء عملهما فضلا عن موتهما. وأمَّا بقاء البناء والمصنوعات فهومرهونٌ للنظم السائد فيهما فإن البناء يبقى بفضل القوى الطبيعية الكامنة فيه، التي أودعها اللّه سبحانه في صميم الأشياء فليس للبنَّاء والصانع فيها صنع، وأمَّا الهيئة والشكل فهما نتيجة اجتماع أجزاء صغيرة، فتحصل من المجموع هيئة خاصة وليس لهما فيها أيضاً صنع.
تمثيلان لإِيضاح الحقيقة
الحق أنَّ قياس المعقول بالمحسوس الذي ارتكبته المعتزلة قياس غير تام ولوأراد المحقق ارتكاب لهذا القياس والتمثيل فعليه أن يتمسك بالمثالين التاليين:
الأول: إنَّ مَثَلَ الموجودات الإِمكانية بالنسبة إلى الجواب، كمثل المصباح الكهربائي المضيء، فالحس الخاطئ يزعم أنَّ الضوء المنبعث من هذا المصباح هواستمرار للضوء الأول، ويتصور أنَّ المصباح إنَّما يحتاج إلى المولّد الكهربائي في حدوث الضوء، دون استمراره.
والحال أنَّ المصباح فاقد للإِضاءة في مقام الذات محتاج في حصولها إلى ذلك المولد في كل لحظة، لأنَّ الضوء المتلألئ من المصباح إنما هو استضاءَة بعد استضاءَة، واستنارة بعد استنارة من المولد الكهربائي. أفلا ينطفئ المصباح إذا انقطع الإِتصال بينه وبين المولد؟ فالعالم يشبه هذا المصباح الكهربائي تماماً، فهولكونه فاقداً للوجود الذاتي يحتاج إلى العلّة في حدوثه وبقائه لأنه يأخذ الوجود آناً بعد آن، وزماناً بعد زمان.
الثاني: نفترض منطقة حارّة جافّة تطلع عليها الشمس بأشعتها المُحرقة الشديدة. فإذا أردنا أن تكون تلك المنطقة رطبة دائماً بتقطير الماء عليها، وإفاضته بما يشبه الرذاذ، فإن هذا الأمر يتوقف على استمرار تقاطر الماء عليها ولوانقطع لحظة ساد عليها الجفاف وصارت يابسة.
فمثل الممكن الذي يتصف بالوجود باستمرار، مثل هذه الأرض المتصفة بالرطوبة دائماً، فكما أنَّ الثاني رهن استمرار إفاضة قطرات الماء عليها آناً بعد آن، فهكذا الأول لا يتحقق إلاَّ باستمرار إفاضة الوجود عليه آناً بعد آن. ولوانقطع الفيض والصلة بينه وبين المفيض لا نعدم ولم يبق منه أثر.
التفويض في الكتاب والسنَّة
إنَّ الذكر الحكيم يَردّ التفويض بحماس ووضوح:
1- يقول سبحانه: ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقَراءُ إِلى اللّهِ واللّهُ هُوالغَنِىُّ الحَمِيدُ﴾(فاطر:15).
فالآية نصّ في كون الفقر ثابت للإِنسان في جميع الأحوال، فكيف يستغني عنه سبحانه بعد حدوثه، وفي بقائه. وكيف يستغنى في فعله عن الواجب مع سيادة الفقر عليه.
2- ويقول سبحانه: ﴿ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللّه، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَة فَمِنْ نَفْسِكَ﴾(النساء:79) فاللّه تعالى ينسب الحسنة الصادرة من العبد إليه تعالى. فلولم تكن هناك صلة بين الخالق وفعل العبد فما معنى هذه النسبة؟
3- ويقول سبحانه: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه﴾(البقرة:102).
4- ويقول سبحانه: ﴿كَمْ مِنْ فِئَة قَلِيلَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّه﴾(البقرة:249).
5- ويقول سبحانه: ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّه﴾(البقرة:251).
6- ويقول سبحانه: ﴿وَما كَانَ لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه كِتاباً مَؤَجَّلا﴾(آل عمران:145).
7- ويقول سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْس أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه﴾(يونس:100).
إلى غير ذلك من الآيات التي تقيد فعل الإِنسان بإذنه، والمراد منه مشيئته سبحانه. فيكون المراد أنَّ أفعال العباد واقعة في إطار مشيئته تعالى، فكيف تستقل عنه سبحانه؟ وما ورد في الذكر الحكيم مما يفنّد هذه المزعمة أكثر من ذلك. وقد ذكرنا بعض الآيات عند البحث عن الجبر الأشعري فلاحظ. وأمَّا السنَّة، فقد تضافرت الروايات على نقد نظرية التفويض بصور مختلفة نذكر بعضه:
1- روى الصدوق في "الأمالي"عن هشام قال: قال أبوعبداللّه عليه السَّلام: "إنَّا لا نقول جبراً ولا تفويضا"8.
2- روى الصدوق في "الأمالي"أيضاً عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السَّلام قال: "الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أنَّ اللّه عزوجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظَلَم اللّه عزوجل في حكمه، وهوكافر. ورجل يزعم أنَّ الأمر مفوّض إليهم فهذا وهّن اللّه في سلطانه، فهوكافر. ورجل يقول: إنَّ اللّه عزّوجل كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن حمد اللّه وإذا أساء استغفر اللّه، فهذا مسلم بالغ"9.
3- روى الطّبرسي في "الإِحتجاج"عن أبي حمزة الثمالي أنَّه قال: قال أبوجعفر للحسن البصري: "إِيَّاك أن تقول بالتفويض فإنَّ اللّه عزوجل لم يفوّض الأمر إلى خلقه وَهْناً منه وضعفاً، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما"10.
4- روى الصدوق في "توحيده"، والبرقي في "محاسنه" عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السَّلام قال: "اللّه تبارك وتعالى أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون، واللّه أعَزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد"11.
5- روى الصدوق في (توحيده)عن حفص بن قرط: عن أبي عبداللّه عليه السَّلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: "من زعم أنَّ اللّه تبارك وتعالى يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على اللّه. ومن زعم أنَّ الخير والشر بغير مشيّة الله، فقد أخرج الله من سلطانه. ومن زعم أنَّ المعاصي بغير قوّة اللّه، فقد كذب على اللّه، ومن كذب على اللّه أدخله اللّه النار"12.
6- روى الصدوق في "عيون أخبار الرضا" عن الرضا عليه السَّلام أنّه قال: "مساكين القدرية، أرادوا أن يصفوا اللّه عزَّوجلَّ بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه"13. والحديث يشير إلى ما ذكرناه في صدر البحث من أنَّ المعتزلة لما جعلوا العدل أصلا فرّعوا القول بالتفويض عليه، غافلين عن الطريق الذي يجمع بين العدل ووقوع الفعل في سلطانه سبحانه.
*الإلهيات،آية الله جعفر السبحاني،مؤسسة الامام الصادق عليه السلام.ج2،ص321-333
1- لاحظ حاشية شرح المواقف، لعبد الحكيم السيالكوتي، ج 2، ص 146
2- ولعل قولهم بلا إيجاب إشارة إلى أنَّ الفعل حال الصدور لا يتصف بالوجوب أيضاً والقاعدة الفلسفية (الشيء ما لم يجب لم يوجد)غير مقبولة عندهم.
3- شرح المواقف، ج 8، ص 154. ولاحظ الأسفار، ج 6، ص 370.
4- لاحظ شرح الأصول الخمسة، ص 332 و336 و344 و345 و355 و372.
5- الإشارات للشيخ الرئيس، ج 3، ص 68. لاحظ كشف المراد، الفصل الأول، المسألة 29، والمسألة 44. والأسفار، ج 2، ص 203 - 204.
6- البحث عن الحركة الجوهرية طويل الذيل وقد أشبع الأستاذ الكلام فيها في بعض محاضراته لاحظ كتاب "اللّه خالق الكون"ص 525 - 555 تجد فيه بغيتك.
7- 1سيوافيك توضيح هذا التشبيه عند البحث عن المنهج الثالث للإِختيار وهوالقول بالأمر بين الأمرين.
8- البحار، ج 5، كتاب العدل والمعاد، ص 4، ح 1.
9-المصدر السابق، ص 10، ح 14
10- المصدر السابق، ح 26.
11- المصدر السابق، ح 64. والتَّوحيد لصدوق باب نفي الجبر والتفويض، ص 360، ح 4.
12- المصدر السابق، ح 85، والتوحيد، ص 359، ح 2.
13- المصدر السابق، ص 54، ح 93.