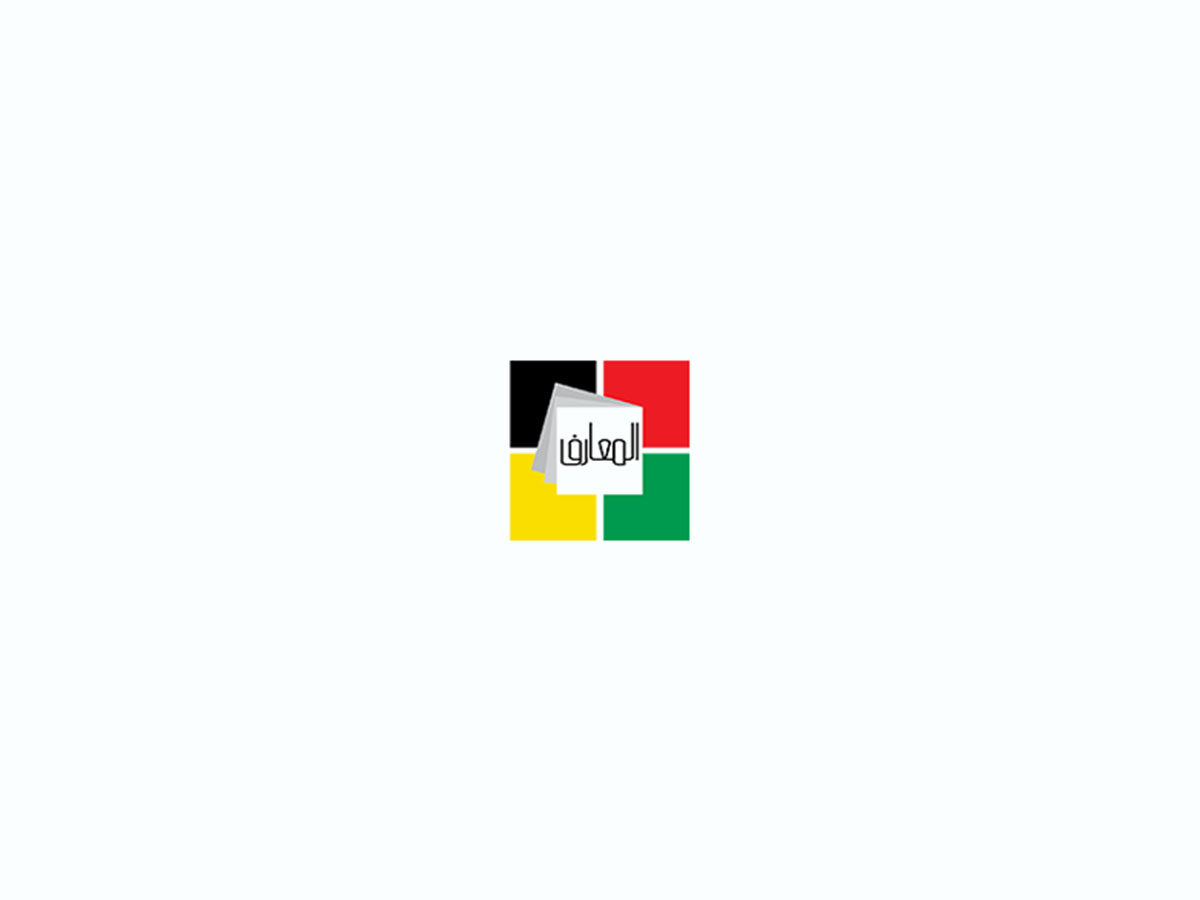في طريق التهذيب الاخلاقي- المشارطة
الخطوة الثّانية: المشارطة: الخطوة التالية التي ذكرها علماء الأخلاق، في خطّ الإلتزام الدّيني بعد التّوبة: "المشارطة": والقصد منها هو الإشتراط على النّفس وتذكيرها وتنبيهها، وأفضل الأوقات لها هو بعد صلاة الفَجر، والتنوّر بأنوار هذه العبادة الإلهيّة، الكبيرة العظيمة عند الله تعالى
عدد الزوار: 177
المشارطة
الخطوة التالية التي ذكرها علماء الأخلاق، في خطّ الإلتزام الدّيني بعد التّوبة: "المشارطة":
والقصد منها هو الإشتراط على النّفس وتذكيرها وتنبيهها، وأفضل الأوقات لها هو بعد صلاة الفَجر، والتنوّر بأنوار هذه العبادة الإلهيّة، الكبيرة العظيمة عند الله تعالى، فيذكّر نفسه ويوصيها بأن تَتحرك في طريق الخَير والصّلاح، فإذا ما انقضى العُمر فلن يفيد النّدم، ولا يمكن الإستدراك، وليجعل نصب عينيه هذه الآية الشّريفة: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الاِْنسَانَ لَفِي خُسْر﴾(العصر:1-2)، فإذا ما ضاع العُمر، فلن ينفع شيءٌ بعده: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾(العصر:3-4).
وعليه أنّ يُحدِّث نَفسه، ويقول لها: تصوّري أنّ العُمر قد إنقضى، وزالت الحُجب وتجلّت الحقائق المُرّة، وبرزت مَعالم العَذاب، وهَولِ المطّلع، ومُنكَر وَنكير، فحينئذ تشعرين بِحالة النَّدم على ما عَمِلْتِ، وتقولين: ﴿رَبِّ ارْجِعُوني * لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيَما تَرَكْتُ﴾(المؤمنون،100).
وعلى فرض إنّك لم تسمعي جواب: "كلا"، وأعادوكِ الى الدنيا فهل ستتعظين وتُكَفّرين عمّا قصرتِ في جَنب الله؟؟
ثمّ يوصي نفسه بجوارحه السّبعة: العَين والاُذن واللّسان واليّد والرّجل والبطن والفَرج، فهذه الجوارح مُنصاعَةٌ لكِ اليوم وفي خدمتك، فلا تقحميها في المعاصي، فإنّ لجهنَّم سبعة أبواب، لكلِّ باب جماعةٌ خاصةٌ من النّاس، يدخلون جهنّم منها، فعليك بالسيّطرة الدّقيقة على الجوارح لئَّلا تنحرف عن الطّريق القويم، والهدف المرسوم لها، وبذلك توصَد أبواب جهنم دونها، وتفتح أبواب الجنان لها؟.
ويُوصي النّفس بالمُراقبة لِجوارحه، للإستعانة بها في طريق الطّاعة لا المعصية، فهي نِعَمٌ كبيرةٌ مُحاسب عليها الإنسان غداً.
ونَجد في أدعية الإمام السجاد عليه السلام، تأكيداً لمسألة المُشارطَة في حركة الإنسان المنفتح على الله.
ففي الدّعاء، رقم (31) المعروف بدعاء التّوبة، يقول الإمام عليه السلام "وَلَكَ يا رَبِّ شَرطِي أَلاّ أَعُودَ في مَكْرُوهِكَ، وَضَماني أَنْ لا أَرجَعَ في مَذْمُومَكَ وَعَهْدِي أَنْ أَهْجُرَ جَمِيعَ مَعاصِيك".
وكذلك الحال في الآيات القرآنية، فإنّ أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، كانوا من خلال إرتباطهم مع الله تعالى، بنحو من العهدِ والميثاقِ، يُطبّقون نوعاً من المُشارطة على أنفسهم، في خط الرّسالة والمسؤولية، ففي الآية (23) من سورة الأحزاب، نقرأ: ﴿مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا﴾...1.
وكان البعض الآخر، ينقضون العهد مع الباري تعالى، بعد توكيدها، فورد في سورة الأحزاب، الآية (15): ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ الاَْدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْئُولا﴾.
وَوَرَد في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: "مَنْ لَمْ يَتَعاهَدْ النَّقْصَ مِنْ نَفْسِهِ غَلَبَ عَلَيهِ الهَوى، وَمَنْ كانَ في نَقْص فَالمَوتُ خَيرٌ لَهُ"2.
"فالمُشارطة" إذن: هي من الخُطى المهمّة لَتِهذيب الأخلاق، ولولاها لتراكمت سُحب الغفلة والغُرور، على قلب وروح الإنسان، ولَحادَت به عن الطرّيق القويم، والجادّة المستقيمة.
الخطوة الثّالثة: المراقبة
"المُراقبة" من مادة: "الرَقَبَة"، وبما أنّ الإنسان يحني رقبته عند مراقبة الأشياء والأوضاع، فاُطلِقَت على كلّ أمر يُحتاج فيه إلى المواظبة والتّحقيق.
وهذا المُصطلح عند علماء الأَخلاق، يُطلق على "مراقبة النّفس"، وهي مرحلةٌ تاليةٌ لمرحلة المُشارطة، يعني أنّه يتوجّب على الإنسان، وبعد مُعاهدته وُمشارطته لنفسه بالطّاعة للأوامر الإلهيّة، والإجتناب عن الذّنوب، عليه المُراقبة والمُواظبة على طهارته المعنوية، لأنّه في أدنى غفلة، فإنّ النّفس ستَنقُض كلّ العُهود والمواثيق، وتَسلُك به في خطّ المعصية مرّةً اُخرى.
وطبعاً يجب أن لا ننسى، أنّ الإنسان وقبل مراقبته لِنفسه، فإنّ الملائكة تراقب أعماله، فيقول القرآن الكريم: ﴿وإنّ عَلَيكُم لَحافِظِينَ﴾(الإنفطار:10).
فالحافظون هنا هم الذين يتولون عملية المراقبة لأعمال الإنسان، وذلك بقرينة الآيات التي تردُ بعدها، فتقول: ﴿يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ﴾(الإنفطار:12).
وفي الآية (18) من سورة (ق) يقول تعالى: ﴿ما يَلْفِظُ مِنْ قَول إِلاَّ لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾. وفوق هذا وذاك، فإنّ الله تعالى مِن ورائهم محيط بكلّ شيء، وفي الآية (1) من سورة النساء، نقرأ: ﴿إنَّ اللهَ كانَ عَلَيكُم رَقِيباًٌ﴾.
وكذلك في سورة الأحزاب، الآية (52): ﴿وَكانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيء رَقِيباًٌ﴾.
وفي الآية (14) من سورة العلق: ﴿أَلَم يَعْلَم بِأَنَّ اللهَ يَرى﴾.
والآية (21) من سورة سَبأ: ﴿وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَيء حَفِيظٌ ﴾.
ولكن المحلّقين في أجواء التّقوى وتهذيب النّفس، يراقبون أفعالهم وسلوكياتهم، قبل مراقبة الله تعالى لهم، ويعيشون الوَجَلَ والخَوف من أعمالهم وفعالهم، وفي مُراقبة دائمة، لِئَلاّ يصدر منهم ما يسلب تلك النّعمة، والحالة العرفانيّة التي يعيشونها مع الله تعالى شأنه.
أو بعبارة اُخرى: الرّقيب الباطني يعيش معهم وعلى يقظة دائماً، بالإضافة إلى الرّقابة الخارجيّة، وخوف الله تعالى.
وفي الحقيقة، فإنّ الإنسان في هذه الدنيا، حاله حالَ الذي يمتلك جوهرةً ثمينةً، يريد أن يقايضها بمتاع له ولعيالِه، ومن حَوالَيهِ السرّاق وقطاعُ الطّريق، ويخاف عليها من السّرقة أو البيع بِثَمن بَخْس، وإن غفل عنها لِلَحظة فسيُضَيّعها، وتذهب نفسه عليها حَسرات.
والسّائر في خطّ التّوبة والمراقبة، يعيش الحالة هذه أيضاً، فإنّ الشّياطين من الجِنّ والإنس مُترصّدون لِغوايته، هذا بالإضافة إلى النّفس الأمّارة، وهوى النّفس، فإذا لم يُراقب نفسه وأعماله، فلا يأمن معها، مِنْ أن تسرق جوهرة الإيمان والتّقوى، وينتقل من هذه الدنيا، خالي الوفاض وصفَر اليدين، وفي الآيات والرّوايات إشاراتٌ كثيرةٌ، وتلميحاتٌ متنوعةٌ حول هذه المرحلة، ومنها:
1- الآية (14) من سورة العَلَق: ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى﴾.
فهي إشارةٌ إلى مراقبة الله تعالى لَه، وعليه مُراقبة أعماله أيضاً.
وَوَجَّه في آيَة اُخرى الخطاب لِلمؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اْتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَد وَآتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون﴾(الحشر:18).
فَجُملة: ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَد... ﴾، تبيّن لنا في الحقيقة مفهوم المراقبة للنفس، على مستوى السّلوك والعمل.
وَوَرَد نفس المعنى، ولكن بشكل مُقتضب، في سورة عَبَس، الآية (24): ﴿فَلْيَنْظُرْ آلاِْنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾، (من الحلال والحرام)3.
2- ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، في تفسير الإحسان في الآية: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾، فقال: "الإحسانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَراهُ فَإِنْ لَم تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَراكَ"4.
ومن الطّبيعي فإنّ المُعايشة مع هذه الحقيقة، وهي أنّ البّاري تعالى معنا أينما كُنّا، والرّقيب علينا، من شأنه أن يخلق فينا روح الرّقابة، ونكون معها دائبين على الإنسجام، مع خطّ الرّسالة من موقع الإلتزام.
3- ورد حديثٌ عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: "يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُهَيمِناً عَلى نَفْسِهِ مُراقِبَاً قَلْبَهُ، حافِظاً لِسانَهُ"5.
4- جاء عن الإمام الصادق عليه السلام: "مَنْ رعى قَلْبَهُ عَنِ الغَفلَةِ وَنَفْسَهُ عَنِ الشّهْوَةِ وَعَقْلَهُ عَنِ الجَهْلِ، فَقَدْ دَخَلَ في دِيوانِ المتَنَبِّهينَ ثُمَّ مَنْ رعى عَمَلَهُ عَنِ الهوى، وَدِيْنَهُ عَنِ البِدعَةِ وَمالَهُ عَنِ الحَرامِ; فَهُوَ مِنْ جُملَةِ الصَّالِحِينَ"6.
5- ما ورد في الحديث القُدسي: "بُؤساً لِلقانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِي وَيا بُؤساً لَمَنْ عصاني وَلمْ يُراقِبُني"7.
6- جاء في إحدى خطب أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: "فَرَحِمَ اللهُ إمرءاً رَاقَبَ رَبَّهُ وَتَنكَّبَ ذَنْبَهُ، وَكابَرَ هَواهُ ، وَكَذَّبَ مُناهُ"8.
7- وقد ورد في نهج البلاغة أيضاً: "فاتَّقُوا اللهَ عِبادَ اللهِ تَقِيَّةَ ذِي لُبٍّ شَغَلَ التَّفَكُّرَ قَلْبَهُ... وَرَاقَبَ فِي يَومِهِ غَدَهُ"9.
نعم فإنّ "الرقابة" على النفس أو المُراقبة لله تعالى، أو ليوم القيامة، كلّها تعكس حقيقةً واحدةً، ألا وهي النّظارة والرّقابة الفاحصة الدّقيقة الشّديدة للإنسان على أعماله، في كلّ حال وزمان ومكان.
وخلاصة القول: إنّ السّائر إلى الله تعالى، وبعد "المشارطة" مع نفسه وربّه، وبعد تهذيب النفس وتربيتها على طاعة الله وعبوديّته، عليه المراقبة والمداومة على العهد الذي قطعه على نفسه في خطّ التوبة، كالّدائن الذي يطلب من مدينه وفاء ديونه، فأيّ غفلة عن مخاطر المسير، ستعود عليه بالضّرر الفاحش، وتؤخره عن الرّكب كثيراً.
* الأخلاق في القرآن (الجزء الأول)، أصول المسائل الأخلاقية، آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي, المؤسسة الإسلامية, الطبعة الثانية/1426ه, قم.
1- بحار الأنوار، ج67، ص64.
2- بحار الأنوار، ج67، ص64.
3- هذا على ما جاء في بعض التّفاسير، وقد جاء في تفاسير اُخرى، أنّ المقصود هو النّظر والإعتبار بخلقة الله تعالى، لإنكشاف الآيات والملاحظات التّوحيدية عند الإنسان، ولا تنافي بين التّفسيرين.
4- كنز العمّال، ج3، ص22، ح5254; بحار الأنوار، ج25، ص204.
5- غُرر الحِكَم.
6- بحار الأنوار، ج97، ص68.
7- المصدر السابق، ج74، ص349.
8- اُصول الكافي، ج2، ص67.
9- نهج البلاغة، الخطبة 83، "الخطبة الغرّاء".
2009-07-29