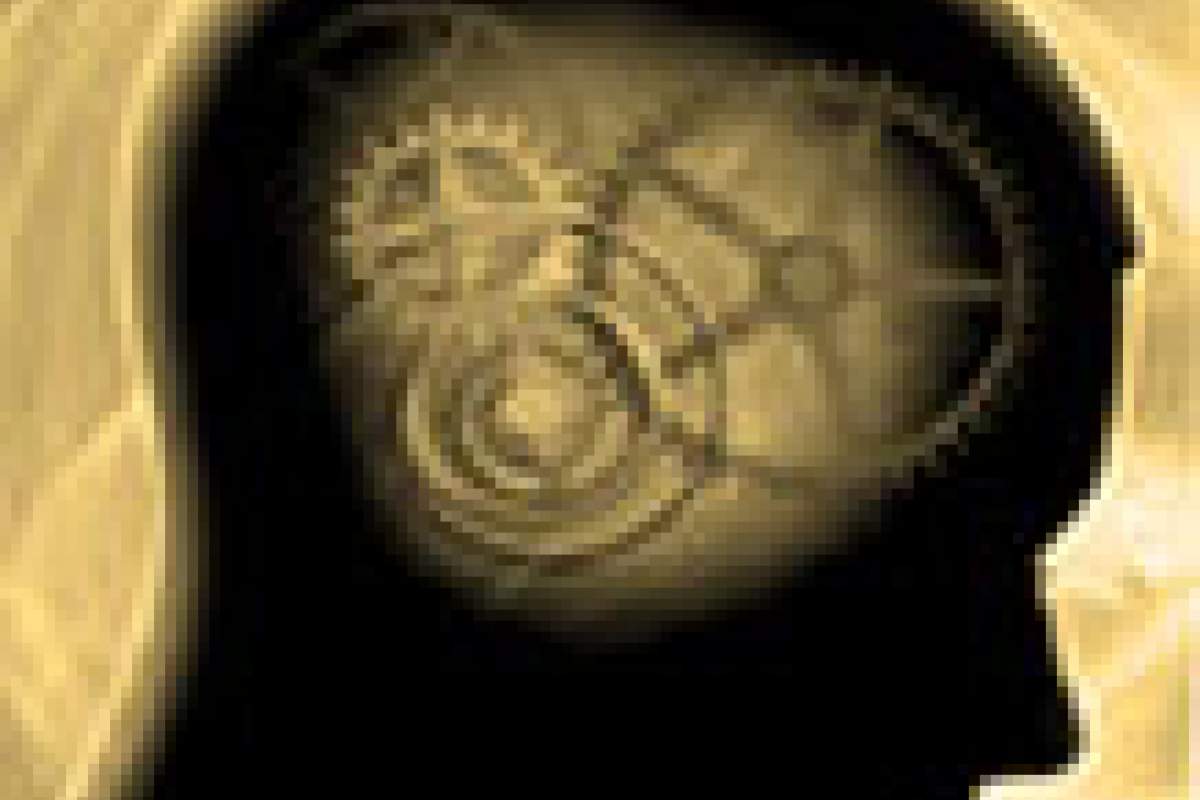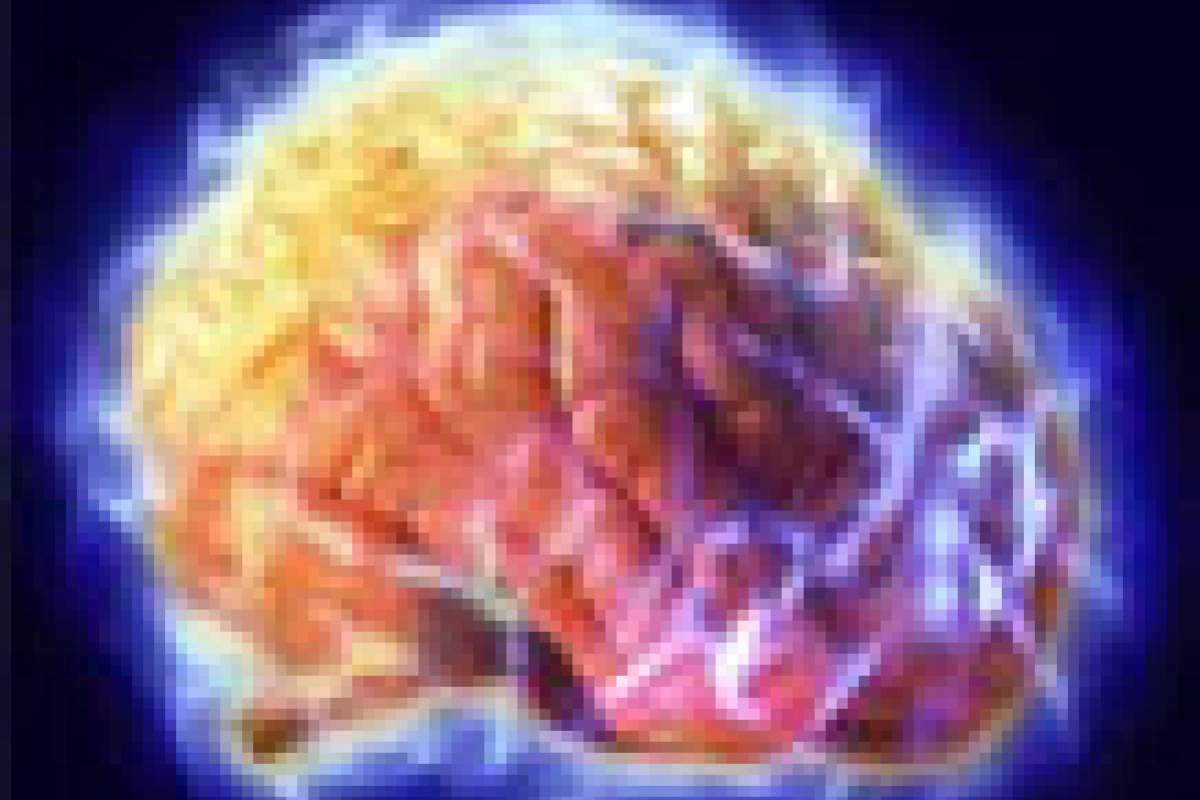تنمية القابليات
إن التربية بشكل عام تختلف عن الصناعة بفارق أساس يتمكن الإنسان عن طريقه من معرفة التربية، الصناعة عبارة عن (الصنع) أي وضع شيء أو بعض الأشياء تحت نظام للتعديل والتشذيب وإيجاد ربط بين الأشياء وقواها، ليصبح ذلك الشيء مصنوعا من مصنوعات الإنسان، كقطعة الذهب التي نصنعها خاتماً ونضفي عليها شكلاً متسقا...
عدد الزوار: 708
إن التربية بشكل عام تختلف عن الصناعة بفارق أساس يتمكن الإنسان عن طريقه من معرفة التربية، الصناعة عبارة عن (الصنع) أي وضع شيء أو بعض الأشياء تحت نظام للتعديل والتشذيب وإيجاد ربط بين الأشياء وقواها، ليصبح ذلك الشيء مصنوعا من مصنوعات الإنسان، كقطعة الذهب التي نصنعها خاتماً ونضفي عليها شكلاً متسقاً.
وأما التربية فهي عبارة عن التنمية، أي إظهار القابليات الكامنة في باطن الإنسان، والموجودة بالقوة فيه إلى مرحلة الفعلية، ولذا تصدق التربية فقط على ذات الأرواح كالنباتات والحيوانات والإنسان، وان استخدمنا هذه الكلمة في غير ذوات الأرواح فيكون ذلك مجازاً، وليس المفهوم الواقعي أننا ربينا ذلك الشيء، إذ لا يمكن تربية قطعة من الحجارة أو المعدن كما نربي نبتة أو حيواناً أو إنساناً، إن هذه التنميات معناها تفتح وتفجر القابليات الكامنة في تلك الموجودات، والذي يصدق فقط في الكائنات الحية، ومن هنا يتضح أن التربية يجب أن تكون تابعة للفطرة ولطبيعة الأشياء، فإن أردنا أن يتفتح شيء فلابد من السعي لإظهار القابليات الكامنة فيه، وأما لو فقدت القابلية من شيء فمن الطبيعي عدم إمكان إبرازه وإظهاره وتنميته، فمثلاً لا توجد قابلية التعلم لدى الدجاجة، ولذا لا نتمكن من تعليم الدجاجة درس الرياضيات ومسائل الحساب والهندسة إذ لا يمكن إظهار القابلية المعلومة فيها، وأيضاً يتضح من هنا أن الخوف والتهديد والإرهاب ليس من عوامل التربية في الإنسان (التربية بمعنى التنمية) يعني لا يمكن تنمية استعداد أي إنسان عن طريق أخافته وضربه وإرعابه وتهديده، كما أنه لا يمكن تنمية شجيرة الورد وجعلها مزهرة عن طريق القوة بأن نقتلها حتى تعطي ورداً أو نمسك البرعمة التي نريدها أن تنمو بأيدينا ونسحبها بالقوة لتنمو، فليس نموها بالسحب وليس التوسل بالقوة مجدياً هنا، بل لا يمكن ذلك إلا بوساطة الطرق الطبيعية، وهي احتياجها إلى قوة الأرض والتربة والماء والهواء والنور والحرارة، مع مراعاة اللطف والرقة والدقة، وكذلك الناحية التربوية للبشر إذ لا يكون الخوف والإرعاب عاملاً للتنمية.
مراعاة حالة الروح
في نهج البلاغة (الكلمات القصار) وردت جملة في ثلاثة أماكن بهذا المعنى: إن للقلوب شهوة واقبالاً وادباراً، فاتوها من قبل شهوتها وإقبالها فإن القلب إذا أكره عمي.
ويقول في الحكمة (188): "إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة": (والمراد من القلب هنا الروح).
وفي الحكمة (304) التي يتضح منها أنها ناظرة إلى العبادات وأنها أيضاً لا يمكن فرضها على الروح، بل يجب إدخالها إلى الروح بلطف ويستغل ميلها وانبساطها، يقول: "إن للقلوب إقبالاً وإدباراً، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض".
إن هذه الأمور بأجمعها تشير إلى وجوب ملاحظة الروح ومراعاتها جيداً حتى في العبادة، فإن العبادة أيضاً لو فرضت على روح الفرد، فعلاوة على أنها لا تخلف أثراً حسناً فإنها قد تخلف أثراً سيئاً.
تعبير رَسل
إن "رسل" في كتابه: (الزواج والأخلاق- وهو إنسان أديب قبل أن يكون فيلسوفاً، وشاعر يستخدم في تعابيره كلمات أدبية وشعرية كثيرة- يعبر عن التربية المبتنية على أسس من الخوف والارعاب "بتربية الدببة".
"إن الإحساس بالذنب والندم والخوف لا يجب أن يستولي على حياة الطفل1 يجب أن نرى الفرح ظاهراً على الأطفال والبسمة على شفاههم ولا ينبغي حرفهم عن معرفة الأمور الطبيعية، وما أكثر من عدوا التربية نموذجاً آخر لتدريب الدببة في السيرك، نعلم كيف يقومون بتعليم هذه الدببة الرقص، فإنهم يضعونها على صحيفة حديدية حارة ويزمرون لها، فتقوم بالرقص، لأنها لو استمرت في وضع أرجلها على الأرض فسوف تحترق، نظير هذا الأمر يحصل للأطفال عندما يقعون تحت لوم الكبار لأسباب تتعلق بأعضائهم الجنسية، إن هذه الملامات ستشوشهم فيما بعد وتشقيهم في حياتهم الجنسية"2.
الخوف عامل للحد من التمرد
لابد هنا من توضيح مسألة عامل الإخافة والإرعاب سواء في تربية الطفل الفردية أو على صعيد تربية مجتمع الكبار، فهل أن الإخافة والإرعاب هما عامل للتربية (بمفهوم التنمية)؟ وهل يمكن للخوف أن يكون عاملاً لإنماء روح الإنسان؟ كلا فليس من خصائص الخوف أن يكون عامل نماء.
وثمة بحث آخر وهو هل أن الخوف جزء من العوامل التي ينبغي أن يستفاد منها من أجل تربية الطفل أو المجتمع أم لا؟ الجواب: نعم ولكن ليس من أجل الإنماء وتربية القابليات، بل من أجل منع روح الطفل أو الكبير من بعض التمردات، أي أن الخوف هو عامل إخماد وليس عاملاً لتنمية وتربية القابليات الخلاقة، وإنما هو عامل حدّ (من نمو) القابليات المنحطة والمتدنية وعامل حد من التمرد.
ضرورة معرفة الطفل لأسباب التشجيع والتوبيخ
ينبغي استخدام عامل الخوف في بعض الموارد، وإننا مع اعتقادنا بأن الخوف ليس عاملاً مربياً ومنمياً إلا اننا نعتقد بلزومه، ولابد من الالتفات إلى أنه ينبغي أن يعلم الطفل بشكل كامل لماذا يشجع ولماذا يوبخ؟ فإن لم يفهم الطفل لماذا شجع وبالأخص لماذا وبخ ستضطرب روحه، وقد أصبح معلوماً أن أكثر الأمراض النفسية ناتجة من أثر التخويف أو الضرب والإرعاب بلا سبب.
أنقل لكم مثالاً يوجد نظيره في الحديث، لنفرض أن أمّاً في مجلس ما، جلس طفلها في حجر صديقتها، والطفل لا يفهم أنه لا ينبغي عليه أن يبول، فإن عملية الإدرار عنده كشرب الماء فلا فرق لديه سواء بال في حجر والدته أو في حجر صديقتها، فعندما يبلل صديقتها تغضب الوالدة وتقوم بضربه، وبديهي أن الصبي لا يلتفت إلى ان هذا الضرب كان سببه بوله في هذا المكان، فتكون النتيجة أنه كلما تحصل له حالة الإدرار تبدو عليه حالة من الاضطراب، ويدخل الخوف روحه، ويغدو بعد ذلك خائفاً من فعله الطبيعي، هذا ومن الممكن أن يؤدي إلى أعراض روحية وجسمية، لأن فعل الأم من وجهة نظر الطفل يعد إخافة غير منطقية، وإن كان من وجهة نظر الأم له منطق.
ولذلك نرى في أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أحياناً يأتوه بطفل ليقرأ دعاءً في أذنه مثلاً وفي تلك الحال بال في حجره الشريف، فغضب أبواه، فقال الرسول: لا ترزموه أي لا تقطعوا بوله، وكذلك بالنسبة إلى أبنائه حيث قال: لا ترزموا ولدي، نعم علموه أولاً عن طريق الملاطفة أن فعله هذا خطأ، وأن التبول على الفراش مثلاً أمر غير صحيح، وبعد أن يفهم هذا المعنى لو تبول عن عمد تكون هذه حالة تمرد وخبث سريرة، ومن الممكن أن تؤثر الخشونة في صنعه، ولكن مع عدم وصول الأمر إلى هذا الحد، فمن المسلم أن الخشونة لا تكون عاملاً إيجابياً.
وفي المجتمع الكبير يكون عامل الخشونة أمراً لازماً، ففي الموارد التي يعلم فيها الفرد الكبير أنه لا ينبغي أن يفعل شيئاً معيناً، ومع ذلك يخرج على القوانين ويتمرد فلا مانع من استخدام عامل الخشونة في هذه المواقع، لأجل الحد من التمرد، وعلى هذا فمع قولنا بعدم كون الخوف والإرعاب والخشونة عاملاً للتنمية، إلاّ أنّه عامل لابد منه لكبح التمرد.
أثر تفتح الروح
المطلب الآخر هنا هو أن أساس التربية في الإنسان ينبغي أن يبنى على تفتح الروح، ولكن هل تختلف الأعمار في هذه النظرة أم لا؟ الفرق مسلّم، فبعض الأدوار لها ظرف أكثر مناسبة وملائمة للتفتح، وهي دورة ما بعد السبع سنين التي اعتنت بها الأحاديث ليلتفت فيها إلى تربية الطفل- هي المدة من سبع سنين إلى ثلاثين سنة- دورة مناسبة جداً لتفتح الروح بالنسبة إلى أنواع القابليات: القابلية العلمية، القابلية الدينية، والقابلية الأخلاقية، ولذا نرى أن أفضل أدوار عمر الإنسان هي فترة دراسته، لأنها أوان تفتح روحه، وهو فيها يستقر في محيط تزداد فيه معلوماته وأفكاره وتنمو عواطفه وذوقه، وبالنسبة للطلبة تكون هذه الفترة ذكرى جيدة جداً، إن الذين قضوا عدة سنوات في الدراسة يذكرونها إلى آخر حياتهم، مع أنهم في تلك الآونة لم يكونوا في وضع جيد من الناحية المادية وهم في أواخر عمرهم في وضع أفضل، ولو ظل الإنسان في هذه الفترة محروماً من الناحية العلمية والمعنوية، فسيكون مفتقراً إلى شيء لا يمكن جبرانه في سن الشيخوخة.
والمطلب الآخر وهو مطلب أساسي هو أنه ما الذي ينبغي تربيته في الإنسان من وجهة النظر الإسلامية؟ إن لدى الإنسان جسماً وسلسلة من القوى الجسمانية وله روح وسلسلة من القوى الروحية3. حسب مصطلحات علم النفس تكون القابليات الجسدية أيضاً سلسلة من القابليات، والقابليات النفسية سلسلة من القابليات الأخرى4.
التربية البدنية من وجهة نظر الإسلام
المسألة الأولى هي أنه هل عني الإسلام بتقوية الجسم وتربيته أم لا؟ من المحتمل أن يجيب شخص بالنفي، لأننا نعلم أن تربية الجسد وتنميته مذمومة في الإسلام، وبما أن المفروض أن التربية هي التنمية، فلا ينبغي تربية الجسد، لأن الإسلام قد ذم تربية الجسد، إلا أن هذه مغالطة لفظية، ففي الإسلام تكون تنمية الجسد بالمفهوم الصحيح للكلمة- وهي تقويته- وهي ليست فقط غير مذمومة وإنما هي ممدوحة.
مثلاً هل يرى الإسلام أن يعمل شخص عملاً يزيد من قوة باصرته أم أن يعمل عملاً يضعفها؟ لاشك في أن رأي الإسلام هو الأول، ولدينا أخبار وأحاديث كثيرة في أن لا تفعلوا الفعل الفلاني لأنه يضعف البصر وافعلوا هذا لأنه يقوي البصر، أو مثلاً في الدعاء الذي نقرأه في التعقيبات "اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني" فهل هذه تنمية للجسد؟ بل لو أقدم الإنسان عن عمد على فعل يضعف بصره يكون قد ارتكب جرماً، وكذلك لو فعل الإنسان فعلاً يبقي على أسنانه سالمة فعمله هذا مقبول بنظر الإسلام، بخلاف ما لو فعل شيئاً يؤدي إلى تسوسها عاجلاً وقلعها، لقد أوصى الإسلام بالسواك لتبقى الأسنان سالمة، وأكد أن الشيء الفلاني يزيد من قوة الرجل والشيء الفلاني يزيد من قوة السمع، وأكل الشيء الفلاني حسن لأنه يقوي المعدة.
وحيث دعا الإسلام إلى تقوية الجسد بمعنى جعله سالماً وقوياً، فما معنى قوله: أن الإنسان لا ينبغي له أن يأكل كثيراً، وتأكيده على قلة الأكل وفوائدها "المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء"5، إن كانت هذه تنمية للجسد فليأكل الإنسان كثيراً حتى ينفجر، كلا، فإن تربية الجسد بمعناها الحقيقي هي تقويته وابقاؤه سالماً، وهي ممتدحة بلا شك ومن ضروريات الإسلام، بل إن فلسفة كثير من الأمور الأخرى من قبيل النظافة والأغسال وجميع الأوامر في رعاية الصحة الموجودة في الإسلام ما هي إلا تقوية للجسد، إن ما أسميناه عجالة تنمية للجسد هو نفسه تنمية للنفس، فعندما نقول: إن الإسلام يعارض تنمية الجسد، فإنما نريد بذلك تنمية الشهوة، ولا شك أن الإسلام يعارض ذلك، فما أكثر تنميات الجسد التي تؤدي إلى ضعفه، إنّ من ينمّي جسده بمعنى تنمية الشهوة ويكون دائماً وراء اللذات الجسمانية، فإن أول أثر لأعماله هو تخريب جسده واضعافه، إن التنمية الحقيقية للجسد تلازم تحمل أنواع المحروميات الجسدية، لأنها لا (تلائم) تنمية الجسد، فإذن علينا أن لا نشتبه فنتصور أن محاربة الإسلام لتنمية الشهوة والنفس- بسبب تسميتنا هذه الأمور تنمية جسدية- محاربة لتنمية الجسد الواقعية، وجعله قوياً ونشطاً.
وأما الشخص الذي كل همه تقوية جسده، فالنقص في عمله ليس من جهة أنه أقدم على تقوية جسده، ولم يترك أسنانه تتسوس وتخرب، بل لأنه أهمل الجوانب الأخرى، إن الشيء الذي يكون سيئاً في هؤلاء الأشخاص هو مسألة (الحصر)، أضرب مثلاً: لو شاهدتم طفلاً منهمكاً في اللعب دائماً ويقضي وقت الأعمال الأخرى أيضاً باللعب فانكم حتماً ستتساءلون، ولكن هذا ليس معناه أنكم تخالفون لعب الأطفال بشكل مطلق، فلو أن هذا الطفل قد ترك اللعب يوماً فستقومون بعرضه على الطبيب، فإذن لو أراد الإنسان أن يصرف جميع وقته في تنمية جسده فإنه يمارس عملاً غير صحيح، ولكن ليس من جهة أنه تقوية للجسد، بل لإضعافه سائر الجهات الاُخرى، بيد أن إضعاف الجسد بالطرق غير الإسلامية- كالطريقة الهندية المعروفة- التي لا تعني مخالفة تنمية الشهوة والنفس فحسب، بل مخالفة حتى تقوية الجسد، ويقولون: ينبغي الابقاء على ضعف القوى الجسدية، فهذا أمر لا يقره الإسلام، ولكن لا يوجد شك في أن تقوية الجسد وتربيته ليست هدفاً في نظر الإسلام، وإن كانت أمراً مطلوباً على أنه وسيلة، أي أن الإنسان عندما يعدم الجسم السالم والقوي سوف يفقد الروح السالمة، نقف عند هذا الحد لنتكلم عن الجوانب الروحية.
القابليات الروحية لدى الإنسان
قلنا: إن التربية بمعنى تنمية القابليات العقلية، ومن الناحية العلمية ينبغي لنا أولاً أن نرى ما هي القابليات الإنسانية الكامنة في الإنسان، والتي ينبغي عليه إظهارها؟ ثم ننظر بعد ذلك إلى أنه ما هي العناية التي أولاها الإسلام لذلك؟ وما هو منطقه تجاهها.
نظرت مذاهب مختلفة لهذا الأمر من جهات متباينة، إلاّ أن علماء النفس الذين بحثوا في الروح والنفس الإنسانية، ربما وضحوا الأمر بشكل أجمع وأشمل، إن آخر مقالة من أول عدد للنشرة السنوية "مكتب تشيع"- نشرت قبل حوالي اثنتي عشرة سنة- وقام بترجمتها المهندس بياني مع مقدمة للسيد المهندس بازرگان تحت عنوان (الدين، البعد الرابع لروح الإنسان) وهذه المقالة قد بينت واحدة من نظريات علم النفس الحديثة، وكانت تستند كثيراً على كلام (يونگ) وتقول: إن روح الإنسان لها أربعة أبعاد، أي أربع قابليات.
1- القابلية العقلية العلمية والبحث عن الحقيقة.
2- القابلية الخلقية (الوجدان الخلقي) ويرون هذا أمراً متأصلاً في الإنسان، وان الأخلاق قد خلقت في عمق طبيعة الإنسان وفطرته، أي خلق ليحب الآخرين ويخدم ويحسن، وإذا فعل سيئة- كما لو ظلم الآخرين- يشعر بتأنيب الضمير، والخلاصة: الوجدان الذي يجعله يرى الآخرين منه ويرى نفسه من الآخرين، موجود لدى كل شخص، المسألة المطروحة قديماً في أن الإحساس بالعطف على الآخرين والشعور بالميل إلى خدمتهم، هل له جذور في طبيعتنا أم هو مجرد تلقين من المجتمع؟ ولو كان متجذراً في طبيعتنا فبأية ناحية من طبيعتنا يتعلق؟ هل يرتبط بأنانيتنا؟ يعني عندما نتأثر لحال شخص هل نتأثر واقعاً على أنفسنا في أن سيكون لنا نفس مصيره، فنقدم على مساعدته لا إرادياً ليخدمنا عندما نبتلى بنفس ما ابتلي به؟ أم أنه إحساس مستقل عن كل هذا وإنما جبلنا على ذلك بلا أيما غرض وأنانية؟
3- البعد الديني، قيل في تلك المقالة: إن القابلية الدينية متأصلة في الإنسان، ويعبر عنها بحس التقديس والعبادة، وهي غير حس البحث عن الحقيقة والحس الخلقي، حس العبودية لحقيقة سامية ومنزهة، يريد الإنسان أن يخضع لها ويخشع، ويناجيها ويقدسها.
4- البعد الفني والذوقي: أو بعد الجمال، فالإنسان يحب الجمال من جهة أنه جمال طبعاً،بالإمكان أن نضيف بعداً خامساً وهو القابلية الخلاقة، فإن الإنسان خلق مبدعاً وخلاقاً ومبتكراً، وإن من جملة الأشياء التي يتمتع بها كل فرد، القدرة على الإبداع والابتكار والتجديد.
والآن علينا أن نرى التوجيهات التي أصدرها الإسلام لتربية حس البحث عن الحقيقة فينا؟ أي قوة التعقل والتفكير، وقد ذكرنا سابقاً أن الإسلام لم يهمل العلم والعقل، وفي القابلية الدينية أيضاً لاشك في وجود أوامر كثيرة، العبادات، الأذكار، الأدعية، الخلوات، الأنس، الاستغفار، والتوبة، كل ذلك يصب في هذا المجال.
الإسلام والفن
ولكن الشيء الذي يحتاج بحثاً أكثر هو أن الإسلام هل اهتم بالبعد الرابع لروح الإنسان؟ أي الاستعداد الفني، وهل اعتنى بالجمال أم لا؟ يتخيل البعض أن الإسلام جاف وبارد من هذه الناحية، وبعبارة أخرى: إن الإسلام يميت الأذواق، وطبعاً هؤلاء ادعوا هذه الدعوى لأن الإسلام لم يرحب بالموسيقى ومنع أيضاً بشكل مطلق الانتفاع بجنس المرأة وفنونها من قبيل الرقص والنحت.
ولكن الحكم بهذا النحو غير صحيح، إذ علينا أن نتأمل في الموارد التي حاربها الإسلام لنرى هل أن الإسلام حاربها من جهة جمالها أو لاقترانها بأمور أخرى منافية لمصلحة الفرد والمجتمع الإنساني؟ ولنرى هل حارب الإسلام الفن في غير هذه الموارد الممنوعة أم لا؟
الموسيقى
إن مسألة الموسيقى والغناء مسألة مهمة، وإن لم تبين حدود الغناء، إن (الغناء) مضرب مثل الفقهاء والاُصوليين في المسائل والعناوين ذات الموضوعات المجملة، أي التي لم تبين حدودها، يقولون: في بعض الموارد يجري أصل البراءة، من قبيل مورد فقدان النص أو اجماله أو التعارض بين النصين أو في الشبهة الموضوعية، وعندما يريدون أن يمثلوا لإجمال النص يذكرون الغناء، ويوجد طبعاً قدر متيقن في الغناء، وهو ما أوجب خفة العقل أي يهيج الشهوات بحيث يسقط العقل من كونه موجهاً بصورة مؤقتة، وله خاصية شرب الخمر أو القمار (فهذا يكون غناءً) وتعبير خفة العقل هو تعبير الفقهاء ومن بينهم الشيخ الأنصاري، إن ما هو مسلّم، ان الإسلام أراد من العقل أن يكون حارساً للإنسان وحافظاً له، وقد أثبتت التجربة أن الأمر من هذا القبيل.
قبل مدة كتبت جريدة عن زوج وزوجته انتهى أمرهما إلى الطلاق والمحكمة، وكان الزوج يريد تطليق زوجته بدليل أنها تعهدت إليه أن لا ترقص في مجلس يحضره الرجال الأجانب، إلا أنها رغم ذلك رقصت في حفلة عرس، وصدقت الزوجة كلامه وأضافت: إنها تجيد الرقص، وأنهم عزفوا نغمات في ذلك المجلس طربت لها، فإنها قامت دون اختيار منها وشرعت في الرقص.
الخليفة والجارية المغنية
كتب المسعودي في (مروج الذهب) أنه: في زمان عبد الملك أو أحد خلفاء بني أمية الآخرين كان اللهو والموسيقى رائجاً بشكل فاحش6، أخبروا الخليفة أن فلانا مطرب وله جارية جميلة وهي مطربة أيضاً وقد أفسدت جميع شباب المدينة، وإن لم تتداركوا أمرها فستفسد المدينة بأكملها، فأمر الخليفة أن تغل رقبة الرجل وأن يؤتى بهما إلى الشام، وعندما جلسا في حضور الخليفة، قال ذلك الرجل: إنه ليس متأكداً من أن ما يردده غناءً، وطلب من الأمير أن يجرب بنفسه، فأمر الأمير أن تقرأ الجارية، فشرعت تغني، وما أن غنت قليلاً حتى رأت رأس الأمير يهتز رويداً رويداً حتى وصل الأمر به الى أن يمشي على أربع، وهو يقول: تعالي يا روحي واركبي على ظهري.
حقاً ان الموسيقى لها قدرة عظيمة واستثنائية خاصة من جهة إزاحة ستار العفة والتقوى.
وأما في مسألة النحت، فكان منع الإسلام من جهة محاربته للأصنام، وكان الإسلام ناجحاً وموفقاً في هذه المسألة، فلو صنع للرسول وغيره تمثال لشاعت دون شك عبادة الأصنام مرة ثانية، وفي مسألة المرأة والرقص وغيره فالأمر واضح أيضاً، فإنه من جهة اهتمام الإسلام بمسألة العفة، ولذا لا يمكن من خلال هذه الموارد الحكم على الإسلام بأنه مخالف للذوق، فإن الإسلام لا يخالف الجمال ولا يحاربه بل يؤيده في بعض الموارد، في (الكافي) باب بعنوان (الزي والتجمل) فيه حديث يقول: (إن الله جميل ويحب الجمال)، وفوق كل هذا فإن جمال البيان نفسه أمر اهتم به الإسلام بأعلى مستوى، فما اعجاز الإسلام- أو في الاقل أحد موارد اعجازه- الا جمال كلام الله والقرآن الكريم.
*التربية والتعليم في الاسلام،الشيخ مرتضى مطهري،دار الهادي، بيروت لبنان،ط4 1426هـ-2005م، ص33ـ43.
1- كلامنا الآن يقتصر على كلمة الخوف هنا ولا بحث لدينا في الإحساس بالذنب.
2- إنه يؤكد كثيراً على مسألة الأخلاق الجنسية والحرية في المسائل الجنسية.
3- طبعاً لا يلزم علينا أن ننظر إلى الروح والجسم على أنهما جوهران
4- لروح الإنسان قابليات مختلفة، وفي الواقع تشعبات مختلفة- سنأتي على كل واحدة منها ونبحث فيها مجملاً.
5- سفينة البحار للقمي، ج1، ص345.
6- بدأ هذا الأمر في الحجاز ومكة والمدينة، وربما كان على يدي الإيرانيين الذين ذهبوا هناك وعملوا في البناء والقضايا الاقتصادية وكانوا ينشدون الالحان خلال أعمالهم تلك، وبعد ذلك شاع أمر الجواري.