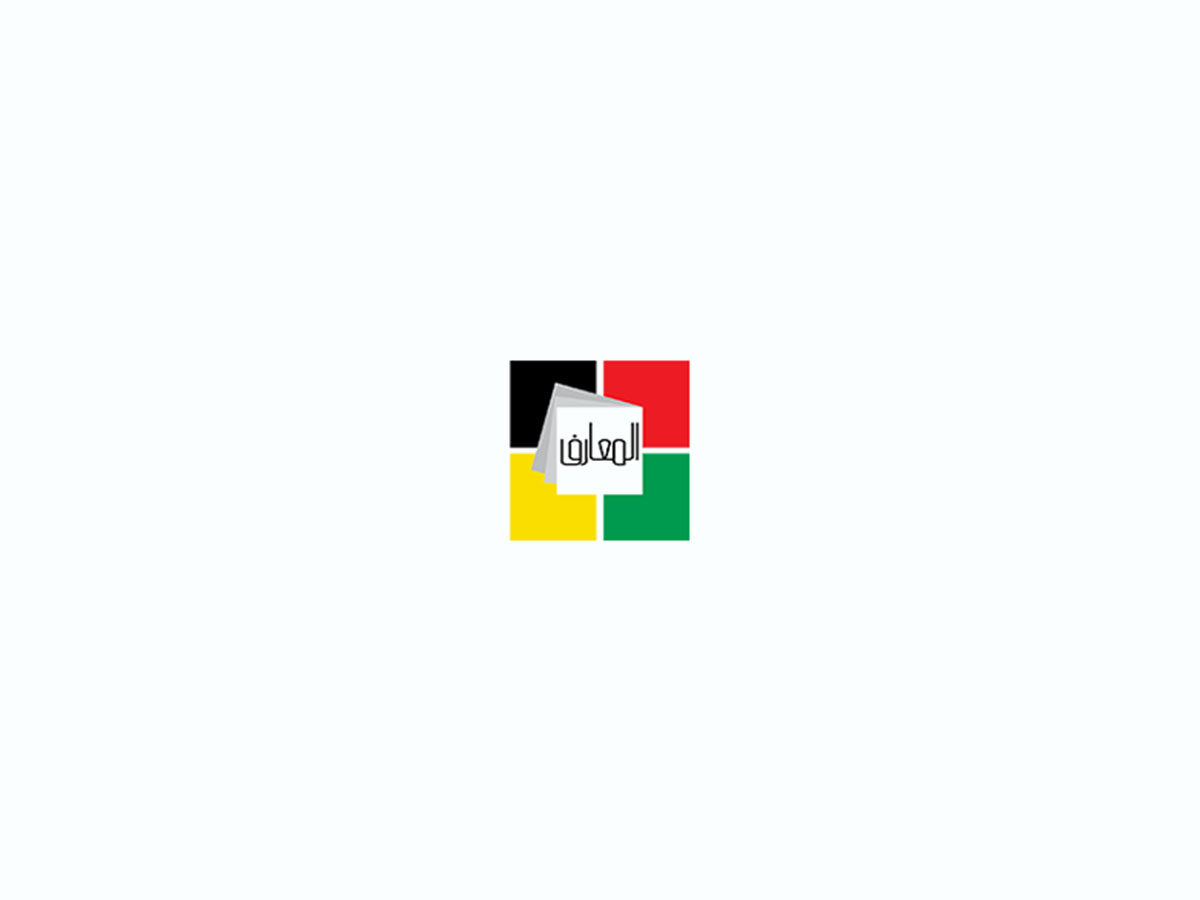الآيات التي تؤكّد على الشفاعة
وبناءً على ما ذكر فإنّ الأنبياء وأولياء اللَّه والشفعاء يستمدون مشروعية شفاعتهم يوم الجزاء من اللَّه تعالى، ويشفعون بإذنه، ومن البديهي أنّ إذنه منبثق من حكمته أي وفق أسس محسوبة، فإن كان هناك شخص لا يستحق الشفاعة فلا يؤذن بالشفاعة له (احفظوا هذا الكلام جيداً فسيأتي شرحه في الظرف المناسب).
عدد الزوار: 1108
قال تعالى:
﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة/
255).
وبناءً على ما ذكر فإنّ الأنبياء وأولياء اللَّه والشفعاء يستمدون مشروعية شفاعتهم
يوم الجزاء من اللَّه تعالى، ويشفعون بإذنه، ومن البديهي أنّ إذنه منبثق من حكمته
أي وفق أسس محسوبة، فإن كان هناك شخص لا يستحق الشفاعة فلا يؤذن بالشفاعة له
(احفظوا هذا الكلام جيداً فسيأتي شرحه في الظرف المناسب).
ومن الجدير بالملاحظة أنّ الآية المذكورة (وهي آية الكرسي) قد أكّدت هذه الجملة بعد
أن أقرّت مقام القيمومة والمالكية للَّه تعالى على كل ما في السموات والأرض،
وعلى هذا فانَّ هذه الشفاعة منبثقة من مالكيّته وحاكميته وقيمومته.
وبهذا فهي تبطل معتقدات عبدة الأوثان الذين يتذرّعون بعبادتها بدعوى أنّها تشفع
لهم عند اللَّه.
وورد نفس هذا المعنى بصورة اخرى ؛ إذ قالت:
﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ
الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ [طه:
109].
ولكن مَن المقصود مِن:
﴿مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ﴾؟ هنالك احتمالان:
الأول: هم الشفعاء بإذن اللَّه، والثاني: هم الذين تشملهم الشفاعة بإذن اللَّه.
إلّا أنّ الاحتمال الأول يبدو هو الأصح لأنّه يتسق ومضمون الآية السابقة (آية
الكرسي) فهناك كان الحديث يدور حول الإذن للشفعاء، وتمثل الآية اللاحقة شاهداً آخر
على صحّة هذا القول، ولهذا السبب اختار الكثير من المفسّرين هذا المعنى.
وينعكس كلا المعنيين في جملة
﴿وَرَضِيَ لَهُ قَولً﴾، الأول: إنّها تعود على
الشفعاء أي تُقبل شفاعة من رضي اللَّه قوله وشفاعته، وعلى هذا فإنّ الجملتين تؤكّد
إحداهما الأخرى.
والثاني: إنّ المقصود هو المشفوع له من الذين رضي اللَّه قولهم، وبعبارة اخرى هو
الذي كان عمله وكلامه ومعتقده صالحاً وصار موضعاً لرضى اللَّه لكي يُشفع له، ولكن
بما الجملة الأولى تقصد الشفعاء، فمن الأنسب أن تكون الجملة الثانية إشارة إلى
ذلك أيضاً، لتكون عودة الضمائر على وتيرة واحدة.
وعلى جميع الأحوال تشكّل الآية دليلًا واضحاً على وجود الشفاعة بإذن اللَّه،
لفريق من المؤمنين.
وقد بيّنت الآية السابقة نفس ذلك المعنى بصورة اخرى إذ قالت:
﴿مَا مِن شَفِيعٍ
إِلَّا مِن بَعدِ إِذنِهِ﴾ فلماذا تعبدون الأصنام؟
﴿ذلِكم اللَّهُ رَبُّكُمَ
فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾.
وجاء نفس هذا المعنى في الآية الاتية بشأن شفاعة الملائكة، إذ تؤكّد أنّ شفاعتهم
تقبل بإذن اللَّه أيضاً، إذ ورد فيه:
﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا
تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: 26].
فالمكان الذي لا يستطيع فيه ملائكة السماء وبكل ما لديهم من عظمة من الشفاعة إلّا
بإذنه، فماذا نتوقع من الأوثان التي لا حس لها ولا تمتاز بأيّة قيمة معنوية؟ أليس
من المخجل أن يقولوا نعبدها لتكون شفيعة لنا عند اللَّه؟!
والملفت هنا هو استخدام كلمة «كم» للتعبير عن أهميّة الموضوع، وهو ما يُستخدم عادة
للكثرة وهو موسوم هنا بطابع العموم، وجاء في الآية كذلك تعبير «في السموات» وهو
دلالة على علو مقامهم، ووردت كذلك كلمة «شفاعتهم» بصيغة الجمع لكي يفهم شفاعتهم
جميعاً لا أثر لها إلّا بإذن اللَّه ورضاه.
ولعل التأكيد على الملائكة دون بقية الشفعاء جاء هنا لأنّ فِئة من العرب كانت
تعبد، الأوثان أو أنّ المقصود: فإن كانت شفاعة الملائكة لا تتحقق ولا تنفع إلّا
بإذن اللَّه، فماذا يُتوقع من الأصنام الجامدة؟
والفارق بين «الإذن» و «الرضا» هو أنّ الإذن يُطلق حين يُعلن المرء عن رضاه، لكن
الرضا منوط بالباطن، وانطلاقاً من أنّ الرضا قد يكون مفروضاً أحياناً وعارٍ عن
الرضا الباطني، فقد ورد الاثنان معاً في هذا الموضع ليتم تأكيد الغرض رغم أنّ الفرض
على اللَّه لا يمكن تصوره (جل وعلا) وأنّ رضاه مستوسق مع إذنه، (فتأمل).
هل أنَّ هذا الاذن مرتبط بالشفعاء أم بالمشفع لهم؟ فالآية التي نحن بصددها تحتمل
المعنيين، رغم أنّ معناها العام يبدو أكثر اختصاصاً بالشفعاء أي إنّ اللَّه يأذن
ويرضى لهم بالشفاعة.