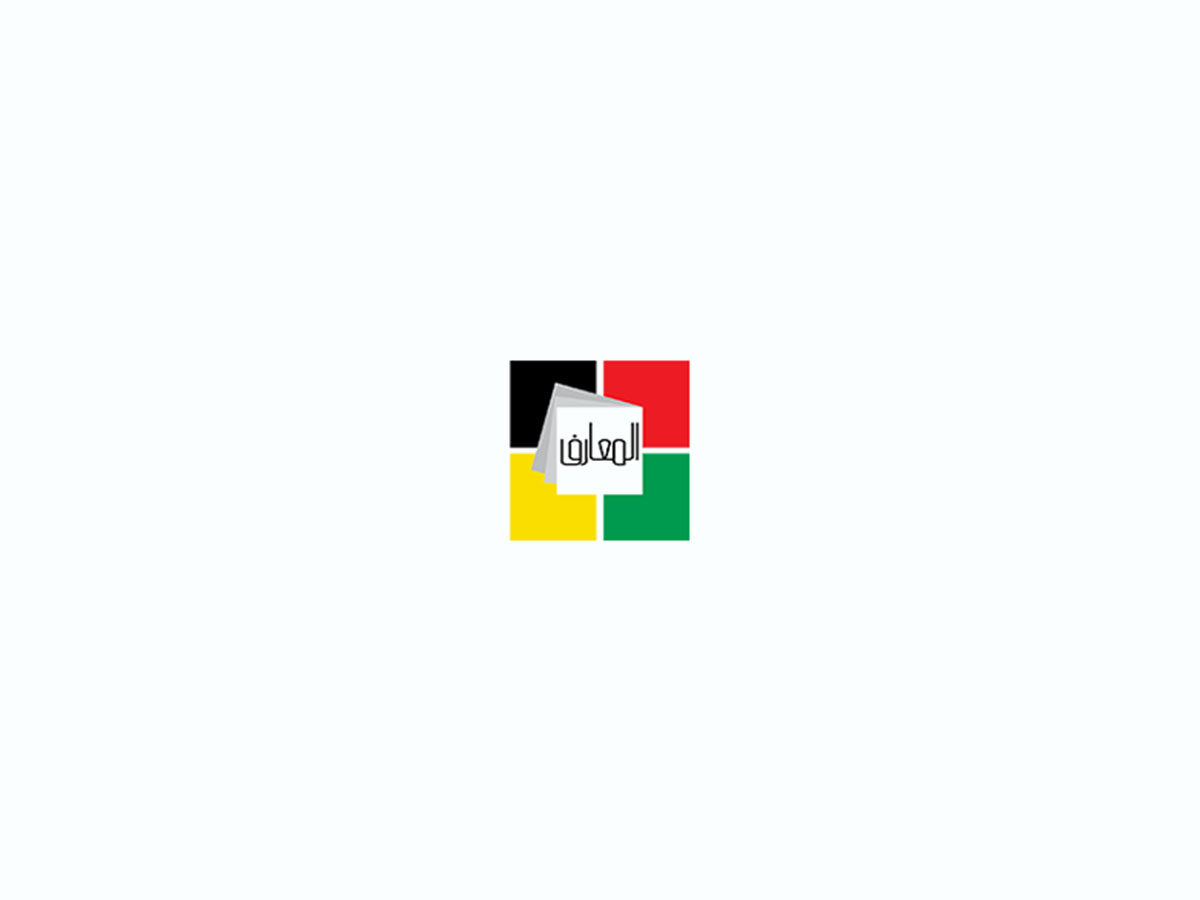الرحمة
(إمام الرحمة) العدل: هو القصد في الأمور، وكل ما يدل على التسوية، والمعادلة، والممائلة في الحقوق، والواجبات.
عدد الزوار: 823
(إمام الرحمة) العدل: هو القصد في الأمور، وكل ما يدل على التسوية، والمعادلة،
والممائلة في الحقوق، والواجبات.
والعفو: التجاوز عن الذنب. والرحمة تعم، وتشمل الإحسان، والعناية، والاهتمام،
والتيسير، والتسهيل، وتخفيف العقوبة عن المذنب، أو تركها من الأساس، ومحمد صلى الله
عليه وآله رحمه مهداة للعالمين بكل ما لهذه الكلمة من معنى، أجل لا رحمة، ولا رأفة
بالظالمين، والمجرمين ؛ لأنها تتحول جوراً على المجتمع، قال سبحانه: « وقاتلوهم حتى
لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين »..... «
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
».
ثم إن رحمته تعالى على نوعين: عامة وإليها أشار سبحانه بقوله: « ورحمتي وسعت كل شيء
»، وتشمل نعمة الوجود، والحياة، والعناية، والرزق، والإدراك، وإرسال الرسل، ورحمة
خاصة وإشار إليها جل وعز بقوله: « والله يختص برحمته من يشآء والله ذو الفضل العظيم
»، وهذه يمنحها سبحانه مضافة إلى تلك للأنبياء، والأئمة، والعلماء العاملين، وكل من
آمن بالله، واتقى معاصيه، وبكلمة كل من يستحق الثواب.
( وقائد الخير، ومفتاح البركة ) كل حاكم يثق به البريء، ويخافه المجرم فهو قائد بحق،
أما قائد الخير، والبركة فهو بالإضافة إلى العدل، كبير في نفسه، عظيم في همته، سريع
في نجدته، لا يهنأ بعيش إلا أن تمتلئ الأرض عدلاً، وأمناً، وبراً، وخيراً. ولهذه
الغاية أرسل سبحانه محمداً للعالمين كما نصت الآية: « ومآ أرسلناك إلا رحمة
للعالمين »، وفي الحديث: « أنا رحمة مهداة » ( كما نصب لأمرك ) أي للإسلام وسيطرته
حتى أذل الأديان بجهاد محمد، وحكمته ( وعرض فيك للمكروه بدنه ) بعث سبحانه محمداً
صلى الله عليه وآله إلى المشركين، والضالين، ليستأصل الفساد من جذوره، فيقضي على
العقائد الفاسدة، والتقاليد الموروثة، فامتثل، وبدأ يعيب عليهم دينهم، وعاداتهم،
ويتوعدهم بما أعد لهم من عذاب الله، فحاولوا جاهدين أن يثنوه بالحسنى عن عزمه فلم
يسمع، فأغروه بالملك، والمال فرفض. وعندها صمموا على إيذائه، والتنكيل به، وبمن
أتبعه من الناس، ولكنه صبر، واحتمل الكثير من المشقة، والمصاعب، وما من أحد ناصر
الحق بقول، أو فعل إلا ودفع ثمنه غالياً من نفسه، وأهله، أو من ماله، وعرضه حتى ولو
كان المتكبر على الحق فرداً لا فئةً، أو مجتمعاً، فكيف إذا ناضل الفرد الأعزل أمة،
أو شعباً ؟.
( وكاشف في الدعاء إليك حامته )، وهي الجماعة التي تحميه، وتذب عنه ( وحارب في رضاك
أسرته ) الذين اصروا على الشرك كعمه أبي لهب ( وأقصى الأدنين على جحودهم، وقرب
الأقصين على استجابتهم لك، ووالى فيك الأبعدين، وعادى فيك الأقربين ) قال الإمام
علي عليه السلام: « إن ولي محمد من أطاع الله، وإن بعدت لحمته أي نسبة وإن عدو محمد
من عصى الله وإن قربت قرابته »، وعلى هذا الأساس قرب محمد الأباعد المطيعين لله،
وأبعد الأقارب المتمردين على طاعة الله، وهذا هو شأن من أخرج الدنيا من قلبه (
وأدأب ) من الدأب بمعنى الجد في العمل، والإستمرار عليه ( إلى ملتك ) إلى دينك،
وشريعتك ( لأهل دعوتك ) وهم أهل بيته الأطايب، وعلماء الصحابة الذين حفظوا سنته
وأقواله، ونشروها من بعد.
( وهاجر إلى بلاد الغربة... ) كان المسلمون في مكة ضعافاً مغلوبين على أمرهم،
يقاسون المحن الرهيبة من أعداء الدعوة الجديدة، فهاجروا إلى المدينة، وكانت هذه
الهجرة فاتحة يمن، وخير للمسلمين، بل وللبشرية كلها حيث أصبح لدين العدل، والحرية
دولة قوية، ورادعة تكفل، وتصون لكل إنسان حقه، وكرامته من أي ملة كان، ويكون، ولا
سبيل عليه لأية سلطة حتى ينتهك حرمة الآخرين، وعندئذ يتسلط عليه الحق لردعه،
وتأديبه ( إرادة منه لإعزاز دينك، واستنصاراً على أهل الكفر بك... ) هذا هو الهدف
الأول، والأخير من دولة الإسلام: صيانة الحق لأهله، وردع العابث، والناكث ( فنهد
إليهم... ) أسرع إلى جهاد أعداء الله، والإنسانية، وفي نهج البلاغة: « فبلغ رسالات
ربه غير واه، ولا مقصر، وجاهد في الله أعداءه غير واه ولا معذر »، أي لا يعتذر.
( اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك... ) مقام محمد صلى الله
عليه وآله عند الله لا يعلوه مقام، بل، ولا يدانيه، ويساويه، لأن الجزاء من جنس
الأعمال، والآثار، وآثار محمد صلى الله عليه وآله هي عين آثار القرآن، والإسلام،
وعليه يكون هذا الدعاء، والطلب تماماً كالصلاة على محمد، وتمجيداً لعظمته، وخصاله،
وتحميداً لجهاده، وأفعاله، وتسبيحاً بفضله، وكماله. ( يا مبدل السيئات بأضعافها من
الحسنات إنك ذو الفضل العظيم الجواد الكريم ) لسبب موجب، كالتوبة، وإصلاح ذات
البين، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضعف، والضلالة إلى القوة،
والهداية.