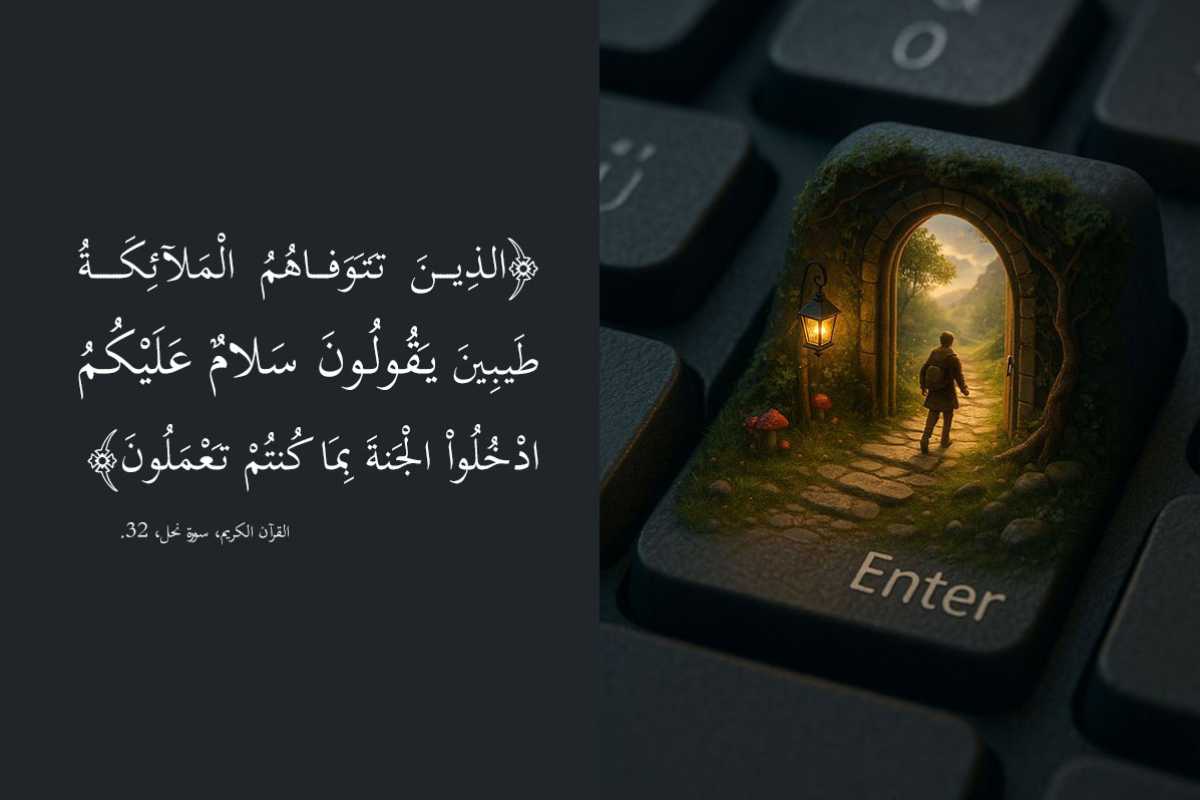سبب اختلاف القوانين الإلهية في المجتمعات الإسلامية
قلنا إن القانون الإلهي هو الذي ينبغي أن يسود في المجتمع الإسلامي ولا يحق لأحدٍ أساساً وضع قانون دون إذن من الله، فعلى كل مجتمع إسلامي وكل نظام إسلامي أن يتمسك بالقوانين الإلهية، وهذا الأمر لا يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والأشخاص.
هذا الموضوع يثير بشكل واضح تساؤلات تقول: إذا كان قانون الله واحداً، فلماذا تختلف القوانين في المجتمعات الإسلامية المختلفة؟ أو لماذا يطرح المقنّنون أو مراجع التشريع في مجتمع واحد، آراء مختلفة حول قانون الإسلام؟ أو نرى قانوناً يؤخذ به في مجتمعٍ ما مدة من الزمن ثم يتغير بعد ذلك؟ وبتعبير آخر، لو كان ينبغي أن يؤخذ في المجتمعات الإسلامية بالقانون الإلهي الموحد فما الذي يسوّغ الاختلاف أو التغيير في القوانين؟ ينبغي أن ندرك أن للقانون الإلهي صفة ثبوتية وأخرى اثباتية، فحقيقة قانون الله هي تلك الإرادة التشريعية الإلهية، أي أن ما يريد الله تعالى من عباده أن يعملوه هو قانون الله، ولكن ليس كل الناس عارفين بهذه الإرادة التشريعية الإلهية، أي أنهم لا يعرفون في كل مكان وكل زمان ماذا يريد الحق تعالى، فهم إذاً لا يختلفون فيما تعلقت به إرادة الله (أي الصفة الثبوتية)، وفي مجال الإثبات فقط يمكن حدوث الاختلاف، فلو تخلّى الأفراد عن الميول النفسانية لأمكنهم رفع الخلافات بالطرق المحددة لذلك.
سبل اكتشاف قانون الله:
هناك سبل عدة تمكننا من اكتشاف إرادة الله وفهم قانونه:
1ـ العقل:
أحياناً يكتشف البشر إرادة الله تعالى بحكم العقل الصريح، فحتى لو لم يأتهم نبي ولم ينزل كتاب لهدايتهم، أو أن نبيّاً بعث وكتاباً أنزل لكنه لم يبلغهم لبعض الأسباب فإنهم يدركون بعقولهم الأمور التي يحظى برضى الله.
وقد يكون من أعم هذه الأمور قضية (العدل والظلم)، فصحيح أن مصاديق العدل والظلم غير واضحة في كل الأحوال، ولكن كل إنسان يفهم بعضها ويعرف أن مواضع العدل يحبها الله ومواضع الظلم يبغضها الله، فحتى لو لم يبلغ بعضهم القانون الشرعي فإنهم يدركون أن الله يرضى بهذا العمل ولا يرضى بذاك، فهنا يكتشف قانون الله بحكم العقل الصريح، ويستدل الفقهاء أيضاً في كثيرة من الحالات بـ (المستقلات العقلية) لإثبات الحكم الشرعي، ومن هنا نقول إن العقل أحد الأدلة الشرعية.
أما ما هو موقع العقل في الفقه الإسلامي؟ والى أي مدى يتمكن العقل من اكتشاف الأحكام الشرعية؟ فهذا ما يتطلب الكثير من البحث الذي ينبغي الخوض فيه في مجال آخر، ولكننا نعرف بشكل مجمل أن فقه الأمامية يعترف بأن كثيراً من أحكام العقل الصريحة (أي ما يطلق عليه في علم أصول الفقه اسم المستقلات العقلية) يمكنها أن تكون كاشفة للحكم الشرعي، وهذا أول السبل وأكثرها طبيعية لاكتشاف حكم الله. لنفترض أن أناساً يسكنون جزيرة ولم يبلغهم الإسلام لكنهم يعرفون على قدر عقولهم أية أعمال يقومون بها وأياً منها يمتنعون عنه لكي يرضى عنهم خالقهم، فمثل هؤلاء الناس يعدون مستضعفين تجاه الأحكام الشرعية لأنهم بعيدون عن مدى تبليغ علماء الدين وتوجيههم تجاه واجباتهم الفردية والاجتماعية، لكنهم مسؤولون تجاه ما تدركه عقولهم ويجب عليهم العمل بمقتضى ذلك وإلا فإنهم يعرّضون للعقاب لأن استضعافهم لا يتجاوز مدى عدم قدرتهم على اكتشاف الحكم الإلهي، أما حين يتوصلون إلى أمر بعقولهم ويوقنون بأنه يحظى برضى الله، فالعمل بذلك واجب عليهم، وكذلك لو علموا أن أمراً يؤدي إلى سخط الله فعليهم تركه. ومما ينبغي أن أؤكد عليه هنا أننا لا نقصد بفهم الأمور بوساطة العقل أن يأتي كل من خطر في ذهنه أمر فيقول إن عقلي يحكم بكذا فحكم الله إذن كذلك، فهذه هي البدعة التي وردت في رواياتنا باسم الرأي والقياس وحوربت بشدّة، بل المقصود بحجية العقل هو الحكم العقلي القطعي الذي يدركه كل العقلاء من دون شك، ففي هذه الحال فقط يعدّ حكم العقل حجة ويكشف عن الحكم الشرعي.
2ـ الوحي:
السبيل الثاني لاكتشاف قانون الله هو (الوحي)، أي الكلام الذي أوحى به الله تعالى إلى نبيّه فنقله إلى الناس، فكلام الله في الإسلام هو القرآن وكان في الشرائع والأديان السابقة بصيغة كتب مثل التوراة والإنجيل وغيرهما أنزلت على أولي العزم من الأنبياء، وقد كانت هذه الكتب وحياً إلهياً يكشف عن إرادة الله التشريعية، أما بعد ظهور نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله) فالقرآن هو الذي ينبغي أن يأخذ به كل الناس.
3ـ أحاديث المعصومين:
أحاديث النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وكذلك أحاديث الأئمة المعصومين ـ سلام الله عليهم ـوفقاً لمعتقدات الشيعة تكشف بعد القرآن عن إرادة الله التشريعية التي هي في الحقيقة القانون الإلهي، أي حين يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) أو المعصومون الآخرون (عليهم السلام) بأداء أعمال أو ترك أفعال فهذا حجة على الناس، وقد ثبتت حجيته وفقاً لآيات صريحة وواضحة من القرآن الكريم، ونحن نسمي ذلك في المصطلح الفقهي (السنّة) وهي قول المعصومين وفعلهم وتقريرهم.
وهكذا لو أدركنا أمراً بشكل قطعي عن هذه الطرق أي العقل والوحي والسنة، فهو يكشف عن القانون الإلهي، وينبغي أن نضيف هنا أن هذه الأشياء الثلاثة لا تضاد بينها ولا تناقص، بل هي طرق للكشف عن حقيقة واحدة، أي أنه لن يكون أبداً أي تناقص أو تضاد بين حكم العقل القطعي وحكم القرآن أو السنة القطعي، وهذه هي قاعدة الملازمة المشهورة التي تقول: (كلما حكم به العقل حكم به الشرع وكلما حكم به الشرع حكم به العقل).
وكذلك فإن الأحكام التي يتم التوصل إليها عن هذه الطرق لن يعتريها الاختلاف أو التغيير والتبديل، إذ حين يكون نص حكم العقل قطعياً أو نص الآيات والروايات متواتراً فإن الأحكام التي ننسبها إلى الإسلام ستكون أحكاماً قطعية ولا مجال لأي اختلاف، ولو أن أي إنسان غير مغرض توصل إلى هذه الأدلة واستخدم عقله من أجل فهم الآية والرواية فهماً صحيحاً فسوف يبلغ رأياً يقيناً، وهذه من ضروريات الدين ومسلّماته التي عرفت في كل المذاهب وفي كل الأزمنة ولا خلاف فيها، ولو عارض أحدهم ذلك عدّ من أهل البدع وأنه يريد إيجاد شرخ في الدين وإلا فإن هذه الأمور لا تقبل الخلاف. ونحن نشاهد في الكتب الفقهية ـ سواء الشيعية منها أو السنّية ـ موضوعات لا خلاف حولها أبداً، فنراهم كلهم قد نقلوا واقعة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وفهموا منها معنى واحداً ولم يعتريهم في ذلك أي شك أو اختلاف، وهذه الأمور من مسلمات الدين، وبعض مواردها من ضرورياته التي بقيت محفوظة على طول التاريخ الإسلامي دون أن يحدث حولها أي خلاف وسوف تبقى كذلك، من ذلك، واقعة ربما لم تكن تخطر ببال أحد وهي الإجماع الذي أظهره مؤخراً فقهاء الإسلام ـ شيعة وسنة ـ حول كتاب (الآيات الشيطانية) وتبين أنهم يجمعون على القول إنه لو أن أحداً سبّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) فدمه مهدور، وهذا أحد أحكام الإسلام التي سوف تبقى ثابتة بشكل قطعي وهو مستفاد من سنة النبي (صلى الله عليه وآله)، وليس آية قرآنية أو حكماً قطعياً للعقل بل أمر مستند إلى سنة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، ولا يلاحظ بهذا الشأن أي خلاف بين المذاهب الإسلامية، وهكذا نجد أن أحكام الإسلام ليست كلها عرضة للاختلاف أو التبديل، بل هناك أحكام قطعية مثل الصلاة والصوم والحج و... تتمتع بالإجماع واليقين. وبتعبير آخر، هناك مجموعة من الأحكام والقوانين الإلهية ثابتة بالتأكيد ولا تقبل التغيير، وهي إما أنها مستندة إلى حكم العقل القطعي أو إلى حكم القرآن الصريح أو إلى السنة القطعية التي اكتسبت القطعية من حيث السند والدلالة معاً، وليس ثمة أي خلاف في هذه المجموعة من الأحكام السماوية، كذلك لم يحصل أي تغيير في فهمها ومعرفتها ولن يحصل بعد الآن، والذين زعموا حصول التغيير في هذا الصنف من الأحكام قد وقعوا في خطأ فاحش.
رأي الفقيه الأعلم:
وهناك حالات لا نملك فيها حكماً قطعياً للعقل ولا يمكننا أن نتوصل بشأنها إلى حكم قطعي من الكتاب والسنة، صحيح أنه يبدو أمامنا أمر مرجح من وجهة نظر العقل ولكن لا يمكننا أن نجزم بأن ذلك هو حكم الله وليس غيره، كذلك حين نراجع القرآن أو السنة من أجل فهم الأمر السماوي واستنباطه لا يحصل لدينا يقين في هل أن ما يعنيه الله تعالى أو النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) هو هذا الذي فهمناه، فما هو تكليفنا في مثل هذه الحالات؟ وماذا ينبغي لنا فعله؟ هنا ينبغي علينا أن نراعي (فعل العقلاء) الذي نستخدمه في المعارف الأخرى، ونقصد بذلك أن الإنسان في هذه الحالات التي لا يجد فيها معرفة عقلية قطعية أو معرفة نقلية قطعية يراجع (بحكم سجيته العقلائية) الخبراء أي المصدر الذي يحظى بقيمة لديه، فما اعتاد عليه العقلاء من البشر الذين يعرفون خيرهم وشرهم أن يراجعوا في كل عمل أكثر الناس خبرة ومعرفة ليحلّوا لهم مشاكلهم، ولما كان بحثنا يدور حول كيفية التوصل إلى حكم الله، فإن علينا أن نسمع في ذلك كلا ممن يلم إلماماً كاملاً بالمصادر الإسلامية، ومن تعمّق في الأدلة الشرعية ودرسها أكثر من غيره، ونجد بحوثه ودراساته أعمق مما لدى غيره، وهذا هو بالضبط ما سمي في الفقه بـ (تقليد الأعلم). على أية حال فالذي هو أعرف الناس بمصادر استنباط الأحكام يعد فهمه ـ بحكم العقلاءـ مما يعتدّ به لدى باقي الناس (حتى لو كان استنباطه غير قطعي بل استنباط أدنى درجة من اليقين والاطمئنان) كما هو الحال في سائر الموارد حيث كلما واجه العقلاء أموراً يجهلونها راجعوا فيها الخبير وغالباً ما لا يحصل لديهم يقين بكلامه لكنهم يثقون به إذ لا سبيل أفضل من هذا، وهكذا حين لا يمكننا التوصل إلى الدليل القطعي لا حيلة لدينا سوى الرجوع إلى أهل الخبرة، وقد تبرز بالطبع خلافات بين الخبراء وهو أمر طبيعي وحتمي إذ لا يمكن السيطرة على هذه الاختلافات إلا في عصر حضور الإمام المعصوم (عليه السلام)، أما في عصر الغيبة التي لا يمكن للناس الاتصال به (عليه السلام) فمن الطبيعي حدوث مثل هذه الاختلافات، وهذا أمر لا يختص بالدين وحده بل نجد نماذج كثيرة منه في كل المذاهب غير الدينية وفي كل الأنظمة القانونية، فلنفترض مثلاً أن شعباً يحترم دستور بلاده احتراماً كبيراً وقد أقرّه بكل ما أوتي من قوة، لكن هذا الشعب نراه يختلف أحياناً في فهم نص مادة من هذا الدستور، وهنا نراه يعين مرجعاً لتفسير الدستور فيرجع إليه مثل مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ أو مجلس الخبراء أو مجلس صيانة الدستور وهكذا نجد في كل بلد مرجعاً يؤخذ برأيه في تفسير الدستور. ثم إن هناك خلافاً يحدث بين المفسرين أنفسهم فنراهم في النهاية يأخذون جميعاً برأي واحد ويطبقونه ولا حيلة غير ذلك، إذ حين لا يمكن التوصل إلى معنى النص ينبغي الرجوع إلى خبير أكثر بصيرة ومعرفة من غيره والوثوق بكلامه، ولو حدث بعد حين أن أبدى خبير آخر رأياً أكثر قبولاً فإنه يؤخذ برأيه، وهذا الكلام لا يعني أن حكم الله قد تغير، لأن الحكم الإلهي ثابت ولم يتغير من حيث الإثبات، ولكن ذلك لا يعني أيضاً أن كل الأحكام الإلهية عرضة لمثل هذه التغيرات والتبدلات، بل إن الأحكام الظنية التي نثبتها بالأدلة الظنية هي وحدها التي تتعرّض للاختلاف، وفي مثل هذه الحالات ينحصر سبيل رفع الاختلاف في أن يؤخذ من بين الآراء المطروحة بالرأي الذي يصدر من أكثر الناس خبرة، وهذا أمر تقتضيه السجيّة العقلائية للبشر وهو الذي يؤخذ به في فقهنا أيضاً.
وهكذا فتقليد الأعلم والرجوع إلى رأي الفقيه الأفقه والأبصر والأكثر وعياً وإحاطة بالمصادر الفقهية واجب على الآخرين حتى لو طرح فيما بعد رأي آخر أو تغير رأي هذا الفقيه أو ظهر فيما بعد فقيه آخر فأثبت خطأ رأي هذا الفقيه، فالاختلاف الذي يحدث في الفتوى والتغيير الذي يحصل في آراء الفقهاء أو حين يصرح مرجع تقليد في بلد معين بشيء ويصرح مرجع آخر في بلد آخر بشيء غيره فيأخذ هؤلاء برأي مجتهدهم إذ عرفوه أعلم من غيره، ويأخذ أولئك برأي مجتهدهم بعد أن رأوا أنه هو الأعلم، هذه الاختلافات لا تلحق ضرراً بطاعة الناس لحكم الله، أي حين يكون رأي الفقيه مطابقاً للواقع فإن الله تعالى يتقبّله منهم، وحين تكون مخالفاً للواقع فهم معذورون لأنهم ملزمون في الظاهر باتباع رأي هذا الشخص ولا ضير عليهم في ذلك، وهذه هي حجيّة رأي الأعلم للمقلدين. والاختلاف بين مراجع التقليد أو بروز رأيين من مرجع تقليد واحد ليس قليلاً، بمعنى أننا نجد مرجعاً قد أعطى رأياً وبعد ذلك أدرك (بعد تأمله أكثر من ذي قبل أو عثوره على رواية لم يعثر عليها من قبل أو لأي سبب آخر) أن رأيه السابق كان خطأ، ففي ذلك الزمان يكون الرأي السابق للمرجع حجة على الناس والآن حيث توصل إلى رأي جديد فهذا الرأي الجديد يصبح حجة على الناس. وقد مرّ بنا أن هذا الأمر لا يختص بالمذهب الشيعي أو الدين الإسلامي أو الأديان الأخرى بل هو أسلوب عقلائي للاستنباط من النصوص التي يحصل خلاف في فهمها، ففي مثل هذه الحالات اعتاد كل العقلاء أن يرجعوا إلى الخبراء من ذوي الاختصاص.
الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي (قدس سره)
2021-06-17