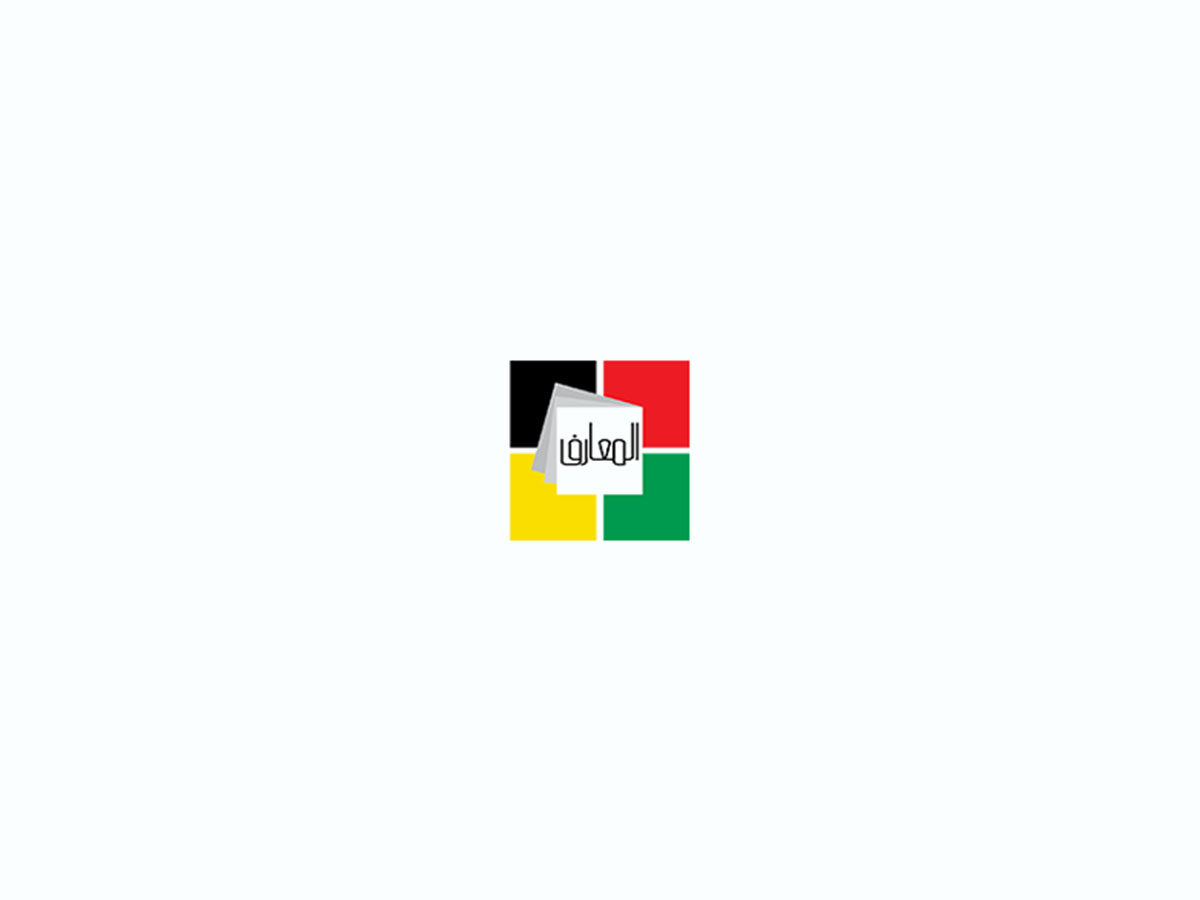المثل والقيم المعنوية هي قاعدة مشروعنا الحضاري للتقدم
المثل والقيم المعنوية هي قاعدة مشروعنا الحضاري للتقدم
عدد الزوار: 336
كلمة
الإمام الخامنئي في طلبة جامعة فردوسي بمناسبة زيارته مدينة مشهد المقدسة.الزمان:
25/2/1386هـ. ش ـ 27/4/1428هـ.ق ـ 15/5/2007م.
المثل والقيم المعنوية هي قاعدة مشروعنا الحضاري للتقدم
الإنسان في
الإسلام: حر مسؤول وخليفة الله في الأرض
وهنا نتمهّل قليلاً، لكي أخوض معكم في حديث حول المعرفة الإسلامية.
إنّ للنظرة للإنسان في الإسلام زاويتين تكمل إحداهما الأخرى. ويمكن لهذه الحقيقة أن
تكون قاعدة وأساساً لكافة قضايا بلادنا ولجميع المشاريع التي نودّ القيام بها من
أجل غدنا ومستقبلنا. فإحدى هاتين الزاويتين هي تلك التي ينظر الإسلام من خلالها إلى
الإنسان على أنه فرد, بما في ذلك أنا أو أنتم أو زيدٌ أو عمرٌ. أي أنّ الإسلام
يخاطبه بوصفه مخلوقاً يتمتع بالعقل والإرادة, فيحمّله المسؤولية ويجعل له شأناً وهو
ما سوف نشير إليه. وأما الزاوية الأخرى فتتمثل في النظرة للإنسان على أنه كل وأنه
جماعة إنسانية. وهما نظرتان منسجمتان وتكمل الواحدة الأخرى.
فالنظرة الأولى وهي التي ينظر لها الإسلام للإنسان كفرد, فانه يخاطبه بصفته فرداً
لا جماعة.
فالانسان هنا وكأنه يَعُبر درباً إذا ما استقام في السير عليه فإنه سيؤدي به إلى
ساحة الجمال والجلال الإلهي, وسيعرج به إلى الله عز وجل:
(يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ)1.
وهذا الطريق بإيجاز هو انسلاخ الانسان عن عبودية الذات إلى عبودية الله تعالى, وهذا
هو الطريق الصحيح والصراط المستقيم. ومسؤولية الإنسان الفرد في ذلك هو المُضيّ على
الطريق.
إنّ هذا الخطاب مُوجّه لكل واحد منّا, وعليه أن يلتزم هو به كفرد سواء التزم
الآخرون أو لم يلتزموا, وسواء عمّ الدنيا ظلمات الكفر أو نور الإيمان, فلا فرق, إذ
إنّ واجب كل فرد بصفته فرداً هو أن يسير على هذا الطريق
(عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)2.
فينبغي عليه القيام بهذه الحركة, وهي الخروج من الظلمات إلى النور, أي من ظلمات
الأنا إلى نور التوحيد.
فما هو السبيل إلى هذا الطريق؟ إنه أداء الواجبات والإبتعاد عن المحرمات.
إنّ إيمان القلب هو آلة الحركة على هذا الطريق, وإنّ متاعه الملكات والفضائل
الأخلاقية. وهي ما تُيسّر عليه عناء السير وتمنحه سرعة الانطلاق.
والتقوى هي الحلم والحذر من الانحراف عن الطريق. وهذا هو واجب الفرد في نظرة
الإسلام إلى الإنسان بصفته فرداً.
إنّ واجب الإنسان هو أن يقوم بهذا العمل ويسعى إليه, وهو ما كان مُخاَطباً به
دائماً في كل زمان ومكان, سواء أعاش في ظل حكومة الأنبياء أو تحت نيْرِ الطواغيت.
إنّ الإسلام يوصي الإنسان بالزهد في نظرته له باعتباره فرداً. ومعنى الزهد هو عدم
الاستغراق في متاع الدنيا وزخارفها, ولكنه في الوقت ذاته يحذّر من الابتعاد عن
الدنيا وقطع الصلة بها.
فما هي الدنيا؟ إنها الطبيعة, وهذا الجسد الذي نعيش به, وهذه الحياة التي نحياها,
وهذا المجتمع الذي ننتمي إليه, إنها سياستنا, واقتصادنا, وعلاقاتنا الاجتماعية,
وأولادنا, وثروتنا, ودارنا.
إنّ الانغماس في هذه الدنيا والتعلّق بها يعدّ صفة مذمومة في هذا الخطاب الفردي.
فلا ينبغي الانسياق وراءها. وهذا التجرّد وعدم الانقطاع إلى الدنيا يسمّى زُهداً,
ومع ذلك فلا ينبغي تجاهل متاعها وحظّنا منها. فليس من الجائز أن ندير ظهرنا لمتاع
الدنيا وزينتها ونِعَمها الإلهية.
(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ
لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ)3.
أي أنه لا يجوز الإعراض عن الدنيا. وهذه من بديهيات الدين ومعارفه الواضحة التي لا
تحتاج إلى تفسير.
إنّ هذه هي النظرة الفردية, وفي هذه النظرة يبيح الإسلام للإنسان الفرد الاستفادة
من ملذّات الحياة الدنيا ومباهجها, ولكنه يذّكره في الوقت ذاته بلذّة أسمى وأرفع
وهي لذّة الأنس بالله وذكر الله عز وجل.
إنّ للإنسان هنا أن يختار سبيله بصفته عاقلاً ومختاراً, وأن يواصل سيره على هذا
الصراط. إنّ المخاطب في هذه النظرة هو الإنسان الفرد, والهدف من هذه الحركة وهذا
الكدح هو استقامة الإنسان على الطريق, فإذا ما التزم بهذه القاعدة واتّبع هذا النهج
فسيغدو مستقيماً وصادقاً. وهذه هي النظرة الأولى.
وأما الثانية: وهي النظرة العامة أو
الجماعية, فإنها تقدّم نفس ذلك الإنسان المخاطب بالخطاب الفردي على أنه خليفة الله
في الأرض, وتُلقي على كاهله مسؤولية أخرى وهي إعمار الدنيا وإدارتها.
إنّ عليه أن يعمّر هذه الدنيا, (وَاسْتَعْمَرَكُمْ
فِيهَا)4. فما معنى إعمار الدنيا؟ إنه الكشف عن النعم التي
لا تحصى, والهِبات التي لا تعدّ, تلك التي منحها الله لهذه الطبيعة واستخدامها من
أجل رفاهية البشرية وتقدّمها.
لقد أودع الله تعالى هذه الأرض وما حولها إمكانيات هائلة, وعلى الإنسان اكتشافها
واستخراجها.
إنّ الإنسان قديماً لم يكن يعرف النار مع أنها كانت موجودة, ولم يكن يعرف الكهرباء
مع أنها كانت كامنة في الطبيعة, ولم يكن يعرف الجاذبية ولا الطاقة البخارية مع
وجودها في الطبيعة. واليوم مازالت هناك طاقات وقوى لا تعدّ ولا تحصى كامنة في هذه
الطبيعة وعلى الإنسان العمل على اكتشافها. إنّ هذه هي مسؤولية الإنسان بصفته خليفة,
وهي من لوازم الخلافة الإنسانية.
ونفس هذا الموضوع ينطبق على الإنسان ذاته, أي أنّ على الإنسان في هذه النظرة
الثانية أن يكتشف ذاته وقواه الكامنة وذلك من قبيل المنطق والحكمة الإنسانية, وكذلك
المعرفة الإنسانية, وتلك الطاقات المدهشة التي أودعها الله في النفس الإنسانية,
والتي تجعل الإنسان كائناً قوياً ومقتدراً.
وهذه هي النظرة العامة. فمن المخاطَب في هذه النظرة؟ إنهم جميع أفراد الجنس البشري.
فهناك مطالبة بإقرار العدالة والعلاقات الصحيحة. ممّن؟ من جميع الأفراد.
إنّ جميع أفراد النوع البشري معنيوّن بهذا الخطاب, أي أنّ عليهم واجباً ومسؤولية.
ومن مسؤولية البشرية جمعاء إقامة حكومة الحق, وتوثيق العلاقات الإنسانية, وإعمار
الدنيا, وبناء عالم حُرّ. وطبقاً لهذه النظرة فإن الإنسان هو الآخذ بزمام الأمور في
هذا العالم, فهو مسؤول عن ذاته وتربية نفسه وسمّوها وتزكيتها وتطهيرها, كما أنه في
الوقت ذاته مسؤول عن إعمار الدنيا وبنائها. فهذه هي نظرة الإسلام للإنسان.
إنّ الإنسانَوِيّة الغربية تتخذ لها هي الأخرى من الإنسان محوراً. فالإنسانَويّة ـ
وهي محور فلسفات القرن التاسع عشر وما بعده وما قبله ـ تجعل من الإنسان محوراً لها.
فما هو ذلك الإنسان؟ إنّ الانسان في منطق الغرب والإنسانوية الغربية يختلف تماماً
عن الإنسان في منطق الإسلام.
فالإنسان من منظار الإسلام هو كائن ذو بُعدين: بعد طبيعي, وبُعد إلهي, ولكنه كائن
مادي محض من منظار الغرب, لا يعرف سوى البحث عن اللذّة والمتعة والاغتراف من ملذّات
الحياة الدنيا. فالنفع المادي للإنسان هو محور التقدم والتنمية في الغرب, وأما في
الإسلام فإن الثروة والسلطة والعلم لا تعدوا أن تكون وسيلة لسمو الإنسان وتكامله,
وهي بنفسها غاية في التصور الغربي.
إنهم يقمعون الشعوب ويسخّرونها ويسفكون دماء الملايين من البشر في حروب طاحنة,
وغايتهم من كل ذلك هو فرض نفوذ بلد ما أو بسط سلطة قوة ما وتحقيق الثراء والغنى, أو
أن تتمكن الشركات الكبرى من تسويق ما تنتجه من أسلحة, فلا غضاضة عندهم في ذلك. وهذا
هو البون الشاسع بين منطقين مختلفين.
المثل والقيم المعنوية هي قاعدة مشروعنا الحضاري
وعلى هذا, فإن ما نحتاج إليه هو أن نقيم مشروعنا الحضاري والتطوري على
أساس النظرة الإسلامية للإنسان. وفي مثل هذا المشروع لا معنى أبداً لأن تكون
الفحشاء والغرق في مستنقع الفساد من لوازم التقدّم, بل يجب أن تكون المُثُل
والقِيَم المعنوية هي القاعدة الأساس لهذا التقدم.
إنّ ثمّة بوناً واسعاً بين تقدمّهم المادي وبين التقدم الذي يجعل من الإنسان محوراً
له, ذلك الإنسان المتمتع بالأصالة المعنوية العميقة, والذي يتخذ من العلم والدنيا
والثراء والكدّ المعيشي وسيلة للسمو الروحي والسير إلى الله تعالى.
والآن أوجز الحديث لأن صوت الأذان يقرع الأسماع.
إنني أريد القول: إنّ على مجمعنا الأكاديمي, وهو مجمع النخبة والصفوة من الحوزويين
والجامعيين, أن يضعوا في أولوياتهم أن يكون المشروع العام لتقدّم بلادنا قائماً على
أساس المبادئ الإسلامية, وألا ينبهروا بالنموذج الغربي, فليس هو النموذج الذي يخلص
البلاد أو الذي يساعد على تقدّمنا.
إنّ على الذين يعملون في مراكز التخطيط أو المراكز العلمية ومراكز الأبحاث
والمعنيين بقضايا بلادنا الاقتصادية والسياسية والدولية والمصيرية ألا يحاولوا
تطبيق النظم الاقتصادية الغربية, أو نماذج البنك الدولي, أو صندوق النقد الدولي على
أنظمتنا الاقتصادية, كلا, فإن تلك النظريات ليست مُجدية بالنسبة لنا.
إنّ من الممكن الاستفادة من علومهم فلسنا بالمتعصّبين. وإنّ بوسعنا الاستفادة من
التقدم العلمي والتجارب العلمية حيثما كانت. وباستطاعتنا الاستفادة من الأمور
النافعة, ولكن التخطيط ينبغي أن يكون وفقاً لثقافتنا واحتياجاتنا.
لقد أصبح استقلال شعبنا أسوة تتردد على لسان القاصي والداني في كل مكان من العالم,
وعلينا أن نبرز هذا الاستقلال في كل جوانب حياتنا. إنّ معنى الاستقلال هو عدم
الانفعال إزاء حركة المتسلّطين في هذا العالم, بل يمكننا الاستفادة بكل ما يتناسب
مع مصالحنا وأهدافنا وطموحاتنا دون التأثّر بالضغوط الدعائية والسياسية التي
يمارسها الأعداء.