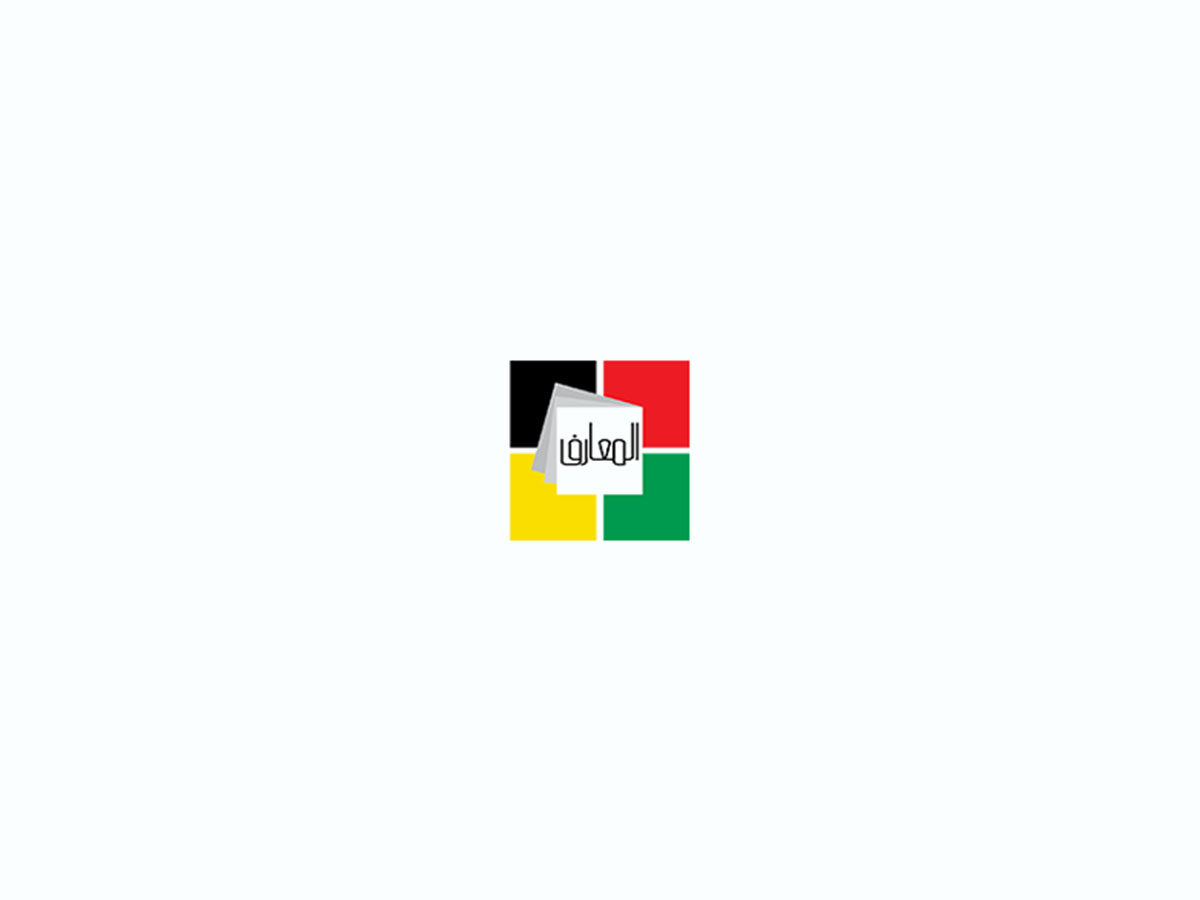الغنى في ظل اتّباع القرآن
في الخطبة المذكورة يصف علي عليه السلام القرآن على أنّه معلّم فيقول: "وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لا يَغُشُّ، وَالْهَادِي الَّذِي لا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لا يَكْذِبُ،
عدد الزوار: 655
في الخطبة المذكورة يصف علي عليه السلام القرآن على أنّه معلّم فيقول:
"وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لا يَغُشُّ،
وَالْهَادِي الَّذِي لا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لا يَكْذِبُ، وَمَا
جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلاّ قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ،
زِيَادَةٍ فِي هُدىً أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمىً". إلى أن يقول عليه السلام:
"وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، وَلا
لأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنىً، فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ،
وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لأْوَائِكُمْ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ
الدَّاءِ، وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلالُ".
بوجود القرآن وحاكميته على المجتمع لا تبقى لأحد حاجة دون أن تتحقق، لأنّ القرآن
الكريم أسمى رسالة إلهية لحياة الموحّدين، وأنّ الله تبارك وتعالى قد ضمن لأتباع
هذا الكتاب السماوي العزة والفلاح في الدنيا والآخرة، بناءً على هذا إذا ما طبّق
مجتمعنا الإسلامي أحكام القرآن وتعاليمه الزاخرة بالحياة، وآمن بصدق وعوده جاعلاً
منه أسوة في العمل، فإنّ القرآن يُلبّي كافة مقتضيات المجتمع الفردية والاجتماعية
والمادية والمعنوية، ويجعل المجتمع الإسلامي في غنىً عن كل شيء وكل أحد.
وفي المقابل يتحدث عليه السلام عن خطر الابتعاد عن القرآن، رافضاً فكرة إمكانية
علاج المشكلات وتلبية الحاجات الفردية والاجتماعية للمجتمع بدون القرآن الثقل
الأكبر، فيقول: "وَلا لأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنىً". فلن يُغنى أحد
بدون القرآن، ولن يستغني المجتمع عن القرآن أبداً، أي لو وُظّفت جميع العلوم
والتجارب البشرية، وحُشّدت كافة الأفكار والنظريات، لإقامة مجتمع يقوم على أساس
القسط والعدل والقيم الأخلاقية والإنسانية، فإنّها لن تُجدي نفعاً بدون القرآن،
وذلك لتعذر استغناء أحد بمعزل عن القرآن، وعلى هذا الأساس يقول عليه السلام:
"فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لأْوَائِكُمْ﴾.
فاطلبوا من القرآن زوال أدوائكم ومشكلاتكم، وابحثوا في القرآن عن الحيلة في الشدائد
والصعاب.
وبعد تذكّره عليه السلام بأعظم الأمراض الفردية والاجتماعية أي الكفر والضلال
والنفاق، يقول إنّ سبيل علاج هذه الأمراض والمشكلات يكمن في القرآن، وعليكم الرجوع
إلى القرآن الكريم لعلاج أمراضكم ومشكلاتكم.
بناءً على هذا يجب أخذ الأصول العامة والخطوط الأساسية من القرآن وتلمّس طريق علاج
المشكلات باتّباع تلك الأصول العامة، والاستفادة من التجارب والتدبر والعلم، فإذا
ما نهضنا ساعين لعلاج المشكلات معزّزين بهذه الرؤية، فمن المؤكد أنّنا سنتغلب على
جميع المشكلات وفي كافة الميادين، لأنّ هذا وعد الهي حيث يقول جلّ وعلا:
﴿وَمَن
يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً﴾1
فمَن يلتزم بتقوى الله ولا يتمرد على أحكامه، فإنّه تعالى يهيئ له سبيلاً للخلاص
والخروج من المشكلات.
القرآن دواء لأعظم
الأدواء
ربّما لا ينسجم الكلام الآنف الذكر مع أذواق المغرورين، والذين لا نصيب لهم من تقوى
الله ومن علوم القرآن وأهل البيت عليهم السلام، والذين يتصورون أنفسهم بأنّهم يقفون
عرضياً مع الله سبحانه وتعالى، لِما يعرفونه من مصطلحات في العلوم البشرية، بيد أنّ
كل إنسان عاقل يقرّ بأنّ كل ما اكتشفه الإنسان نتيجةً لتطوره العلمي المذهل، إنّما
هو بمثابة قطرة من بحر في مقابل مجهولاته، وأنّ كافة مزاعم المدارس الأخلاقية غير
الإلهية في تقديم نموذج للمدينة الإنسانية الفاضلة، لا تعدل صفراً في مقابل العلم
الإلهي، الذي لا ينفد وعلوم أهل البيت عليهم السلام النابعة من الإلهام الإلهي.
على آية حال إنّ علياً يرى أنّ أعظم مرض في المجتمع البشري هو الكفر والنفاق
والضلال، فهذه الأمراض النفسية هي التي تصيب المجتمع بصنوف المشكلات والمصائب،
ولابد من البحث على علاجها في القرآن:
"فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ
وَالْغَيُّ وَالضَّلالُ"، فأعظم الداء عبارة عن الكفر والنفاق والغي والضلال،
وعلاجه عبارة من الإيمان بالقرآن واتّباعه.
وينبغي الانتباه إلى أنّه ليس معنى هذا القول: "اطلبوا دواء أدوائكم من القرآن،
لأنّه دواء لجميع الأدواء والمشكلات"، إنّ القرآن شأنه كوصفة الطبيب الذي يقوم
بتشخيص أمراضكم البدنية، ويكتب لكلّ منها دواء للشفاء منها، ولا أن يتم تعلّم
معادلات علاج الأمور من القرآن في مجال المشاكل الاقتصادية والعسكرية، أو في الحقول
الصناعية والتقنية، كلا فلا يُفسّر كلامه عليه السلام بهذا المعنى مَن يتمتع
بأدنى معرفة بالمعارف الدينية، لأنّ علاج الأمراض الجسمية وحل سائر المشكلات يحتاج
إلى أدواته وطرقه الطبيعية، والقرآن الكريم ـ كما قيل آنفاً ـ يبيّن الخطوط العامة
لعلاج هذه المشكلات، والناس مكلّفون بحل مشكلاتهم وعلاج أدوائهم من خلال الالتزام
بالخطوط العامة للقرآن، واستثمار العقل والقابليات التي وهبها الله إيّاهم،
والاستفادة من تجارب العلوم البشرية، وهنا نلفت اهتمام القرّاء الأعزّاء إلى أمرين
هما:
الأَوّل: بالرغم من أنّ للأسباب والعلل الطبيعية والمادية معلولاتها
ومسبباتها، ولكن من الضروري الانتباه إلى هذه القضية وهي أنّ الله تبارك وتعالى
علّة العلل لجميع الظواهر، فهو الذي خلق نظام الكون على أساس العلاقة بين العلّة
والمعلول، وهو الذي يمدّ الأسباب والعلل بالسببية والعليّة، وهذه إرادته التكوينية
التي لولاها لا استقلال لأي فاعل في تأثيره بفعله، بناءً على هذا لابد أن نتوجه
بالأصالة إلى الله سبحانه وتعالى، ونتطلع بأعين الأمل نحوه لعلاج كافة الأدواء
وإزالة الابتلاءات والمشكلات، ورغم لجوئنا إلى الأسباب والعلل الطبيعية لحل
المشكلات والبرء من الأمراض، لكنّه وبمقتضى التوحيد الأفعالي يتعيّن أن نعتبر
ونتوقع الشفاء وحل المشكلات منه تعالى بالأصل.
الأمر الثاني: هو ينبغي عدم اعتبار طريق الوصول إلى حل المشكلات، وعلاج الأمراض
محصوراً بالأسباب العادية والطبيعية، أي ليس الأمر إذا ما انعدمت الأسباب والعلل
العادية والطبيعية، أو انعدمت فاعليتها لحل المشكلات، تنتفي إمكانية إزالة المشكلة
أو الشفاء والبرء من الأمراض، أو تحقق كل رغبة مشروعة وحقّة للإنسان، فالله سبحانه
وتعالى بخلقه لنظام العلة والمعلول لم يجعل نفسه عاجزاً عن خلق أية ظاهرة بطريق غير
طبيعي، بل إنّ سُنّة الله قضت بأن تُنجز الأمور عبر مجراها الطبيعي، بيد أنّ إنجاز
الأمور لا يقتصر على المجرى الطبيعي، وإنّما يقوم الله سبحان وفي ظل ظروف خاصة
بإيجاد أمور خارج سياقها الطبيعي، ويمكن القول إنّ هذه سُنّة إلهية أيضاً، فمن
الممكن أن يحصل الشفاء والبرء من المرض عن الطريق الطبيعي ومعاينة الطبيب، ومن
الممكن أن يحصل في ظل ظروف خاصة عبر العلل غير المادية، من قبيل دعاء الأئمة
المعصومين، أو دعاء غيرهم من أولياء الله، مثلما يمكن أن ينتصر جنود جبهة التوحيد
بفعل الإمداد الغيبي والأسباب غير الطبيعية، في حين أنّهم بحكم المنهزمين أمام
العدو من حيث المصاديق المادية والشروط الطبيعية، وهذا أمر يُعد من الأسباب والعلل
الإلهية أيضاً.
لقد ورد في القرآن الكريم أمثلة من الحوادث التي وقعت خارج إطار الأسباب العادية
والطبيعية، فمثلاً لو قدّر لهطول الأمطار أن يجري عبر علله وأسبابه الطبيعية، فلابد
من أن تتبخر مياه البحار والمحيطات نتيجةً لأشعة الشمس والحرارة، ثمّ يتحول إلى
غيوم، ونتيجةً للاختلاف في درجة الحرارة بين البحر واليابسة تهب الرياح، وبهبوبها
تسير الغيوم من على البحار نحو بقاع الأرض، كي تُنزل قطع الماء الموجودة في الغيوم
وفي ظل ظروف معيّنة، على شكل قطرات مطر، أو حبيبات من الثلج أو البرد على الأرض،
فتوقّع هطول الأمطار بغير أسبابه وعلله الطبيعية يعتبر توقّعاً عبثاً وغير معقول من
وجهة النظر المادية، لكنّ نوحاً عليه السلام ودون أن يضع في الحسبان الأسباب
الطبيعية لنزول المطر، قال لقومه استغفروا ربّكم وتوبوا إليه، كي تُنزل السماء
عليكم مطرها:
﴿وَيَا
قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السّماءَ عَلَيْكُم
مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوّةً إِلَى قُوّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلّوْا مُجْرِمِينَ﴾2
أيّها القوم استغفروا ربّكم وتوبوا إليه وعودوا إلى الله، ليُنزل مطراً
غزيراً من السماء، وبنزول الرحمة الإلهية وهطول المطر تزدادون قوةً واقتداراً، ثمّ
يقول:
﴿وَلاَ
تَتَوَلّوْا مُجْرِمِينَ﴾،
أي إيّاكم أن تعرضوا عن الله دون توجه واستغفار إليه وانتم مجرمون مذنبون، ولا
تحرموا أنفسكم من الرحمة الإلهية.
بالرغم من أنّ جميع الأسباب الطبيعية لنزول المطر وكل نظام العلة والمعلول الحاكم
على الطبيعة، بيد القدرة الإلهية وتعمل بإرادته جلّ وعلا , لكن الله سبحانه وتعالى
ودون أن يضعها في نظر الاعتبار، يقول استغفروا لذنوبكم وعودوا إلى الله، إذ ذاك
نوعز للسماء أن تُنزل مطرها عليكم.
ربّ قائل يقول ليس مراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر دون تحقق الأسباب
الطبيعية، بل المراد هو أنّنا نُنزل المطر عليكم عبر توفير الأسباب الطبيعية، والرد
هو أنّ هذه الرؤية لا تنسجم مع الرؤية التوحيدية، لأنّه وكما تقدم القول ليس الأمر
أنّ الله قد اعجز نفسه عن خلق الظواهر دون أسبابها وعللها الطبيعية بخلقه لنظام
العلّة والمعلول، فهو تعالى يقول بصدد قدرته على خلق الأشياء:
﴿إِذَا
أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾
فإذا ما تعلقت إرادته جلّ وعلا بشيء فستتحقق إرادة الله ويتحقق ذلك الشيء.
* تجلّي القرآن في نهج البلاغة - آية الله محمّد تقي مصباح اليزدي
1-
الطلاق: 2 .
2- هود: 52 .